خالد البدور شاعر يقيم «في بلاد الرياح»
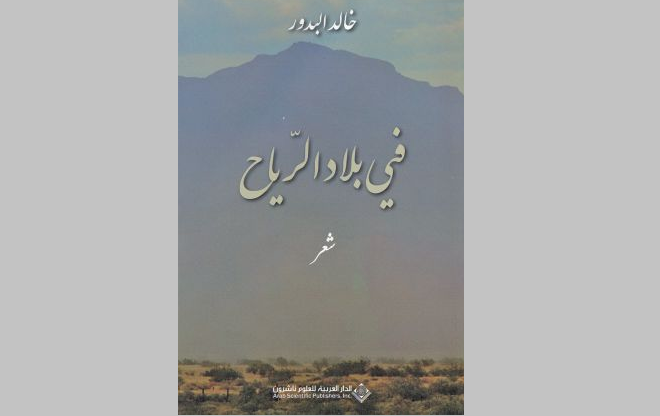
الجسرة الثقافية الالكترونية
عبده وازن
أول ديوان قرأته للشاعر الإماراتي خالد البدور كان «ليل» الذي فاز عام 1991 بجائزة يوسف الخال، وكانت تمنحها مجلة «الناقد» لصاحبها ورئيس تحريرها رياض نجيب الريس. ديوانه الأول ذاك حمل صوتاً شعرياً يصبو الى الاختلاف عن الأصوات الشعرية التي كانت سائدة و «مكرسة»، والى البحث عن قصيدة خفيضة النبرة، متحررة من عبء البلاغة العالية ومرتكزة الى الذاتي بصفته مرجعاً شعرياً مع انفتاحه على شؤون الحياة اليومية والأليفة. كان ديوانه آسراً ببساطته العميقة وحيويته ونضارته، وقد شقّ أمامه الطريق بجدارة الى المشهد الشعري التسعيني الذي بدأ آنذاك في التشكل في أكثر من عاصمة عربية. في ديوانه الجديد «في بلاد الرياح» (الدار العربية للعلوم-ناشرون 2016) لا يبدو البدور غريباً عن المناخ الذي انطلق منه وجسده في «ليل» وما تلاه من دواوين بعضها باللغة العامية، بل هو يمضي في تجربة التحرر من العوائق التي تواجه الكثير من الشعر الراهن على اختلاف انواعها: الافتعال، الأطناب، اللفظية، الركاكة، التجريب المجاني المجرد من روح الشعر… بل هو يمعن في كتابة قصيدة ذات بعد غنائي داخلي ونفَس رثائي، مستعيداً ماضيه الشخصي وماضي المكان او الذاكرة، وملامح طفولة عبرت ولم يبق منها سوى آثار في الروح.
وقد يخيل للقارئ أن «بلاد» الشاعر ليست بلاد الرياح فقط، وفق ما يشير عنوان الديوان، بل هي ايضاً بلاد النسائم والظلال والأطياف التي تهب من صميم المكان الذي هو الطبيعة الصحراوية الجامعة بين الرمل والبحر، بين الشمس والغيوم. وهذه الطبيعة تجسدت في قصائد البدور تجسداً وصفياً وذاتياً وروحياً. طبيعة ناطقة وصامتة في آن واحد، ترنو اليها العين مثلما يرنو اليها القلب والمخيلة. طبيعة تضيئها الشمس وتحتل سماءها الغيوم ويمنحها الماء، بحراً وجداول، طلاوة الجنة. لكنّ الشاعر لا يدع من مسافة بينه وبين عناصر الطبيعة هذه، فهو يؤنسنها مركزاً على نواة الحياة الكامنة فيها. وليس مفاجئاً ان يحتل المعجم الطبيعي حيزاً في شعر البدور مما يؤكد الحضور «الفردوسي» في اعماق هذا الشعر: حقل، شجر، شمس، جداول، نجوم، نهر، قمر، ياسمين، تلال، كثبان، قرنفل… واللافت ان الشاعر ينظر الى عناصر الطبيعة عبر عين هي أشبه بعين الكاميرا التي تلتقط المناظر التقاطاً مشهدياً وبصرياً. يشعر القارئ فعلاً بطغيان هذا الاحساس السينمائي المرهف الذي يسكن الكتابة والذي لا يكتفي بنقل الطبيعة نقلاً مباشراً بل يبحث في تلافيفها عن أسرارها الدفينة، مضفياً عليها هالة من التخييل البديع: «سحب كثيرة مرة فوق تلك الشجرة». هذه الصورة المشهدية قد تبدو عادية اذا ما اكتفى القارئ بمقاربتها حسياً او وصفياً، اما اذا تأملها فهو يدرك ما وراءها: حركة الزمن متمثلة بمرور السحب فوق شجرة تظل في مكانها. هذه لقطة سينمائية وشعرية في وقت واحد، تجسد العلاقة الأزلية بين الثابت والمتحرك. وقد يكون ممكناً ان تُقرأ هذه اللقطة على ضوء قصيدة الهايكو نظراً الى احتفالها بالطبيعة احتفالاً صوفياً وجمالياً. واصلاً لا يغيب اثر شعر الهايكو عن الديوان لكنه يحضر حضوراً خفياً وليس شكلياً. واصلاً تميل قصائد البدور بمعظمها الى الكثافة والاختصار ما خلا بضع قصائد إحداها قصيدة «صار لديك ما يكفي» الجميلة والمؤثرة التي يرثي فيها صديقه-وصديقنا- الشاعر الراحل احمد راشد ثاني. والكثافة لدى البدور دلالة على اكتفاء الشعر بجوهره حتى لتبدو بعض الأسطر الشعرية لمعات كأنها مقطوفة من أعماق الذاكرة والمخيلة: «حدق في الشجرة/ حينها سترى الريح»، او: «الصعود بصمت / كغيمة»، او: «كنا قد سرنا/ كما لو كنا نمشي فوق الهواء»… هذه الجمل الشعرية تحمل في داخلها علامات ورموزاً، تفصح عنها بمقدار ما تخفيها. وهنا سر الشعر الحقيقي.
لا يحضر الماضي في ديوان «في بلاد الرياح» حضوراً طيفياً او انطباعياً فحسب بل واقعياً ايضاً من خلال الأثر الذي يتركه في الذات التي لا يمكنها ان تكون بعيدة من هذا الأثر. ها هو الشاعر يستعيد ذكرى «جنيات الليل» اللواتي كن يأتين من الجبال، متسائلاً ببراءة عميقة: «هل سيهبطن / فوق صدر الصحراء قبل الفجر؟».
وفي قصيدة «سهو» يلمح «وجه طفل محمول / على كتف ابيه» ثم يعترف انه يعرفه جيداً، فهو وجه الطفل الذي كانه والذي لا يمكنه أن ينساه. ويستعيد كذلك في قصيدة أخرى ما كانت تقول له أمه ليلاً لتجبره على النوم: «نم الآن / قالت له امه/نم / لا ينهض سوى الجن في هذه الأنحاء». ولعل ما يحمل الشاعر على استعادة الطفولة والماضي البريء، بوصفهما ملاذاً يلجأ اليه الانسان ليحمي نفسه من غيلة الزمن العابر الى غير رجعة، هو الواقع او الحاضر الذي يمضي في القضاء على معالم الطفولة والماضي مخلياً اياها من جمالها الأول، الفطري والصافي. انها حداثة العصر تقضي على الذاكرة المزدوجة، ذاكرة الإنسان وذاكرة المكان. في قصيدة «ما قالته مريم» يبدو الشاعر كأنه يقف على أطلال بيت يوسف، الذي سمع الجرافات «تهاجم جدرانه ذات مساء»، ويوسف كما يقول الشاعر، رجل فقير كان يسكن مع امرأته مريم بجوار منزله القديم عندما كان طفلاً. وفي قصيدة «ارض اخرى» يكتشف الشاعر، عندما يرى الغبار من نافذة السيارة، ان الارض، ارض ماضيه، صارت ارضاً أخرى. انه الحنين الى الماضي الذي زال او الذي هو على قيد الزوال، الماضي ليس في مفهومه الزمني فقط بل الوجودي والكينوني. وهذا الحنين الداخلي المكتوم هو ما يدفع الشاعر الى القول: «ستهطل الذكريات بشدة»، الذكريات التي تتراكم كلما مر الزمن. وهذا الحنين كان اختبره بودلير حين قال: «لديّ الكثير من الذكريات وكأن عمري الف عام».
ولكن حيال الذكريات والزمن المنقضي تحــضر في الديوان موضوعة «السفر». السفر بوصفه انتقالاً في المكان والزمان وتوغلاً في ذات المسافر والمشاعر التي تكتنفه. لا يسافر الشاعر وحده دوماً بل ترافقه امراة او طيف امراة في احيان. السفر في «القطار الطويل» الذي يمر ببطء، كما يقول الشاعر، «بين جبال، غابات، محطات وبحيرات». او السفر في الطائرة بنافذتها المستديرة وغرقها «في ظلام المحيط». او السفر في الســفينة وعلى ظهرها يســـأل الشاعر نفسه: «متى سأعود؟». غير ان السفر لا بد ان ينتهي «في بلاد الرياح»، تلك البلاد التي لا بد من العودة اليها، وهناك يبتـــني الشاعر كما يقول، «منزلاً من الكلمات». انها البلاد التي يجلس فيها تحت شجرة «لها اغصان/ وليس لي بقربها ذكريات». وهنا تتماهى فكرة السفر في فكرة الاقامة، لكنها الاقامة الشعرية بامتياز، الاقامة في بلاد الرياح.
المصدر: الحياة




