الروائي التركي تانبينار: مدن وشظايا عشوائية من الخبرة
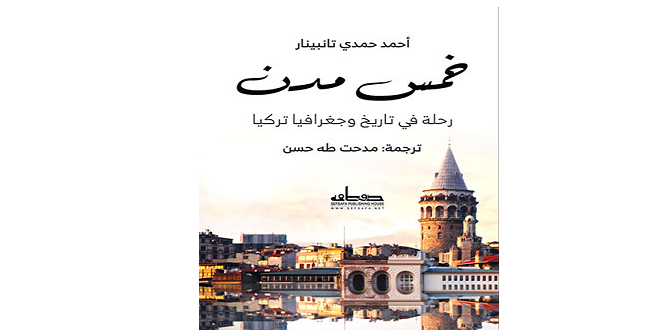
محمد الحمامصي
يعد أحمد حمدي تانبينار (1901-1960) أحد أهم الروائيين في تاريخ الأدب التركي المعاصر، كانت روايته التي ترجمت إلي العربية باسم “طمأنينة” واحدة من علامات التحديث في أدب بلاده، وقد كتب كذلك القصة والشعر والمقال، وهو يقيم حالياً في إسطنبول مهرجانا أدبيا سنويا يحمل اسمه.
وهذا الكتاب “خمس مدن.. رحلة في تاريخ وجغرافيا تركيا” الصادر هذا الأسبوع عن دار صفصافة ترجمة مدحت طه، يعد عملا أدبيا توثيقيا، سعي فيه تانبينار إلي نقل صورة عن أهم مدن بلاده، واقعها وتاريخها، تضاريسها وصورتها المعمارية، وحاول قبل كل ذلك الإمساك بروح تلك المدن الخمس: “إسطنبول”، “أنقرة”، “بورصة”، “إيرزوروم”، و”قونيا”، ونقلها بأسلوب سلس يضع الكتاب في مرتبة مميزة بين أعماله.
ورغم أن الكاتب يبدأ رحلته في هذا العمل من “أنقرة” التي عاش بها إلا أن “إسطنبول” تحتل نحو نصف صفحات الكتاب، يقول تانبينار “موضوع الكتاب يعد نوعًا من الصراع بين الشغف الذي ننميه تجاه الحداثة، والندم الذي نشعر به تجاه ما فقدناه في حياتنا. من النظرة الأولى تبدو هذه المشاعر متناقضة، لكن يمكن جمعهما في كلمة “حب”. كل المدن التي اختيرت بالحب ظهرت في حياتي بالصدفة. بناء عليه، بالنظر إلى تاريخها يمكننا أن نصل إلى فهم أفضل لشعبنا، حيواتنا، والهوية الروحية للبلاد التي تنتمي إليها ثقافتنا.
مثل الأجيال التي سبقتنا، اختبر جيلنا تلك القيم من نقاط التحول الحرجة على طريق الرحلة الشاقة الذي جلبنا لهذا المدى المعروف لنا الآن بـ “الميل الحضاري”، والذي رسخ كل آمالنا. اقتربنا على مدى مائة وخمسين عامًا من شفا هاوية، ناظرين للخلف على الطريق الذي خلَّفناه وراءنا، وللأمام للرؤية المستقبلية البعيدة بوعود لإضاءة الطريق لحل مشكلاتنا.
ويرى أن الدراما الأساسية للمجتمع التركي ستستمر لزمن طويل، وهي مغامرة العيش وسط مناخ من النقد، وكتلة من الاتفاقات والخلافات، ومن الآمال والأحلام، مع فترات استثنائية من التقييم الواقعي، حتى نعيد إحياء حيواتنا، بالعمل الذي سيكون مبدعًا بحق، بكل المعاني.
كلنا نعلم الطريق الذي يجب علينا اتباعه. لكن كلما كان الطريق أطول، كانت هذه الدنيا التي نغادرها تبقينا مشغولين أكثر قليلًا، يومًا بعد يوم. الآن نحن نشعر بهذا بفعل الفجوة المتزايدة تدريجيًّا في هويتنا. فيما بعد بقليل أصبحت عبئًا ثقيلًا نحن أكثر من متأهبين للتخلص منه في الركن التالي. حتى عندما تكون قوة إرادتنا في أقوى حالاتها، لدينا وجع داخلي يشير إلينا أحيانًا مثل وخز الضمير. مثل هذا الغليان الداخلي ليس مفاجئًا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الظرف الذي نعرفه بأنه “تشبع بالتاريخ” يبذر البذرة، ويخلق المعنى الحقيقي والهوية، ليس فقط للدول والمجتمعات، لكن للشخصيات كذلك. هناك الماضي دائمًا متجسدًا. فلكي نعيش حيوات أصيلة، علينا أن نعتبر بالماضي ونتوافق مع شروطه.
ويشير تانبينار إلى أن كتاب “خمس مدن” هو مناقشة وُلدت من الحاجة إلى مثل هذا الاعتبار. كان يمكن أن تكون أوضح، وحتى أكثر فائدة، لجلب هذه المناقشة المعقدة والتي يصعب معالجتها إلى مواد أكثر دنيوية. باختصار، لكي نطرح أسئلة ونجيب عليها مثل: ماذا كنا؟ ماذا نحن عليه الآن؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ وقد واجهتني هذه الأسئلة خلال حياتي بالصدفة فقط. فقد ظهرت بينما كنت أتجول عبر بقايا السلاجقة التي تسمى أناضوليا، أو عندما كنت أشعر بالتواضع أسفل قبة السليمانية، أو أواسي وحدتي من خلال المنظر الطبيعي في البورصة، أو أستمع لموسيقى “لتري” أو “ديدي أفندي”، تلك الموسيقى الممتزجة بالماء مع الأصوات البدوية التي تملأ مقتنياتنا الشعرية.
ويقول “لن أنسى أبدًا أنه ذات صباح على (الأولوداج)، زالت عن عيني غشاوة، في نفس اللحظة التي كنت أستمع فيها لناي راعي غنم وأشاهد قطيع أغنامه وخلافه يحيط بموسيقاه عندما تجمعوا واحدًا تلو الآخر عند ندائه. أعرف أن الشعر التركي والموسيقى التركية هي حكاية المنفى، لكنني لم أدرك إلى أي مدى هما مرتبطان بهذا الجانب من حيواتنا. كان إحساسًا مؤثرًا وجميلًا بحق تملَّكني لعدة دقائق تفهمتها كعمل فني. إذا ما كُتب التاريخ الشعوري للأناضول يومًا وكانت حيواتنا في موضع الاختبار من تلك الزاوية، سنرى إلى أي مدى أنَّ ما نفكر فيه الآن باعتباره حداثيًّا نبع من النسيج الأصلي لحياتنا ذاتها. في كلمة واحدة، الطريقة التي وصلتُ بها إلى هذه التفسيرات للأحداث وتباطأت لتعكس حالتي الروحية، كانت بنفس الأهمية بالنسبة لي مثل الأحداث ذاتها. لقد نشأ هذا الكتاب أساسًا من شظايا عشوائية من الخبرة”.
• مقتطفات من خمس مدن
“أنقرة”
لطالما تخيلت أنقرة كمحارب أسطوري، ربما كنتيجة لذكريات الصراع الوطني من أجل الاستقلال، وربما من الانطباع القوي الذي تتركه القلعة مرتفعة ومنتصبة مثل فارس من الأزمنة القديمة مكتسيًا بدرع من الحديد. ربما كان موقعها لديه شيء من طبيعتها. ما يصدمنا فعليًّا هو الحصن الطبيعي الذي يطل على طريق بين تلين مسطحين. وتتغير الملاحظة بالكاد إذا ما نظرت من المرتفعات المحيطة التي تسود المدينة.
“إيفيليا سيليبي”
من المستحيل التحدث عن مدينة تركية دون ذكر “إيفيليا سيليبي”. فهناك اثنان من أسلافنا يتسيدون خريطة بلادنا. أحدهم هو “سينان” المعماري. فتركيا القرن السادس يمكن دائمًا أن تجدها في أعماله، وهناك القليل جدًّا من المدن الكبرى التي لا تملك نصيبًا من آثار هذا العبقري في الإمبراطورية العثمانية. عندما أسمع اسمه أرى على الفور، مثل حبل من أحجار ثمينة قطعت بجمال لا نهائي من المباني الكبيرة والصغيرة، التي تمتد من المجر إلى البحر المتوسط وخليج البصرة. السلف الثاني هو إيفيليا سيليبي، المرآة الأهم والأسمى لبلاده، أحيانًا بإضافة بعض التفاصيل الثانوية، لكنه يبقى دائمًا حقيقيًّا بالنسبة للأطر الرئيسية عاكسًا تركيا بأكملها في القرن السابع عشر.
“قونيا”
تمتلك قونيا كذلك ثروة أخرى، ربما لن تصل إلى ذُرا موسيقى ميفلانا، لكنها لديها تأثير عميق مساوٍ علينا، فولكلورها الذي يمكننا اعتباره ملحمة سلوقية. في تلك المدينة تعلمت أن أتعرف على الأغاني الفولكلورية للأناضول المركزية، التي وضعت مع عبء المنفى والمصير، غرابة اللحم والألم والمرارة.
***
اعتدت أن أنام في حجرة صغيرة في أعلى طابق بمدرسة الليسيه في قونيا القديمة. وفي أي ساعة من النهار كانت الأغاني السوداوية للسجناء من السجن القريب تمتزج مع أصوات الأطفال وهم يلعبون في الحديقة أو مع أصوات عملي، أحيانًا تأتي من المنازل البائسة المجهولة على الجانب الآخر.
أحببت بشكل خاص أن أسمعهم في الساعات الني تتورد فيها جبال تاكيي في ضوء المساء. وأيضًا مع اقتراب الصباح عندما يوقظني ضجيج العربات التي تحمل الفواكه والخضروات إلى المدينة. في صباحات برد الخريف الثقيل كانت الأغاني تدخل الأحلام التي تركتها بالكاد خلفي، وتجرُّني بعذاباتها ومعاناتها مثل وجوه وأجساد النساء العزيزات المحبوبات اللائي عرفن القسوة والقهر.
***
هناك العديد من الأمم الأخرى التي تفسر الموت بطريقة أبعد كثيرًا من فكرة الجبر، خالقين الضريح كعرض بسيط من بركات الهلاك الدنيوي، مقلدين حياة تنتمي الآن للعالم الآخر، تصبح بمثابة متحف لمستقبل مروع. استنفدوا كل فنونهم واختراعاتهم في محاولة للتغلب على مخاوفهم العميقة من الموت؛ لا أحد استطاع أن يروّض الموت أو يخفف من واقعيته الرهيبة كما فعلنا نحن، وحدنا.
” اسطنبول”
اسطنبول الحقيقية ليست فقط مدينة المساجد والمآذن حبيسة الجدران، لكنها تتكون أيضًا من مثل هذه المواقع الجغرافية المتنوعة بمظاهر جمالها الخاصة المميزة مثل بيوجلو، وبوجازيسي، وأوسكودار، وشواطئ إيرنكوي، وبحيرات كيميكس، والينابيع والجزر، كلها داخل مدينة واحدة. لذلك فإن ساكن اسطنبول يتشوق إلى مكان غير ذلك الذي يعيش فيه حياته اليومية.
***
كل ساكن في اسطنبول يعرف أن صباحًا على البوسفور هو سعادة مختلفة تمامًا عن أي صباح آخر في الجوار، وقلب أي واحد منا يرى أضواء اسطنبول من مرتفعات كاميلكا في الغسق يكون ممتلئًا بحزن فريد. في الليالي المقمرة، الفرق بين ساريير، فقط مائة مقياس لمياه النهر، تتزايد من خليج بويوكدير هو اختلاف بنفس قدر الاختلاف بين البوسفور والبحر المفتوح لمرمرة. بضربات قليلة للمجداف يترك المرء عالم الحلم المألوف، خبزه اليومي من الشعر، ويدخل ليلة خشنة أسطورية لمغامر مستكشف. في كل ساعة من النهار يكون لدى البحيرات في كيمكيس جمال مختلف تمامًا عن شواطئ البحر المجاورة.
***
بينما نتأمل كل هذه التغيرات في خيالنا، هناك اسطنبول وُلدت وتتفتح مثل زهرة، بتلة تلو بتلة. بالطبع كل مدينة كبرى، هي بدرجة أو بأخرى كذلك. لكن مناخ اسطنبول المميز، والصراع بين رياح الشمال والجنوب، والأحوال المتعددة للتربة، تؤكد على الاختلافات بين الجيران التي نادرًا ما تكون معروفة في أي مكان آخر.
(ميدل ايست اونلاين)




