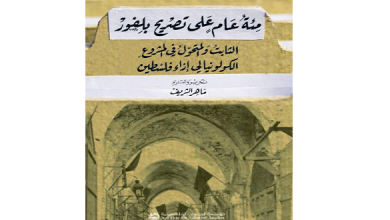طوغان.. قصة فنان صنعته الآلام!

مصطفى عبد الله
تبقى السيرة صنفًا أدبيًّا مميزًا، لا يعتمد الخيال في كتابته، وإنما الواقع في أصدق تجلياته، كاشفًا عن مساحات إنسانية مترامية الاتساع في نفس صاحب السيرة، وكلما كان بوح سارد السيرة صادقًا، لا يتزين لإضفاء الجلال على شخصه، وإنما يكتب وكأنه يعترف لملاك الموت قبل الرحيل.
والكتاب الذي بين أيدينا هو واحد من كتب السيرة الجيدة التي لا يقدم فيها صاحبها، وهو فنان الكاريكاتير الراحل الكبير أحمد طوغان، نفسه ملاكًا لا يأتيه الباطل من أمام ولا من خلف، ولا السوبرمان الذي لا تهزه الملمات، وإنما يشير بأدبٍ جمٍّ إلى هنَّاته الإنسانية، معترفًا بما قدَّمت يداه من نقصٍ بشري، باكيًا مشاعرَ ودٍّ لو فهمها في وقتها، نائحًا فقد فلذة كبده، راجيًا آخرين لو يحسنوا المشاعر، فإن الأمر أتفه من كل هذه المؤامرات، والحياة قصيرة تنتهي خطفًا!
في مقدمة هذا الكتاب المعنون بـ «سيرة فنان صنعته الآلام»، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، والذي حرَّره الكاتب أحمد كمال زكي؛ كتب الأديب الراحل خيري شلبي معبرًا عما يميز هذه السيرة، قائلًا: «إنها ليست مجرد مذكرات صحفي رسام حقق شهرة مدوية، إنما هي فصول من تاريخنا المعاصر، غير أنه التاريخ الحي، التاريخ غير المرئي، التاريخ المخبوء في كواليس استدرجنا إليها ليرينا ما لم نكن نعرفه عن شخصيات عايشناها وتتلمذنا على أيديها وتأثرنا بها من طراز: كامل زهيري، ومحمود السعدني، وإحسان عبدالقدوس، ومحمد عبدالمنعم رخا، وزكريا الحجاوي، وصاروخان، وعباس الأسواني، وفتحي الرملي، وعلي جمال الدين طاهر، ومدحت عاصم، وسعد زغلول فؤاد، ومصطفى القشاشي، وعلي ومصطفى أمين، وأنور السادات، وحسني مبارك، وعديد من الشخصيات التي أثرت في حياتنا ولعبت أدوارًا فيها».
لكن كلمة الناشر على الغلاف الخلفي للكتاب تمنحنا معلومة إضافية، تكشف عن بعض سر متعة هذه السيرة عندما يكتب: «في رحلته الثرية يأخذنا طوغان إلى أماكن يسكنها البحر، وتطوف بأرجائها الأسطورة، لنُحلِّق معه في أجواء ممتعة، قبل أن يعيدنا إلى صلادة الواقع مرة أخرى، ورغم أنه يضرب بفرشاته الهموم ليُخرج منها بهجة كامنة، إلا أنه لا يخفي آلامه، تلك التي صنعت منه فنانًا ذا مذاق خاص».
لكننا سكتشف أن ما قدمه الناشر في كلمته الموجزة من أسباب الإمتاع ينقصها سبب آخر بالغ الأهمية، اكتشفه خيري شلبي بحسِّه الأدبي الفاخر، فكتب في طرف من مقدمته: «في كتابة طوغان ثقافة البلاغة الصحفية بأساليبها الحداثية المعاصرة، ومن هذه الثقافة تأثر كبار الحكائين المحترفين الذين فتحت لهم الصحافة صفحاتها، إنها روح حكاء جنوبي من الطبقة الوسطى».
وكان طوغان قد أصدر، في عام 1957، كتابًا بعنوان «قضايا الشعوب»، عن جريدة الجمهورية، كتب مقدمته الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان وقتئذٍ ضابطًا من الضباط الأحرار يتولى إدارة تحرير جريدة الجمهورية، أراها مقدمة صالحة لهذا الكتاب الذي بين أيدينا، كاشفًا عن أهم أسباب روعة هذه السيرة، فكتب بداية متعجبًا متسائلًا عن هذه القدرة الخلاقة التي مكنت طوغان من جعل الخطوط والظلال قصصًا خالدة تروي للأجيال القادمة حديث أشرف معركة تخوضها مصر، بهذا الوضوح وبهذه الرزانة والإصرار الذي لا يقدر عليه إلا مَن أفنوا عمرًا طويلًا في البحث والخبرة والمران!
ثم قرر أن السبب لن يكون غير الألم؛ فكتب السادات في مقدمته لـ «قضايا الشعوب»: «إنها الآلام التي صهرت هذه النفس الوادعة في مستهل العمر، ومطلع أيام الشباب، عرفها طوغان وهو حدث، وصارعها وهو يافع، وأفاد منها في شبابه خبرة وحكمة لا تصنعهما في سنين قليلة آلام كبيرة!»
ولم يكذب السادات خبرًا، إذ تبدأ مذكرات طوغان فعلًا بفصل شديد الإيلام، معنون بـ «بداية القصة»، في مقطع كتبه تحت عنوان «بين المنيا وأسيوط»، وهما المدينتان اللتان عاش فيهما طفولته المبكرة، أول ما اهتم به فيه تقديم صورة لأمه، وكانت صورة مفارقة عجيبة، حيث كتب: «كنت أنا الولد الأول لوالدتي، ويبدو أن ذلك هو سبب اهتمامها بي، وبالرغم من انشغالها في شؤون المنزل وهوايتها بالعزف على البيانو الذي كان ضمن مقتنياتها إلا أنها تفرغت لي معظم الوقت، علمتني القراءة والكتابة، وأنشأتني على الجدية، والالتزام، وحب الناس، واحترام الكبير، والاعتزاز بالنفس، والصدق، والصبر، والقناعة، وكراهية الظلم، وعيادة المريض، وعدم التفكير في الثأر أو الانتقام حتى من أولئك الذين يسيئون لنا، لأن الله هو الذي سيتولى عقابهم في الدنيا وفي الآخرة. ومن نصيب وحظ أبي زواجه بأمي، فقد كانت تعامله كالسيد وهي الجارية، عندما يرجع إلى المنزل تتبعه حتى يدخل إلى غرفته ويناولها السترة ورباط العنق، ثم يجلس على كرسي، عندها تنزل إلى الأرض وتخلع عن قدميه الحذاء!
ولم يكن يُسمع لها صوت، كما كانت في غاية الطيبة والرضا والهدوء وسعة الأفق وحسن التدبير، وعاشت حتى السبعين ورحلت بعد أن تحملت الكثير».
كان والده ضابط شرطة متفانيًا في عمله، مخلصًا لوطنه، عمل في المنيا، ثم أسيوط، ثم الجيزة، لكنه لم يكن زوجًا على الدرجة ذاتها من الإخلاص لهذه الزوجة الودود والتفاني من أجلها؛ فقد تزوج عليها مرتين، قبل أن يصاب بفقدان الرؤية الذي سبب له اكتئابًا أودى بحياته، لتضع الأقدار طوغان في خط المواجهة الأول كرجل للبيت خليفة لأبيه، مسؤولًا عن أمه، وعن أخ يصغره ببضع سنين، اسمه عبدالسلام، يعاني من روماتيزم في القلب.
لكن: «ماتت أمي بعد وفاة أبي بسبعة عشر عامًا، وتركت لي فراغًا وأسى وحزنًا ما زلت أعيش فيه حتى الآن، وكثيرًا ما يأكلني الندم وأنا أتذكر المرات النادرة التي عاملتها فيها بما لا تستحقه من توقير واحترام، خصوصًا بعد وفاة أبي وتسلمي زمام المنزل». الندم ألم.
ويحكي قصة أخيه «عبدالسلام»، الفتى البالغ من العمر 19 عامًا الذي كان فرحًا برسوم أخيه للغاية، حتى إنه قام بتوزيع خمسة آلاف نسخة من كتاب رسوم له بنفسه، تقديرًا لموهبته، فيكتب طوغان الأسى قائلًا: «فجأة سقط عبدالسلام وارتمى على السرير وأصبح يتنفس بصعوبة، فضربت لخمة، ثم ذهبت وجئت بالطبيب علي عيسى أستاذ أمراض القلب، الذي همس في أذني بأن الوضع ميئوس منه، وأنه لو تمكن من النجاة خلال الساعات الخمس القادمة يكون قد كتبت له الحياة من جديد، وغادر الطبيب ولم يوصِ بأي دواء، أو أية وسيلة للإنقاذ!
وزاد ضيق التنفس على عبدالسلام، وتورمت رجلاه، وفجأة شاهدنا صدره يعلو ويتضخم؛ كان القلب يحاول سحب الدم وعندما عجز انفجر كالبركان، في هذه اللحظة نهض عبدالسلام ورفع إصبعه بالشهادة، ولن أنسى ما حييت نظرته لي، تصورت أن فيها شيئًا من العتاب، وتخيلت أنني قصرت عندما جاءتني أمي باقتراح المستشفى، كما تصورت أنني اخترت الطبيب غير المناسب، الذي لم يكتب أي دواء، ولم ينصح حتى بأنبوبة أوكسجين!»
لكن هذا الموقف سيتسبب في ألا يأكل طوغان البلح طوال حياته: «الجملة الوحيدة التي نطق بها عبدالسلام كانت: عاوز بلحة. ولسوء طالعي تصورت أن أي شيء سيأكله وهو في هذه الحالة سيصعد الأزمة، فأحجمت عن تلبية طلبه، وهو ما لا أستطيع مسامحة نفسي عليه أبدًا، عندما عرفت بعدها أنها كانت سكرات الموت، وأنها كانت رغبته الأخيرة، وأن الدم عندما وصل إلى فمه أراد تغيير مرارته بطعم البلح!»
عاقب طوغان نفسه بأن حرم عليها أكل البلح إلى الأبد!
ومع ذلك تبقى نفسه تعذبه: «أحيانًا كثيرة أتصور أننا قد تسرعنا في دفنه، وأنه كان ينبغي إبقاؤه يومًا أو يومين، وأنه سوف يقوم من رقدته ويعجز عن فتح المقبرة، وحتى اليوم لا تمر ليلة دون أن تضنيني أو تؤرقني فيها ذكرى عبدالسلام».
وسيحتدم عذاب الندم حتى هذه الدرجة: «كلما جاءني نبأ مفرح تصدت له نظرة عتاب من عيون عبدالسلام».
ومثلما تبدأ مذكرات طوغان بآلام الندم فإنها تنتهي بألم أشد وأنكى، وهو ألم فقد فلذة الكبد، موت ابنه الكبير بسام في نادي الفروسية وهو يمارس رياضة ركوب الخيل، ولم يكن بسام مجرد ابن، وإنما على حد وصف أبيه له كان: «نموذجًا فريدًا بين الرجال، راجح العقل، كنت إذا احتجت للرأي ألقاه عنده، وإذا بحثت عن النقد أجده لديه، حتى بالنسبة لأفكاري الكاريكاتيرية، كان ثاقب الفكر، سليم التقييم، ودائمًا ما لجأت إليه للمشورة والقول الفصل».
وبعيدًا عن آلام الندم والفقد كان طبيعيًّا أن يعرج طوغان على الإشارات الأولى المبشرة به رسامًا كاركاتيريًّا لامعًا، فكتب عن مدرسة ديروط الابتدائية للبنين الأقباط، أول مدرسة التحق بها، والمسافة بينها وبين المنزل الذي كان يقيم فيه مع أسرته حوالي أربعة كيلو مترات، يقطعها سيرًا على قدميه جيئة وذهابًا، مخترقًا حقلًا فسيحًا مفروشًا بالفول الأخضر معظم أيام السنة، في هذه المدرسة، التي لم يكن بها غير تسعة تلاميذ مسلمين، اكتشف طوغان امتلاكه موهبة الرسم بمساعدة وتشجيع كبيرين من الأستاذ وليم أفندي جريس، مدرس الرسم، الذي يتكلم عنه طوغان بامتنان كبير قائلًا: «كان دمث الخلق، كريم الخصال، فرح عندما اكتشف قدرتي على التعبير بالخطوط، وأوصاني بإعطاء الوقت الكافي لتنمية ما أملكه من موهبة، وقوله بأن مستقبلي في فن الرسم لن أنساه، كما حدثني عن أهمية هذا الفن، وأن مجد الفنان المصري مسجل به».
وهي النصيحة التي احتفظ بها طوغان «في نفسه وعقله»، على حد تعبيره، ليواصل الرسم، وهو ما كان سببًا في تفرده بين زملائه، ليكتسب الثقة والإحساس بالرضا، وأحيانًا بالزهو.
ثم يتفرد بين رسامي العالم العربي كله لهذا الفن!
ومن المهم أن نعود إلى تقدمة خيري شلبي لهذا الكتاب لنقرأ ملحوظته بخصوص إفادة أخرى مهمة تقدمها لنا هذه المذكرات التي من خلالها: «نتعرف على العديد من الصحف والمجلات المجهولة التي أسهم طوغان في إصدارها وسار بها من فشل إلى فشل، ومن نجاح إلى نجاحات، وبين الفشل والنجاح نتعرف على مراحل تحديث الصحافة المصرية، وكيف تطورت موضوعيًّا وتقنيًّا واجتماعيًّا، من الجمع اليدوي إلى الطباعة الحديثة المتقدمة، من الأبيض والأسود إلى الألوان الزاهية، ونتعرف كذلك على دور الصحافة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، حتى وضع تأميم الصحافة نهاية لذروة من ذُرا صعودها إلى عصر إخصائها!»
ولنقرأ تقييم هذا الأديب الكبير لهذه السيرة عندما كتب قائلًا: «إنها مذكرات خصيبة كطمي النيل، حين تنتقل إلى ذهن القارئ تخصب وجدانه فتنبت فيه من جديد زهور الحياة، تخضوضر شجرة المسؤولية الوطنية في نفوس الشباب فتستيقظ فيهم مقومات الرجولة، تلك التي تقدم الواجب على المصلحة الشخصية، والوطن على الذات، حيث لا كرامة لرجال في وطن هان، ولا قيامة لوطن يسيطر على مقدراته أشباه الرجال».
والآن، ليس هناك أفضل مما كتبه الرئيس الراحل أنور السادات منهيًا تقدمته التي كتبها لكتاب طوغان «قضايا الشعوب» كي ننهي به هذه المقالة المستعرضة لسيرة أحمد طوغان، عندما كتب: “كل ما أردت أن أقوله لك هو أنها قصة لفنان صنعته الآلام”.
(ميدل ايست اونلاين)