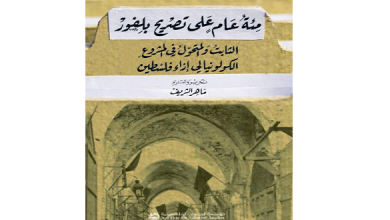خالد محمد: الصوفي يبحث عن قلب ينبضُ بالحياة

محمد الحمامصي
يرى الباحث خالد محمد عبده في كتابه “معنى أن تكن صوفيًا” الصادر أخيرا عن مركز المحروسة، والذي يعد رحلة روحانية في تجليات الصوفية شيخا ومقاما وتراثا عظيما، أن التصوف أن تكون إنسانًا أّوًلا وقبل كِّل شيء٬ وأن تحقق معنى “وفيك انطوى العالُم الأكبر”، وتتذّكر أنك مهما علوت أو هبطت وعيت أو غفلت سهوت أو تذّكرت٬ فأنت حي تحيا بالله، وأن ليس هناك قواطع وحدود صنعت وبُّت في أمرها مسبقًا٬ ولا بد أن تسعى على درب قدُ حدد لك من قبل٬ أنت تحاول، أنت تفكر٬ أنت تجاهد نفسك ما استطعت أن تحيا وتتجدد.
قال ربك في الكتاب “يزيد في الخلق ما يشاء” و”أنا عند ظن عبدي بي”٬ أنا لا أقف لعبدي بالمرصاد كي ألقيه في حفرة٬ ولا أتحيّن الفرصة لسهو أو غلط فألقي به في النار لأجل جملة أو كلمة أو حرف٬ أنا آخذ العباد بما كسبت قلوبهم واستيقنوا به وقّدموه٬ إن خيرًا فخيرًا٬ وإن شّرًا فشرًا، وربّك الغفور ذو الرحمة.
يقوم الباحث في الكتاب برحلته إلى عالم الصوفية مستعينا برؤيته وأقوال ومواقف وتجليات كبار الصوفية، بالإضافة إلى مقامات الأولياء في مصر وتركيا والسنغال حيث يحكي عن مشاهداته ولقاءاته ليرصد صورًا وآراء مهمة حول قضايا التصوف، يقول “قيل قديمًا: التّصوُف: هو استرساُل النّفس مع الله على ما يريده.
وكان من دعاء أحدهم:
“يا إلهي٬ اجعل عين قلبي مبصرة وأرشدني إلى معراج اليقين٬ وافتح بالّرحمة كنوز الُجوِد عليّ، وادُع قلبي إلى ساحِة الأمل٬ وارزقني قلبًا عامرًا بالثناء عليك٬ ولسانًا يكوُن بمنأى عن مدح من سواك٬ واشغل تفكيري بشكرك في الّسراء٬ وزد حمدي لك في الّضراء وسق هودج أملي إلى حيث يقع باب الفلاح٬ وبما أنك قد سموت بي في الدنيا عن التراب٬ فلا تُسلمني في الأخرى إلى طوفان الهلاك٬ واغمرني بالعفو حتى أصبح طاهرًا٬ وأحيني بذاتك حتى لا أموت، فليس ما أحمله قلبًا٬ إنما هو جماد أمتلكه في الخفاء٬ وأنت من يهب الأموات الحياة٬ ولتُنر هذا الضريَح الترابي بالعقِل المنير والفكر النقي٬ وما ذلك الأمل الذي أعلّقه على تلك الحياة إلاّ إضاعة لها في الغفلة٬ فلا تذرني في نوم الغفلة أكثر من ذلك فإن أمامي نومًا آخر.
وإني أخط في صحيفتي لازدهار أيامي٬ وعندما تنتهي زخرفة هذا الديباج٬ فلتكتبه عندك في سجل العتقاء من النار. ولا تسألني عن حسابي الذي لا يستحُق التقويم٬ فإنه لا يستحق السؤال. وليكن كرُمك حارس سوقي وعنايتُك وكيلي في عملي٬ وجدد أملي بغفرانك٬ واجعل أملي فيك يفوق الحدود”.
• الصوفي وصلته بالله
ويشير إلى أن الصوفي يبحث عن قلب ينبضُ بالحياة، ويطلبُ الرشاد إلى معراج سماوي، في كل لحظة تتجدد فيه صلته بالله يكون الله صديقه الأوحد ومطعمه وساقيه، لا يبحث عن كنز من المال والمادة، بل يطلب فتح كنوز الرحمات حتى تتنزل على العباد، ولا يريد أن يرى إلاّ الله، وفي كُلّ حسن يرى صورة الله وتجلياته، يريد أن يتخلّص من غبار النفس الزائف ومن ترابها الذي يمنعه من الحياة، يطلبُ العفو وإن تورّمت قدماه قياماً وصلاة لله، يطلب النور الأعلى، وإن كان في حضرة ربّ العباد.
يؤمن الصوفيُّ أن قلبه قطعة مُضغة تتكوّن لحظة بلحظة وتتجدد فيها الحياة بالله، وعلى قدر صفاء القلب تصفو الحياة، وعلى قدر طهارة القلب تُقبل صلاته وتتأكد صِلاته، لا ينشغلُ الصوفيّ بالصورة الظاهرة، وإن كان الظاهر يتجمّلُ من خلال الباطن، فلا ينشغل كثيراً بالطاهر من الماء أو المكان؛ فالعالم كله منه وبه طاهر، يعرف أنواع الماء السبعة لكنه غير مشغول بنقل أحكام الطهارة البرّانية وصحيح نُطق القرآن وكيفية المعاملات كما وردت في الكتاب أو السنّة فحسب، وهمُّه الأكبر أن يجدّ في طلب الحقيقة ويجدها، ويسهم فيها، ويكون جزءًا منها، ويكون قلباً وقالباً ترجمة لها.
• أن تكون صوفيّاً
ويقول “أن تكون صوفيّاً؛ يعني أنك تلتمسُ من الحياة ما فيه نفع للعباد وتقدّمه على منافعك حتى ولو كانت قربة لله وأداء فريضة من فرائض الدين. كان أحدهم قد روى عن بايزيد البسطامي قصة تقول:
كانت مع البسطامي مجموعة من الدراهم وأراد أن يحجّ، وفي طريقه للحج وجد عجوزاً صاحب عيال فقير، فسأله الفقيرُ عن وجهته فأخبره أنه ذاهب إلى الحج حيث الكعبة بيت الله يطوف كما المناسك، فرجاه أن يطوف به ويعطيه المال فهو أحوج إليه هو وعياله، والبسطامي أحوج إن كان عبداً لله أن يطوف ببيت الله الحيّ “قلوب العباد عياله”، وقد فعل البسطامي وانصرف عن الحج.
وقد انصرف أهل الصورة عن المعنى الكامن في فعل البسطامي وترجموه إلى إهمال الفرائض والاستخفاف بالدين، ونسوا ما هو أولى من ذلك، أن العاقل لا ينشغل بفعل غيره مع ربه، وأولى به أن ينشغل بالله. وأن تكون صوفيّاً؛ أي أن تخلع عنك كل الأفكار المُسبقة ما كان بالياً منها أو حديثاً، ولا تفرض فكراً على أحد ولا تنشغل بأفكار الآخرين مهما ظهر لك أنها لا تناسبك ولا تناسب الآدميين، وإن كنت مهموماً بتغيير العالم من حولك، فإنه سيتغير حتماً إن تغيّرت، ومن خلال حياتك الناجحة وبشريتك الراقية سيسعى غيرك للحصول على ما حصلت”.
يُروى أن رجلين من أهل الله في طريق سفر من بلدة لأخرى، وفي الطريق مرا بنهر، ووجدا على ضفته امرأة تنتظر بمفردها في وقت متأخر، وتبدو عليها ملامح الحزن والأسى، فسألاها: يا أختاه هل تحتاجين من شيء نقدمه لك، فقالت: أريد العبور للضفة الأخرى لأعود لأولادي ولكنني تأخرت وأخاف الغرق، فسارع أحد الرجلين إليها وحنى ظهره وقال لها اركبي، فامتطت المرأة ظهره وعبر بها إلى الضفة الأخرى من النهر، وبعدها أنزلها وألقى عليها السلام، ثم انطلق مع صاحبه إلى وجهتهما، وبعد مسيرة يومين من السفر، قال له صاحبه: هناك سؤال يؤرقني طوال سفرنا، فهل لي أن أسأله إياك، فأشار إليه بالموافقة، فسأله: كيف تسنّى لك وأنت شيخ عالم فاضل أن تمس امرأة لا تحل لك، بل وتحملها على ظهرك وتشعر بحرارة صدرها على ظهرك، وتحتّك أبدانكما أحدهما بالآخر، أليس هذا حرام؟ فأجابه صاحبه مبتسماً: والله يا صاحبي، لقد تركت أنا المرأة على ضفة النهر الأخرى قبل يومين، ولكن يبدو أنك لم تتركها طوال اليومين حتى هذه اللحظة.
• مقامات الأولياء
ومن أجواء رحلة الباحث إلى مقامات الأولياء يحكي:
“محمود وغيره كثيرون، ينتقلون من القاهرة إلى جميع الموالد في مصر، ولديهم خريطة لكل الأماكن، لا يحملون إلاّ أجسادهم في السفر، ويرزقون بنيّاتهم، مخلصون للغاية لما يدينون به. يحكي محمود الخوارق دون أن يشعر بخارق أو معجز؛ فالغيث الذي نزل من السماء يصيب رؤوس العباد، وهو بينهم لا يصيبه، يكون مدد السماء سببًا لجذب محمود، فمنذ سنته التاسعة، وهو صبي يجلس ليخدم عباد الله، يقدّم الطعام والشراب، وفي حديثه إصرار عجيب على أهمية الإطعام والإنفاق، وهو لا يملك إلاّ قلبه.
يسألني أحدهم عن معنى الخدمة وأنا هناك؛ فأخبره أن كلّ شخص يقدّم ما في مستطاعه. أجلس أنا وبسيوني الذي يكبرني قلبًا وكرمًا وإن كان يصغرني ببضعة أعوام في خدمة سيدة عجوز تستند إلى عمود يقابل الباب الرئيس لمقام سيدي عبدالرحيم القناوي، السيدة جالسة وأمامها رجال كثيرون وأحد الرجال سمته بهيٌّا يقول: (كريمة يا ست) قاصدًا السيدة زينب رضي الله عنها وعلى كل محبيها. يجلب لنا طعامًا (عيش وطعمية) آكل كسرة، وأسأله أن يصب لنا الشاي، حتى نمضي إلى حيث قُدّر لنا. هذا اللون من الخدمة على بساطته أجمل من الجلوس في فندق يُمنح سبعاً من النجوم !
في جامع الفناء في مراكش (مدينة الأولياء السبع)، كنت أسير نهارًا بمفردي، وكان الجو في حرارته يشبه جو الأقصر، وإن كان الفناء لا يشبه المعمار العربي بالنسبة لي، كان كل شيء يباع في الفناء، لم أسترح في المكان كما استرحت وأنا جالس في وسط الباعة الجائلين أمام جامع الكُتبية، جلب لي أحدهم الشاي، وأخذنا نحكي أكثر من ساعة، لا تملّ مجلسهم أبدًا. في وسط المكان هناك، يجلس أحدهم مستظلاً بشجرة، يصنع أساور من نحاس ويكتب عليها اسم من يريد شراءها، أحدهم يبيع قبّعات إفرنجية، وأحدهم يطلي بفرشاته نماذج مصغّرة لأثر الكتبية ويبيعها، وأحدهم يرسم لوحات يتكسّب من ورائها. لا زلت أذكر أحد الباعة الذي ناداني؛ حيث كان لديه أعشاب تُباع بالجرام لتقوية الباه وتحقيق مكاسب جنسية هائلة.
حين انتقلنا بعد رحلة كانت كلها عناء ومشقة إلى سيدي أبي الحسن الشاذلي في حُميثرة، كان أمام المسجد بائع طاعن في السن ذو وجه ملائكي وصوتٍ خافت يبيع الأعشاب، منها ما هو لوجع البطن والمعدة، ومنها ما هو لمرضى السكر؛ فسألته متذكّرًا (مراكش): (مفيش حاجه للتقوية والستات)، فأجابني مبتسمًا وأنا أضحك: “المقوّي ربنا “.
كانت زيارة مقام الشاذلي الكبير سريعة ودون إطالة، وقد بدأناها بزيارة السيدة زكية خادمته والمقيمة في جواره. توضأتُ من ماء البئر المجاور للعجوز الباسم، وصليتُ ركعتين خفيفتين، ثم عدنا إلى مركبتنا التي لم يحالفها الحظّ أن تكمل المسيرة دون عتل فقد كدنا أن نُدفن في ليلتنا هذه في الصحراء إلا أن الله تغمدنا برحمته، ونجونا من حادث ربما بعده بُنيت لنا قبة وكتب عليها هنا يرقد “العظماء السبعة”!
(ميدل ايس اونلاين)