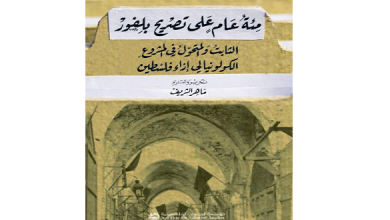«همس» خالد عاشور: قصص مُعذَّبة بالنَّسق وطقوسه

عبد الدائم السلامي
عندما قرأت مجموعة خالد عاشور القصصية الموسومة بـ«همس» والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب تبدّدت عندي صورةُ وهمٍ قديم يقول إنّ نجيب محفوظ قد حلب المدينةَ المصرية واستقطر شوارعَها من كلّ تفاصيلها وأحداثها ولم يُبق للكُتّاب من بعده إلاّ قشورا لا تُسمن التخييل. ذلك أن خالد عاشور قد كشف عن عبقرية المعيش المصريّ السردية، وأكّد على مدار خمس عشرة قصة قصيرة أنه يتكئ على تلك العبقرية لكتابة قصّة لا يهدأ صراعها مع ذاتها ومع أنظمة النَّفيِ الرسمية، إنها قصةٌ ولاّدةُ دَلالات لا يظفر منها القارئ بيقين ولا يبلغ فيها كلَّ حمولتها السياسية والاجتماعية، وتلك لذاذتها. أبطال تحرّروا من ثقل أسمائهم، تروي سيرتهم قصصٌ لها طاقة على الحركة كبيرة حرّرت فيها كلّ إمكانات الكتابة الوَجَعيّة الساخرة، وذاك أسلوبها. إنها مشهديات مكتظة بصنوف من الحياة المغموسة في الصّمت، بل هي صدى لتأوّه روحٍ تُجبَرُ على فقدِ معناها، روح لها وعيٌ معذَّب بالنَّسق وطقوسه، إنها باختصار كتابة مُضادّة لثقافة الرتابة وثقافة المحوِ.
اسمُ العَلَمِ هو المَحْوُ. إنه عبء يحمله الكائن المسمّى به، بل هو لعنة اعتباطية تحل عليه لتُلغي حضوره الماديّ، الاسمُ ضدّ الحضور، إنه مكرٌ بالكيان وعَزْله. قد نستفيد في تأكيد هذا الرأي من السيميائية حين تُعلن أن وجود اسم العلم في الخطاب يدلّ على غياب المسمّى به جسدًا وأحوالاً، بل إنّ الكائن واسمه لا يجتمعان إلاّ بسُلطان حرف النداء أو اسم الإشارة على غرار «يا خالد» (نستعملها عندما ننادي كائنا أمامنا) أو «هذا خالد» (ونشير بها إلى كائن حاضر بيننا)، علما أنّ في الإشارة والنداء ضربًا من الغفلة التي تُخيّم على وجود الكائن المخصوص بهما، وهي غفلة تشبه الغياب، وهو غياب استفادت منه شخصيات قصص خالد عاشور، حيث تحرّرت من سلطة أسمائها وحضرت في السرد، عبر عين السارد، ممتلئة بكياناتها وأحلامها وأوهامها. وإذا ذهبنا مذهب جون ستيوارت ميل، قلنا إن اسم العلم يدلّ على المسمّى ولا يُحيل إلى ما نحمل عنه من تصوّرات ومعارف داخل مجموعته الاجتماعية. فاسم «خالد» مثلا لا يحمل شيئا من أحوال المواطن المصري الذي نشر مجموعة قصصية بعنوان «همس» وإنما هو لفظ معلّق بكيانه ينوب عنه إذا غاب. يحضر الاسم فيغيب المُسمّى. ويحضر المسمّى فلا نحتاج معه إلى الاسم. ويبدو أن قصص خالد عاشور اختارت أن تتحرّك داخل منطقة تصوّراتنا عن الكائن دون اسمه، وبنت شخصياتها خارج أفق أسمائها الرسمية، أي خارج سجونِ تعيينها، لكأنها مارست محوًا مضادًّا: محو سلطةِ الاسم ومكرِه لتُفسح في المجال لسلطة المُسمّى ليكون خير الماكرين. وصورةُ ذلك أن شخصيات القصص وردت بلا أسماء عدا اثنتيْن نجدهما في قصّتيْ «الخالة قمر» و«غرفة سلمى»، حيث نتبيّن أنّ حضور اسم الشخصية في الحكي ساهم في اضمحلال كيانها الاجتماعي، ذلك أنّ القصة الأولى انتهت بموت «قمر»، وآلت الثانية إلى عزلة «سلمى» وهروبها من الناس.
ومن الوجيه القول إن تحرير خالد عاشور لأبطال قصصه من عبء أسمائهم مثّل بالنسبة إليه تقنية سردية لاذ بها سبيلا إلى تحقيق هدفيْن: أولهما تأكيد شيوع الحالة المحكية في واقع الناس من دون اقتصارها على شخصية مفردة لها اسم يُعيّنها، وثانيهما سهولة النفاذ إلى الهامش المصري واستدراج كائناته لتتجلّى في قصصه بكلّ أتربة تفاصيلها بعيدا عن مكرِ اليافطات الرسميّة النظيـــفة، فإذا هو فضاءُ عتمةٍ يهيج فيه الوجـــع الإنسانيّ في صمت، وهو ما حفز كلّ شخصية لأنْ تنفجــــر في الحكاية بتفاصــــيلها وأسرارها انفجارا محمولا في دراماتورجيا سردية امتزجت فيها، بمهارة فنية عالية، حالُ المكان بأحوال الشخصية وبزمن انفعالها وبأسئلة الراوي امتزاجا مكتظًّا بالوجع ومكتظًّا بالسخرية في الآن نفسه.
ومن أجلى صور ذلك أن بطلة قصّة «همس» عاشت حياتها الزوجية في الظلمة والصمت، ولما أرادت الخروج على سلطة الصمت ماتت مظلومة. فقد كان زوجها يأتي «في الظلام يبحث عنها، ككلّ يوم يبحث عنها، يعرف مكانها وماذا سيفعل بالضبط من دون صوت، فالليل سكون، وفي السكون يكون للهمس صدى وهي تخشى أن يسمعها أحد وهي تمارس معه شرع الله»، غير أنّ سؤالا ظلّ يلحّ عليها: «لماذا لا تتكلّم وتصارحه ذات مرّة أنها ملّت ذلك الصمت وهو يفعل معها شرع الله؟». ولأن السؤال فكرة، والفكرة مثل «شرع الله» لا تُنجز إلا في الصمت وفي السرِّ معا، وجدت هذه الزوجة في الشاب الأعزب ساكن الدّور الثالث من العمارة كائنا يسمع فكرتها، ويبيح لها أن تُعلنها خارج الصمت، ومن ثمة «لم تتحمّل العودة إلى الهمس فصعدت بإرادتها لتعلن بداخلها نهاية الهمس بلا رجعة» ومعه أيضا «أعلنت ثورتها على الهمس وراحت تتأوّه معلنة نهاية زمن الهمس، وغابت عن الوعي». وما كان لثورتها على الهمس أن تتحقّق من دون خسائر، إذْ في نزولها إلى بيتها تنبّه زوجها لعلاقتها بساكن الدور الثالث، و«للمرة الأولى تخرج عن الهمس حين أطبق على رقبتها بيديْه، فارتفع صراخها» «غير أن صرخاتها وآهاتها تضعف حتى تتحوّل إلى همس كلما اشتدّ بقبضته أكثر، وفي همس أيضا تسكن أنفاسها وتتوقف، فقط في همس». والمائز الفنيّ في سرد هذه القصة هو نهوضها على حركتيْن: حركة الصعود إلى اللذّة، وحركة النزول إلى المنع، بل قل حركة الحياة في الضوء وحركة الموت في الظلمة.
ولئن أخلص موضوع هذه القصّة غايتَه لكشف سلطة التقاليد وأوجاعها التي تخز باستمرار جسد العلائق الاجتماعية فإن باقي قصص خالد درويش راوحت في محكياتها بين توصيف الواقع والسخرية من فوضاه ومن ارتباك مؤسّساته على غرار قصص «نظام» و«الحارس» و«غرفة سلمى» وخاصة قصة «الإمام» التي يذكر فيها الراوي أن بطلها أزهريٌّ خرّيجُ قسم الفلسفة، تمّ تعيينه بالصدفة ليؤمّ الناس بالمسجد من دون النظر إلى سواء سيرته الاجتماعية، فكان كلّما صعد درجة من درجات المنبر ليخطب فيهم تذكّر ملمحا من ملامح فساد تاريخه الشخصي، ففي الدرجة الأولى تذكّر «تلصّصه على الجارات عبر النوافذ»، وفي الثانية عادات به ذاكرته إلى فترة المراهقة حيث اكتشف العادة السرية، وفي الثالثة يعرّفنا أنه كان مولعا بمجلات الجنس حتى سمّاه زملاؤه الطلبة «الشيخ سكس»، وفي الدرجة الرابعة يذكر أن «أحلامه في تدريس الفلسفة تبخّرت، أخبروه أن إيمانه بالفلسفة سيورثه الكفر»، وفي الدرجة الخامسة يعترف بأنّ «فاقد الشيء لا يعطيه»، ولما وصل إلى المنبر ونظر إلى المصلّين أمامه، خشي أن يكون «من بينهم زوج لإحدى عشيقاته»، ولكنه مع ذلك راح يخطب في الناس قائلا: «أيها الناس اتقوا ربَّكم» وكان الصوتُ صوتَه.
ويبدو أنه عدا قصص «عصفوران» و«قهوة والي» و«الخبر» و«الرئيس» التي بدت لي ضعيفة البناء الفني وتغلب عليها التقريريّة تمكّن خالد عاشـــور من خلق عالم قصصي جدير بمكانه وزمانه وحال قارئه، وقد أجاد استثمار تقنيات ســرديّة عديدة لعلّ منها التكرار (قصة: همس) وتفصيح اللهجة الدارجة، وتنويع زوايا النظر إلى المشهد المحكي، وهو ما منح قصصه ديناميةً ثرّةَ الإحالات والأسئلة.
(القدس العربي)