تحوّلات مصر في ذاكرة محسن عبد العزيز الروائية
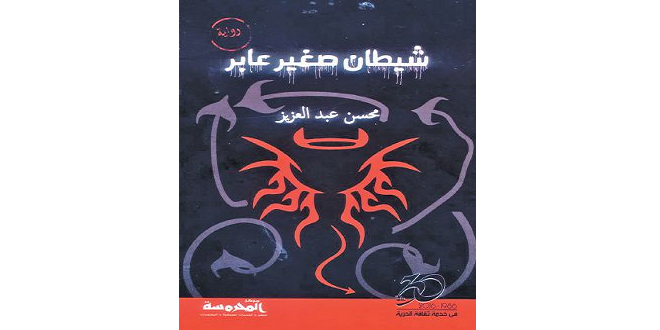
عمار علي حسن
في رواية «شيطان صغير عابر» (المحروسة) للمصري محسن عبدالعزيز، نقابل بطلاً بذاكرةٍ لا تسعفه في استحضار وجه أمه التي غيَّبها الموت وهو صغير، غير أنّها تستدعي في المقابل تفاصيل دقيقة عن شخصيات ومواقف ومشاهد من زمن بعيد. تجتمع هذه التفاصيل لتصنع في مجملها صورة عن قرية مصرية، قبل عقود خلت، تشكل السياق العام للنص.
تنقسم الرواية إلى ستة فصول، تندرج تحت كل واحد منها عناوين فرعية، تحيل إلى أماكن ومواقف وشخصيات وحالات إنسانية، ينتظم بعضها في وحدة عضوية، باحثة عن همزة وصل مع بقية الفصول. وتستدعي ذلك كله ذاكرة راوٍ عليم، تحاول تجاوز العفوية بشيء من التدبير في صنع صلات بين هذه الأشتات التي ترسم في خاتمة المطاف ملامح بناء روائي مختلف.
حكايات
هذه الرواية هي الأولى لصاحبها بعد مجموعتين قصصيتين وكتابين في السياسة، تتوالى فيها مقاطع محبوكة بعناية، كل منها يصلح، في ذاته، قصة قصيرة، حيث اللغة المكثفة والنهاية التي تنطوي على مفارقة، واكتمال الحدث. لكنّ هذه القصص تشكل مشاهد وسير شخصيات، يربط بينها خيط روائي يجمعها في وحدة نصية، أو نص واحد، متكئاً على وحدة المكان والراوي والطقوس الريفية، وتتابع الزمن لدى البطل من الطفولة الغضة إلى الشباب اليافع.
هنا، تتناسل الحكايات والشخــصيـــات والمنــاسبات والأماكن، فتنتقل من الحقل إلى المدرسة، ومن الجامع إلى البيوت، ومن الأفراح والموالد إلى الجنائز والمآتم، ومن المؤسسات المحلية إلى ملاعب كرة القدم البسيطة. وتطل علينا وجوه أطفالٍ صغار، وفتيان مفعمين بالحيوية والأمل، وعجائز حزينات، وفتيات قادرات على الغواية، وألوان من اللعب والمذاكرة والغزل والكدح، وأنواع من البشر المختلفين في السنّ والرؤى والدين والفكر والشريحة الاجـــتماعيـة والخــلفــيــة التعليمية والمهنية، وفي دور الأسرة الصغيرة والعائلة الممتدة وقوافل الدعوة الدينية والأندية الرياضية. وفي هذا كله، نرى ما كانت عليه القرية المصرية في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته، وما آلت إليه، بعدما زحفت إليها قشور التمدين الظاهري، وطاولتها يد العولمة، وضربها التزمّت العقائدي، الذي أوجد خلافاً بين المسلمين، واحتقاناً مع المسيحيين.
هذه العوامل تجعل من صورة القرية في هذه الرواية مختلفة عن إطارها التقليدي عن القرية المصرية، التي اعتادت أن تجعل منها وحدة مصغرة للدولة، وتسقط عليها كل ما يجري فيها من تسلط وفساد وتمرد. الكاتب هنا لا يعنيه هذا، وإن كانت أطلَّت من بين السطور أنماط من الصراع الاجتماعي والتنافس في التفوق الدراسي، والرغبة في السفر إلى الخارج بحثاً عن الثراء السريع، أو الحصول على فرصة عمل في الداخل بغية التقاط الرزق والتحقق، وكذلك التفاوت في الرؤى الدينية بين أزهريين أو منتسبين إلى وزارة الأوقاف وأتباع الطرق الصوفية، وبين من ينتمون إلى السلفية الدعوية والجماعات المتشددة، وتزاحم بعضهم على توظيف الدين من أجل كسب المكانة والهيبة والمشروعية الأخلاقية. ولم تقف الرواية بنا عند ما كابده طفل يتيم من زوجة أبيه، ولا كل حالات التمرد الذي كان يمثل القيمة الكبرى لديه، ثم علاقته في الطفولة والمراهقة والشباب بأقرانه في القرية، بل نقلتنا مع بطلها وراويها إلى المدينة، حيث تبدأ معاناة جديدة في البحث عن سكن وعمل وصحبة وفرصة في النجاح. وهكذا نشأت حالة من الاغتراب الشديد يعبر عنها الراوي قائلاً: «في القاهرة العاصمة القاصمة ستجد ناساً يتكلمون لغة أخرى، ويلبسون ملابس أخرى، أنت تشبههم فقط، بأن لك عينين ولساناً وشفتين، وتمشي على ساقين. وتجري أحياناً خلف الأتوبيس المزدحم، لكنك أبداً لست مثلهم، ولن تكون. فالمسافة بينك وبينهم أبعد من حدود صعيدك بكثير، ورغم ذلك جئت تحمل حزناً طاغياً، تنظر إلى العمارات والسيارات وزحام الشوارع، ولا تفقه شيئاً يا غريب».
عالم آخر
تنقلنا الرواية، في المدينة، إلى رحاب عالم آخر، متوسلة بالتحاق بطلها، بعدما أنهى دراسته الجامعية، بالعمل في صحيفة كبرى، فيتعرف الى صحافيين دفعهم قربهم من السلطة إلى الصفوف الأمامية، ومنهم واحدٌ، «كان إذا يطلع علينا نرتعد، ويروح الكلام في بئر الخوف العميقة. وحده كان قادراً أن يجعل الواحد، أي واحد، في سابع أرض أو سابع سماء».
تجود الرواية بلغة شعرية، إذ يصلح بعض مقاطعها أن يكون قصائد نثر، مثل تلك التي يتحدث فيها البطل عن جدته، التي حلَّت لسنوات محل أمه بعد رحيلها عن الدنيا، «تلك التي ظلَّلتنا تحت جناحيها، وحمتنا من الجوارح. طاقة النور التي طلعت من سماء الله ولم تنطفئ. فيا من تعرفون قبر جدتي، احملوا إليها دموعي الغزيرة في بلدتها البعيدة. فأنا لم أعرف كيف أبكيها بما يليق بسيدة جليلة المقام. ولا أعرف أين يوجد قبرها في مكان غير قلبي».
وتمتد هذه الشاعرية إلى تلك الصبغة الرومنطيقية الخالصة التي يضفيها الراوي على القرية. وفي حالات الفقر واليتم والغربة والإخفاق في تجربة الحب الأول، فإنه سرعان ما يستدعيها بعد أن تتقادم بعيداً، ليتصالح معها، وليصنع منها أسباباً جديدة للبهجة الغارقة في الحنين. وربما هذا الذي جعله يعود في المشهد الأخير من الرواية إلى القرية مرة أخرى، بعد مكابدته في المدينة، ليراها هذه المرة في شكل جديد بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) مباشرة، ثم انتفاضها ضد حكم «الإخوان». يحاول أن يعيد إليها شيئاً من الفرح، حين يتضاحك الرفاق على قيادة إخوانية محلية هربت إلى نيجيريا، تُدعى الشيخ مختار، «ها نحن الآن نضحك. لكن أين أنت يا شيخ مختار؟ أم أن الموضوع هذه المرة أكبر من خيالك، وأكبر من احتمالك ومن ضحكنا»؟.
(الحياة)




