شهادة عام سينمائي على قدرات السينما والناس في المقاومة
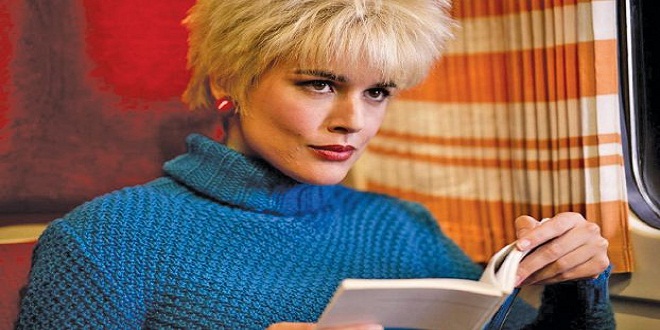
ابراهيم العريس
لم يكن العام المنتهي 2016 عاماً طيباً في أي مكان من العالم… فعام ملأته المجازر وشتى أصناف الإرهاب ولم ينتهِ إلا على وقع «الصدمة» التي أصابت العالم كله نتيجة انتخاب كثر من الأميركيين دونالد ترامب رئيساً لبلادهم متضافرة مع «صدمة» تحوّل «القيصر» الروسي الى جلاد آخر للشعب السوري، ليس من الأعوام التي يمكن أن تبشر بالخير. وعام تمتلئ فيه مياه البحر الأبيض المتوسط بجثث طافية لـ «مهاجرين» سريين كان كل ذنبهم أنهم يبحثون في أوروبا التي كانوا يعتقدونها أرض القيم الإنسانية الراسخة، عن مستقبل ما… عام لا يمكن أن يقول أن الإنسانية في خير. وعام يضرب فيه الإرهاب المقنّع بمسوح الإسلام خبط عشواء حاصداً الأرواح والأخلاق وكل إمكان للتعايش بين البشر، لا يمكن اعتباره إلا من تلك الأعوام التي يقول المرء عنها في نهاياتها: ليتها لم تكن!
أين المبدعون؟
غير أن الأدهى من ذلك هو الغياب شبه التام للإبداع عما يحدث، لا سيما في العالم العربي، حيث المبدعون منهمكون في اصطياد الجوائز والكتابة لكي يقرأهم محكّموها… وحيث التلفزة تزداد سخفاً يوماً بعد يوم، بما في ذلك «ضيوفها» من الذين يتحولون على الشاشة الى مهرجين، أو في أحسن الأحوال، الى متلعثمين يمضون ساعات استضافتهم وهم خائفون من أن يخطئوا فيقولون ما قد لا ترضى عنه العامة…
في مثل هذا العام لا يعود غريباً أن يرحل مبدعون طيبون من أمثال صادق جلال العظم ومحمد خان وعباس كيارستامي… ويمكن للائحة أن تطول… مثل هؤلاء كانوا في أزمان سابقة نوعاً من ضمانة لمقاومة حقيقية تقف ضد تفاهة أزماننا. صحيح أنهم لم يكونوا وحدهم المقاومين، لكن وجودهم كان دائماً تحريضياً، صحياً ومُعدياً. تماماً مثل وجود لوحظ، على أية حال، طوال العام المنقضي لسينما معينة جعلت من نفسها حصناً أخيراً ربما في وجه هجمة التفاهة واللاعقلانية والتعصب وتوحش العولمة والديكتاتوريات، المباشرة أو المقنّعة، وكراهية الآخر والمختلف… كراهية كل ما يتحدث، بعد، عن تقدم وانفتاح على العالم وتمسك بإحلال دينامية التاريخ بديلاً من جمودية الماضي القاتلة، والأخوّة بين البشر بديلاً من انغلاق «الهويات القاتلة»، وفق تعبير أمين معلوف الذي لم ينج هو الآخر هذا العام من فريسية المزايدين أصحاب القبضات المرفوعة… ولكن لتحمل قبض ريح لا أكثر…
قد يتساءل القارئ هنا: وما دخل هذا كله في سياق يريد لنفسه أن يكون استعراضاً لـ «أبرز» ما في عام سينمائي يرحل، وربما هو الآخر، غير مأسوف عليه؟ حسناً سيكون الجواب بسيطاً: إن لم تكن السينما قد عرفت وحدها كيف تقاوم الإنهيار العام، فإنها كانت في مقدم المقاومين على أية حال. وإذ نقول «السينما» هنا، فإننا لا نعني كل السينما ولا أية سينما كانت. حتى وإن كنا، في أعماقنا نجد ألف ما يغرينا بأن ننظر حتى الى السينمات التي قد لا نحبها وقد لا نتفق مع إيديولوجياتها أو حتى جمالياتها، باعتبارها هي الأخرى نوعاً من المقاومة… وعلى الأقل في وجه تلفزة تزداد يوماً بعد يوم، ديكتاتورية وتسلطاً وإمعاناً في ضخّ الناس، كل الناس، بما يقف ضد تطلعهم الى تشغيل عقولهم وفكرهم. فالسينما، بما فيها تلك التي قد تبدو أقل ذكاءً، تبقى فعل تقدم وخلق وعي في المجتمعات كافة. ولعل ليس ثمة ما هو أدلّ على هذا من أنها، وفي انحاء عديدة من العالم تتعرض الى الرقابة أكثر من أي فن آخر اليوم (حتى فيلم «البائع» للإيراني المميز أصغر فرهادي، جوبه برقابة قوية، رسمية واحتماعية في إيران. وحتى فرنسا، أم الحريات والتقدم، أرعب فيلم الفلسطينية مي المصري «3000 ليلة» بلدية مدينة آرجنتاي فيها، فحاولت منع عرضه في صالاتها… لكن مقاومة عادلة اندلعت هناك فردعتها وعُرض الفيلم).
أجل السينما هي الأكثر تعرّضاً للرقابات سواء أكــانت هــذه الأخيرة من النوع الغبي أم من النوع المتعسف. وذلك بالــتحديد لأن الـــسينما لا يزال لديها الكثير مما تقوله والكثير مما يثير النــقاش والكثير مما يشحذ الوعي، وكل هذه إن هي وعود بأن كل شيء لم يمت أو تلاشى بعد.
مهما يكن، وفق المرء أن يستعرض في ختام هذا العام، عدداً من أبرز أفلامه ليلاحظ الاداءات التي لا تزال مميّزة لسينما، هي الأخرى لا تزال مميّزة وتعرف كيف تقاوم. ولعل اللافت أكثر من أي شيء آخر في هذا السياق حقيقة أن الأفلام الأكثر وعياً وجمالاً، وبالتالي، جماهيرية إنما في حدود قد لا تكون فاقعة، ليست أفلاماً سرية أو صاخبة أو جديرة فقط بأن تُعرض، لنخبويتها في صالات الفن والتجربة، لا أكثر، أو في أحسن أحوالها، في المهرجانات. بل هي أفلام شعبية لا تخلو من تسلية ومرح وميلودراما وربما أحياناً من نجوم، ما يشير بوضوح الى ما يمكننا اعتباره «انتصاراً مدوياً» لتلك التيارات السينمائية المتقدمة التي ولدت في سياق تحركات الشبيبة والمثقفين الأكثر وعياً عند نهايات القرن العشرين…
فالحال، أننا إذا ما أردنا أن نضع لائحة ما بالأفلام السينمائية العشرة التي ما كان لها إلا أن تلفت أنظارنا طوال هذا العام الذي يلفظ أنفاسه هذه الأيام، سنجدنا أما شيء من الحيرة وصعوبة الاختيار لكننا في النهاية ولأن اللعبة هي اللعبة، ولا بد من لعبها ولو مرة في العام، سيقرّ قرارنا في نهاية الأمر.
عشرة أفلام وربما أكثر
وهاكم اللائحة التي تتبدى لنا، هنا والآن على الأقل… لائحة ربما ستكون ثابتة بعد أيام وربما ما كانت لتكون هي نفسها قبل أسابيع. اللعبة هي اللعبة سنقول: فهناك بالنسبة إلينا في المقام الأول ثلاثة أفلام تتنافس في ما بينها على احتلال الصدارة: «طوني إردمان» للألمانية الشابة مارين آدي، والأميركي «باترسون» لجيم جارموش، وبالطبع البرازيلي «آكواريوس» لكليبير مندونسا فيليو… ولئن كان لا بد أن تضم اللائحة فيلماً كان مصيره أن يُنسى عند نهاية العام، لسوء الحظ، فإن ثمة بالنسبة الينا فيلمين في هذه الخانة، لا فيلماً واحداً: «هايل قيصر» للأخوين كون، و «كافي سوسايتي» لوودي آلن. صحيح أنه يصعب علينا ضمان أن يوافقنا كثر في العالم على هذين الاختيارين. ولكن ماذا نقول والفيلمان سلّياننا بذكاء وقالا قدرة السينما، الشعبية بامتياز، على التصدي للتفاهة واستشراء عالم ثقافي وفني لم يعد يتّسم بقدر ما من الذكاء؟
لو أن هذه اللائحة وُضعت قبل شهور، لكان من العسير علينا أن نضم اليها فيلم بدرو المدوفار الأخير «جولييتا». فالحقيقة إننا حين خرجنا من عرضه الأول في مهرجان «كان» رأينا فيه شيئاً من التراجع عن مستويات كان المخرج الإسباني الكبير قد وصل إليها خلال السنوات السابقة. ولكن، بعد تفكير ومشاهدة ثانية، وبالمقارنة مع ما انجزته سينما الكبار الشعبية وعُرض خلال العام، أعدنا النظر ورأينا فيه بورتريه رائعاً لامرأة متعددة تحاول أن تقاوم مرارة العيش وسلطة الماضي، من خلال علاقة رائعة في التباسها مع ابنتها. جولييتا في الفيلم إمرأة مقاومة… مثلها في هذا مثل نساء مقاومات أخريات في أفلام أخرى من أفلام العام. ومنهن روزا في «ما روزا» الفيليبيني لبريانتي مندوزا حتى وإن صعب علينا أن نعتبره واحداً من أفلام العام العشرة… ولكن منهن أيضاً في شكل خاص تلك الشخصية الرائعة في «أكواريوس»، الستينية التي تقف وحدها متصدية لأخطبوط المضاربات العقارية مدافعة ليس أكثر عما هو حقها في حياة كريمة عند الحدود الدنيا…
لكن المرأة ليست وحدها من يقاوم، وتنقل الشاشة مقاومته: فالوالد في «طوني إردمان» مقاوم أيضاً، ولكن على طريقته الخاصة، من خلال علاقته بابنته الغائصة حتى النخاع في عولمة لا يرى هو خلاصاً إلا في دحرها أو السخرية منها… في هذا المجال يأتي هذا الفيلم المميز فريداً في مقاومته هذه، أو على الأقل متواكباً مع تلك المقاومة المدهشة التي تشكل عصب فيلم «أن تبقى واقفاً» للفرنسي آلان غيرودي الذي سنعتبره بالنسبة إلينا واحداً من آخر الأفلام العشرة التي نختارها كأبرز ما في العام… لكن هذا الفيلم لن يكون الفرنسي الوحيد في اللائحة بل سيعلو عليه فيها فرنسي آخر، لم يكن متوقّعاً من الناحية السينمائية، على الأقل، هو «مالوت» لبرونو دومون. فعلى عكس أفلام دومون المميزة السابقة، ينتمي «مالوت» الى السينما الهزلية (البورلسك) لكنه لا يتّسم ببراءتها، طالما أنه في الوقت نفسه «فيلم أسود» مملوء بالجرائم والقتل. لكن الأعجوبة الصغيرة تكمن في أن دومون عرف كيف يمزج النوعين، وربما على خطى تيم بورتون في «سويني تود» قبل سنوات. المهم في هذا أن دومون أعاد الى السينما الفرنسية فعل مقاومة إبداعية مدهشاً، تماماً كما فعل غيرودي…
مجتمعات وأسئلة حائرة
ربما يبدو من اللامنطقي هنا أن ندرج في هذه اللائحة فيلم «البائع» للإيراني أصغر فرهادي بالنظر الى أن لنا عودة في ملحق مقبل، الى السينما الإيرانية وأدائها خلال العام. ولكن ما العمل والفيلم فرض نفسه طوال العام كحدث عالمي للسينما الإيرانية، المقاومة بتكتم إذا أردتم؟ «البائع» فيلم سينمائي مميّز مشغول بذكاء وعناية الى درجة أن رقابة بلاده التي لم تستسغه أبداً، عجزت عن ايجاد مبررات لمنعه فمرّ واضعاً نفسه كالمرآة أمام مجتمع يكشف لنا هذا الفيلم كم أنه لم يعد واثقاً من نفسه أو من تلك المثل العليا الأخلاقية التي بنى عليها رجال دين متعصبون ثورتهم قبل عقود، فإذا بالسينما تقول لنا اليوم، من الداخل وليس من صفوف المعارضة، كم هشة هي تلك المثل العليا وكم أن أموراً كثيرة باتت في حاجة لأن تتبدل في تلك «الجمهورية» الهشة!
شيء مثل هذا، وبالأسلوب الاجتماعي ذاته المغلف بالبراءة الكاذبة أيضاً، الذي يأتي ليطبع الفيلم الأخير على لائحتنا، «باكالوريا» للروماني كريستيان مونجيو، الذي يتابع من ناحيته ذلك الحضور القوي للسينما الرومانية في العالم الخارجي سابراً في طريقه ثنايا مجتمع لا يكفّ اليوم عن التساؤل عما إذا كانت ثورته قد أوصلته الى الأمان في ظل استحالة إيصاله الى السعادة…
تلكم باختصار أفلام شوهدت خلال العام 2016، ومن اللافت أن معظمها مر على مهرجان «كان» خلال دورته الأخيرة ما يؤكد، مرة أخرى، قدرة هذا المهرجان على أن يعكس النبض الحقيقي لسينما تتحرك بقوة في عالم اليوم، وبالتحديد بعيداً من تلك المركزية الأميركية التي كانت المهيمن على سينما العالم خلال عقود وعقود.
(الحياة)




