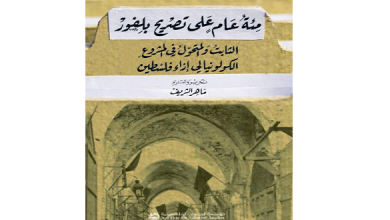نقد النقد في تنويعاته الثقافية المتعددة

يسري عبد الله
تبدو قراءة مجمل النتاج النقدي العربي في أية لحظة من لحظات تاريخنا الفكري – الثقافي شاقة وعسيرة. لذا لا بدّ أن يتوافر لها باحث متخصص، لاسيما إذا كانت منطلقات نقد النقد تعتمد على محاور نظرية، وعناصر إجرائية واضحة. وهذا ما صنعه تماماً الناقد المصري سامي سليمان في كتابه الضخم «التمثل الثقافي وتلقي الأنواع الأدبية الحديثة» (مكتبة الآداب، القاهرة).
يتوزع الكتاب (540 صفحة) على ثلاثة أبواب: «السياق الثقافي للتلقي»، «تجليات التمثل الثقافي في ماهيات الأنواع»، «تجليات التمثل الثقافي في أنساق المهام»، يسبقها مدخل، وتعقبها خاتمة؛ في استقرار من الباحث على اعتماد هذا النسق المنهجي الذي يتلاءم وحاجات الدراسة العلمية ومتطلباتها في الكتاب.
يبدو المؤلف مشغولاً بقضيته، يتعاطى معها بوصفها سؤالاً منفتحاً على أجوبة شتى. لغته منضبطة، وإجرائية في آن، تباعد بينها وبين الإنشاء. تغلب النزعة التحليلية على بنية الكتاب، ويرسي المؤلف مصطلحاته ويستقر عليها، ويحدد مفاهيمه ويضبطها، ويطرح أسئلة الدراسة في المدخل الذي يبدو تأسيسياً بامتياز. «التمثل الثقافي…»؛ كتاب يرصد تجربة النقد العربي في مئة عام، ساعياً صوب استقراء الدلالات الكامنة خلف خطابات النقد وتصورات النقاد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.
ولا يكتفي الناقد هنا بالتبويب والتصنيف، وهذا عمل مركزي للبحث، ولكنه يفكك خطابات النقاد، وينحت الاصطلاحات الدالة على الصنيع الثقافي والمعرفي المتواتر لديهم. وتبدو قراءته للنقد الإحيائي بروافده المركزية: التقليدي، والتجديدي، والتوفيقي، محمولةً على الدرس الثقافي الجديد، إذ إنه وصل القراءة العلمية بمحيطها السياسي والثقافي، ونزوعها التاريخي والجمالي، وبما يعني اتساع أفق الدراسات الثقافية وانسحابها إلى دراسة الخطاب النقدي وآليات تعاطيه مع النص الأدبي، واستيعابه النظرية النقدية الغربية.
هنا يصير التمثل الثقافي حاجة فكرية وجمالية، ووصلاً بين سياقات مختلفة، وجدلاً خلاّقاً بين الأنا/ التراث، والآخر/الغرب. بين النزعات الكلاسيكية الماضوية والأخرى التجديدية الحداثية، بين الإرث الشرقي والوافد الغربي. ولكن؛ ليس من منظورات الفصل القديم، أو الهجين المفارق المعنى، أو حتى الثنائيات الضدية الراسخة: الأصالة والمعاصرة، التقليد والحداثة، الشرق والغرب، وإنما من تعدد منظورات فهم العالم واستيعابه.
من هنا كانت الفروق الجوهرية بين ممثلي النقد الإحيائي، وفق طرح الباحث؛ في تعاطيهم مع الأنواع الأدبية المختلفة. فأصحاب الاتجاه التقليدي نزعوا إلى إرث الشعرية العربية القديمة، وبدوا مرتبكين إزاء الفنون الأخرى؛ غربية المنشأ في سياقها الجديد كالرواية والمسرحية، وزاوج أصحاب الاتجاه التوفيقي بين استحضار العناصر الإيجابية في الموروث العربي، والتماس مع المنجز الغربي الحديث، بينما بدا أصحاب الاتجاه التجديدي أكثر انحيازاً إلى المفاهيم والأنساق الثقافية الجديدة.
ظلت الهيمنة لدى نقاد القرن التاسع عشر لأصحاب الاتجاه التوفيقي على مستوى الذيوع، وحتى على مستوى التلقي الجاد مع ما خلَّفوا من إرث نقدي. وهذا لا يبدو مرتبطاً فقط بالسياق الذي أفرد له سامي سليمان مقاطع من كتابه تخص تأثيراته في تلقي الأنواع الأدبية بتنويعاتها المخلتفة، وإنما أيضاً بالذهنية العربية نفسها التي لم تجد صنع قطيعة معرفية وجمالية مع السابق، ولم تتواءم نخبتها الثقافية والفكرية ومن ثم النقدية مع تلك الهيمنة المفرطة للماضي، فرأينا هذا المزج المبدع لدى نماذج مجددة مثل لويس شيخو.
في ما يتعلق بتلقي الرواية؛ يستقرئ سامي سليمان خطاً متصلاً بين السرد في المرحلة الوسيطة التي عرفت بعضاً من الأشكال النثرية العربية والسرد الذي تمثَّله القريحة النقدية العربية إزاء تفاعلها مع الآخر الغربي، ومن دون صخب يدفع بناقده وأعني لويس شيخو الذي صار هنا موضوعاً للمراجعة النقدية، وعملاً للقراءة في استجلاء ضاف للجهد البارز الذي صنعه.
وظلّ المفهوم الكلاسيكي «الصدر/ العقدة/ الخاتمة»؛ مهيمناً على التعاطي مع الرواية لدى النقاد الإحيائيين التوفيقيين؛ مثل لويس شيخو، أو التجديديين مثل سليم البستاني. وتمركز أصحاب الاتجاه التجديدي في ما بعد في عدد من المهتمين بالمسرح؛ على غرار مارون النقاش وسليم النقاش.
وقد يكون هذا الأمر متصلاً بعناصر الفرجة المسرحية التي تنفتح على أكوان مختلفة في سياق العرض المسرحي، فضلاً عن غواية الفنون البصرية والأدائية التي يعد المسرح واحداً من طليعتها. وربما كان الاتجاه التجديدي مشغولاً باستلهام روح المسرح في العالم، وإن ظلَّ ملتحفاً برداء اجتماعي، يتمثل في تلك الوظيفة الاجتماعية للفن، تلك التي لازمت المسرح ولا تزال. هذا بالإضافة إلى أننا في المسرح نجد أنفسنا دائماً أمام فن جماعي بامتياز. وقد يكون من المستقبليات التي تنفتح عليها الدراسة أو التي يجب أن تنفتح عليها، النقد في القرن العشرين. وهذا جهد قد يمنح صاحبه نتائج أكثر إدهاشاً وجِدة. فالتحولات التي صاحبت النظرية النقدية في العالم، والانفتاح الذي شهدته الثقافة العربية على مثيلتها الأوروبية، يمكن أن تدفع بأفق تلقي النظرية النقدية إلى مناحٍ أخرى أكثر رحابة.
ربما شكلت الأنواع الأدبية المختلفة سياقاتها النقدية المستقرة، من اصطلاحاتها إلى مناهجها إلى أدواتها الإجرائية. فالمسرح؛ مثلاً؛ غادَر في القرن العشرين صيغاً قديمة تخص المسرح الاجتماعي، وأصبحنا أمام صيغ المسرح الملحمي، ومسرح الشارع، والمسرح الفقير. لقد صرنا أمام حال من التلقي المختلف، فرأينا بحثاً عن صيغ مسرحية عربية؛ حتى لو لم تخلق امتدادها الجمالي لدى كتاب أو أجيال مختلفة. فحضر «مسرح السامر»، و «مسرح المقهى»، وغيرهما.
وعلى مستوى أفق النظرية النقدية المسرحية، حاول النقد المسرحي أن يستعير بعضاً من اصطلاحات السرد، وفعَل السرد الأمر ذاته، وتجاوز النقد فكرة الصراع الدرامي، والحوار الذي يعد مركزاً للدراما، وظهرت لغة الجسد، ومثَّلت القراءات السيموطيقية مداخل شارحة في هذا السياق. وأمكن في مستويات للخطاب النقدي المسرحي الجديد أن نقرأ النص وفقاً لما يعرف بالفضاء الدرامي للنص، الداخلي والخارجي.
وفي نقد الرواية كنا أمام سيل من النظريات الحديثة، التي منحت هذا المفهوم المستقر معاني مختلفة، وأشكالاً متعددة. فمن تطوير خطابات الماركسية والاستفادة من الاتجاه الاجتماعي في نقد الرواية إلى البنيوية بتنويعاتها، والتفكيك بتجلياته، وصولاً إلى آليات التحليل السردي الجديد.
قد يكون يكون ذلك مشروعاً ممتداً لسامي سليمان، خصوصاً أنه وضع في سِفره هذا، الأساس الذي لن يكتمل البناء من دونه. وهو في قراءته التي استعارت بعضاً من إجراءات نقد النقد، مثل المراجعة النقدية المستمرة، ومقاربة الخطابات ووضعها في سياق تقابلي، والخروج منها إلى خلاصات جديدة، يبدو نافذاً صوب جوهر الروح النقدية السارية في خطابات النقاد، موضوع الكتاب وهاجسه المركزي.
(الحياة)