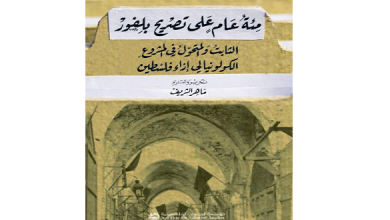عالم علي عطا يتهاوى على «حافة الكوثر»

مايا الحاج
بعد ثلاثة دواوين شعرية، يخوض علي عطا تجربته السردية الأولى في روايةٍ بعنوان «حافة الكوثر» (الدار المصرية اللبنانية). يرسم بطله على هيئته، يشبهه حتى يكاد يكونه. يقدّم له وصفاً دقيقياً – نفسياً واجتماعياً وفيزيولوجياً – فكأنّه أمام مرآةٍ تعكس صورته، غير أنّه يمنحه اسماً آخر هو حسين عبد الحميد، ليقول إنّ حكايته تظلّ عالقةً في مكانٍ غائم، ليس كلّ ما فيها حقيقة وليس كل ما فيها كذباً.
حسين عبد الحميد، شاعرٌ في الخمسين من عمره، متزوج وله ابنتان وولد، في رصيده ثلاث مجموعات شعرية، يعمل في الصفحة الثقافية في وكالة أنباء المحروسة. دخل في أواخر شباط (فبراير) 2012 إلى «مصحة الكوثر». ظلّ فيها فترة أسبوع، خضع خلالها لعلاج مضاد للاكتئاب، أكمله في البيت على مدار أشهر. ذاك العام لم يشهد دخوله المصح النفساني للمرة الأولى في حياته، وإنما عرف تحولات كبيرة أهمها زواج ابنتيه حنان وحنين، ثمّ زواجه الثاني من سلمى السكري، زميلته في المهنة.
وإذا قرأنا دلالات ذاك العام المحوري في حياة الراوي، لوجدنا أنّه عام التحولات في مصر ايضاً. ففي منتصفه تقريباً تسلّم محمد مرسي الحكم، أول رئيس مدني منتخب، لكنّ الشعب لم يحتج كثيراً من الوقت كي يكتشف خطورة هذا التحوّل الذي كاد أن يُضيّع البلد كلّه.
من هنا، يلتمس القارئ أنّ التاريخ الذاتي لبطل «حافة الكوثر» لا ينفصل بتاتاً عن التاريخ العام لوطنه، مصر. الحكايتان تتقابلان وتتقدّمان بطريقة متوازية لنكتشف أنّ أزمة حسين (الذي رأى في سلمى خلاصاً قبل أن يخيب أمله بها) ليست سوى نسخة مصغرة من أزمةٍ عاشتها مصر التي عرفت تجربة جديدة حرّكت الدم في عروقها المتجمدة قبل أن تصطدم أخيراً بواقعٍ مخيّب زاد من اضطرابها.
تكرّرت زيارة حسين الى «الكوثر» بعدما تراكمت ضغوط الحياة فوق رأسه، مرّة حينما أصرّت سلمى على إبلاغ زوجته الأولى بأمر علاقتهما، ومرّة أخرى إثر مشاكل ابنته مع زوجها واكتشاف ورم سرطاني في جسد حفيدته الصغيرة. كان همّه أن يجد حلاًّ يسمح له بالنوم من دون عقاقير وأدوية منوّمة. لكنّ المصحّ النفساني تحوّل الى ملهمٍ، مكان مدهش يتمنّاه كلّ كاتبٍ يبحث عن نماذج بشرية غريبة، فيها من الخيال بمقدار ما فيها من الواقع. لكنّ مصحة «الكوثر»، وهنا المفارقة في اسمٍ يحمل معاني كثيرة، لعلّ أبرزها نهر في الجنة، الوارد اسمه في القرآن الكريم، لا تحضر بالصورة التقليدية التي نقلتها لنا الروايات والأفلام السينمائية أو الأعمال الدرامية.
صورة خارجية
يصوّر علي عطا المصحة بعينٍ لا تصف أكثر مما ترى. لا يُضفي إلى نظرته تلك مسحة من التهكّم أو التراجيديا. لا يغوص في العوالم الداخلية للشخوص، ما يجعلنا أمام تجربة جديدة تستهدف الأمراض النفسانية من دون أن تُصنّف ضمن خانة الروايات النفسية. وهذا النهج يرسّخ حنكة الكاتب الذي اختار لنصّه راوياً غير عليم، يكتفي بالتقاط مشاهد خارجية تُعبّر عن ذاتها بذاتها.
العالم في الداخل (المصحة) لا يختلف كثيراً عن الخارج (مصر). فيه مثقفون ومديرو شركات ومدمنون ومتخلّفون عقلياً، يجمعهم المكان من دون أن يُحيلهم كياناً واحداً. أحدهم مهووس بالطهارة فلا ينفكّ عن السؤال: «هل التدخين ينقض الوضوء؟»، والثاني ممثّل فاشل يدّعي أنّ خاله هو الممثل حسين صدقي، الذي بنى مسجداً يحمل اسمه يطلّ عليه من نافذة «الكوثر». وليست مصادفة أن يُقحم عطا شخصية حسين صدقي في نصّه، هو الممثل الذي جمعته علاقة متينة بجماعة الإخوان المسلمين ومهّد إلى ما بات يُعرف لاحقاً بمفهوم «السينما النظيفة»، المعادل الفني لوجه مصر «المتدينة» سوسيولوجياً.
أهل الكوثر هم أناس أتعبتهم الحياة. ولكن من يُكابر خارجاً على جروحه ومتاعبه لا يعني أنّه صحيح من كلّ اعتلال نفسي. وهذا ما يقودنا إليه عطا حين ينقل بلسان راويه دراسات عن تفاقم نسبة الكآبة وأنّ «ربع سكّان الكرة الأرضية يُصابون بمرض نفسي في مرحلة ما من حياتهم».
المصحة، إذ تغدو عالماً عادياً، هي وطن بديل يقصده مُتعبون يعيشون على الحافة، مهددين بخطر الانتحار. الراوي واحد منهم. لكنّ زوال الحياة هنا ليست سوى جزء من أشياء كثيرة أخرى تزول في عالمه. زوال شغفه تجاه زوجته، زوال الحدائق والفيلل والأبنية التراثية، زوال الحكم، زوال الثورة، ومن ثم زوال الأمل.
وفي ظلّ عالمه المهدد بالانهيار، يكتب البطل نصاً بعنوان «شــجرة التوت»، يروي فيه مشاهداته داخل «الكوثر» وينشره ضمن ملف القصة القصيرة في جريدة يعمل فيها أيضاً «عرب اليوم». لم يكن هدفه مهنياً بمقدار ما كان علاجياً. أراد أن يُنهي معاناته الصامتة بالبوح. وحين كتب له صديقه من ألمانيا أن يواصل كتابة نصّه الجميل ليصير رواية بديعة، رضخ لطلبه هو الراغب في أن يكتب ذاته «التي سئمت طحنها في تحرير نصوص الآخرين».
رسائل افتراضية
«حافة الكوثر» رواية صغيرة (155 صفحة) لكنها تقول الكثير. الكتابة، الثورة، المرض النفسي، الملل، الحب، الغيرة الزوجية، العالم الافتراضي… موضوعات تناولها علي عطا في رواية كتبها بلغة سلسلة، كثيفة، شفافة، تقترب من المحاورات الشفهية.
نقرأ الرواية عبر رسائل بين حسين (الراوي) وطاهر (صديقه المهاجر). والغريب أنّ هذا الصديق كان خلال الفترة الأخيرة غائباً، بحيث انقطعت أخباره تماماً عن أصدقائه حتى ظنّ بعضهم أنّه مات. هكذا، تتكشّف لنا الرواية عبر مراسلات متبادلة، يكتب معظمها حسين الذي يخاطب صديقه باسمه «يا طاهر»، وكأنه حاضر أمامه بالجسد والروح.
هنا يتولّد السؤال: لماذا اختار الراوي صداقة افتراضية؟ أو بمعنى آخر، لماذا لم يلجأ إلى صديق واقعي؟
«الفضفضة» قد تكون جواباً منطقياً ومختصراً. ففي وقت وجد الراوي صعوبة في التواصل بأريحية مع محيطه، اتجه صوب الرسالة، التي تعني في علم النقد «محاورة» على وزن «مفاعلة»، ما يستوجب وجود شخصين أو أكثر. إنها إذاً خروج من الانعزال، وحوار مع الآخر. ومثلما كانت الرسائل أشبه بحوار مفتوح، نقرأ الرواية أيضاً كنصٍ مفتوح، يكتبه الراوي – ومن خلفه الروائي – وفق ترتيب يرسمه هو. لا يوافق الزمن الطبيعي للحوادث، على غرار الروايات التقليدية مثلاً، وإنما يعتمد «توقيته» الشخصي عبر إستراتيجية تسمح له بحذف ما يستغني عنه النصّ وإضافة ما يراه مهماً، قبل أن يعيد ربط الأجزاء اختتاماً. يحكي الراوي عن حياته الراهنة مرة، ثمّ يعود إلى طفولته مسترجعاً سيرة عائلته وجدته التركية «ست الدار»، ليغوص مجدداً في عوالم المصحة قبل أن ينتقل إلى رصد مسار الكتابة نفسها.
رسائل الإيميل تصير رواية جاهزة. رواية يُفرغ فيها الكاتب قلقه واضطرابه. وبها، يتخفّف من ثقل الماضي، وأرق الحاضر وفزع المستقبل. وفي الاختتام، ينتهي حسين من كتابة روايته، بينما يختفي الطاهر يعقوب مجدداً. «هاتفه دائماً غير متاح. لا يردّ على رسائلي على الإيميل والفايسبوك. لا أجد من يمكن أن يطمئنني عليه»… وهنا يحضر سؤال آخر، هل صديقه طاهر يعقوب موجود فعلاً أم أنّه اخترعه ليحقق هذه الرواية؟ لا شيء ينفي أو يؤكد.
يواصل الراوي حسين تناول الأدوية، حياته كما هي. سلمى تنتظر أن يسافر إليها حيث تعمل في الخليج. زوجته تشك فيه. عمله اليومي يستنزفه. مشــاكل أولاده تُرهقه. يُنهي روايته «المشتهاة»، فهل يعود إلى المصحة ثانيةً؟
(الحياة)