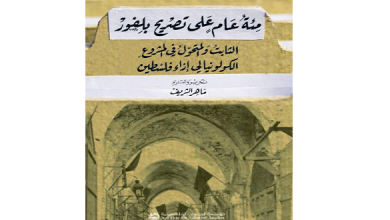«عين الشرق» للسوري ابراهيم الجبين: أكثر من عين ثقافية ترصد تاريخ دمشق
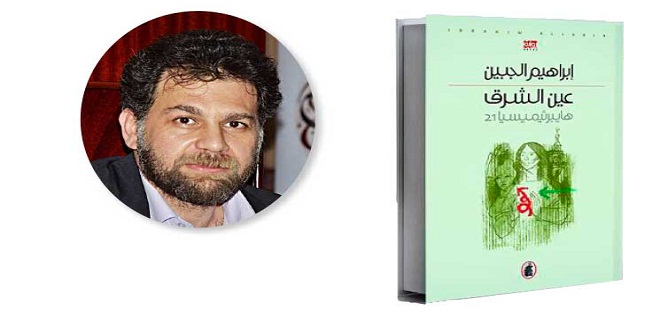
محمد المطرود
تحاول رواية «عين الشرق» للروائي إبراهيم الجبين، هتك ستار العفة الذي بنته السلطة حول نفسها، والعبور وولوج التابو المشكّل طائفياً من قبل فئة معينة ومحدودة ومتواطئة غصباً مع أكثرية ليست غالبة، إنّما مغلوبة على أمرها، مصمتةٌ من حيث تماهي فعلها وسلوكها مع» الأقلية الطائفية» الحاكمة أو السياسية خارجَ مركزيتها الدينية، ذلكَ أنَّ هذا الديني لا يعدو كونه واجهة، وإن كانَ يحتكم إلى مرجعية.
يتبيّنْ هذا الخط مدغماً في التشكيل الثقافي للمجموعةِ المرصودة طيلة فترة السرد، التي هي فترة حياة، تخصُّ حيوات أناس فاعلين ومؤثرين وآخرين هامشيين، يسندون حياة الروي هنا أكثر من حقيقة الحياة. وهذا سيخصُّ بالتأكيد أقلية متمايزة فعلاً ضمنَ سوادٍ عميم، سواد يذهب إلى ما وراء الحدث متفرجاً، إمّا لجهل بأهمية ما يحدث، وإما مواربة وتورية خوفاً من يدٍ يقدّرُ جيداً ثقلها، وبهذا تظهر ثيمةُ الرواية الرئيسة، بوصفها تعرية للخطاب الطائفي من جوانيتهِ ومن عينٍ مفتوحة على قطاعات من دمشق المدينة والنفوس والتاريخِ والقداسة والمدنّس، وهي عينٌ ترىَ التعدي الحاصل على بنيةِ القديم/ توأم العريق هنا، حينَ يعرف الرائي أنَّ «عين الشرق» بالضرورة عينٌ لأقدمِ مدينة مأهولة، وبما تنطوي عليه كلمة «مدينة» المرادف للمدنية، وما التخريب الذي طالَ بنيتها عمرانياً ونفسياً وتكويناً سكانياً إلّا إحقاق لشرطِ قتل سوريا كاملة، وتحويلها إلى مزرعةٍ تقوم ثنائيتها على أسياد وعبيد.
تأتي الروايةُ على هذا المفصلِ المهم لتأكيد سلوكِ السلطةِ الحاكمةِ التي همّشتْ العدالةِ الاجتماعية وألغَت المظاهر المدنية للحياة، لتتجاوز التوصيف الدلالي الاصطلاحي «الديكتاتورية» إلى مصطلح أكثر مواءمة لحالها: «التوتاليتارية»، المقنّعة والمقنعةِ بحكمِ المؤسسات وديمقراطية المجالس الممثلة (للشعب) بحسبها.
شخصيات الجبين/ بواباتُه، اعتبارية وأخرى أقلُّ أهمية ومركزية، تتقدمها (ابن تيمية) صورة إشكاليةٌ، يتم الدفاع عنها بوصفها مسروقة من السلفيين، باعتبارها مرجعا لهم، ومن الطائفيين ليشحذوا عليها سكاكين طائفيتهم، والعلمانيين بسهامهمِ المصوّبة لها بجهلهم بها وعدم دراستها، وهذه الدفوعات التي يقدمها الروي في سياقات عدة، لا تدفع إلى اتهام للراوي في ما إذا كان مؤمناً بهذهِ الشخصية أو سواها، وإنما تدلل علىَ أنّ الرواية بجانبها الاستقصائي تحاول أنْ تدرس أسّ الإشكال ثقافياً وفق الحجة والمماحكة التي توفرها حالةُ التقصي وتتبعِ المعلومةِ في حياتها وتفاعلاتها، وليس في مواتها بعد أن تصبح رهنَ العادي.
شخصيات عديدة: منها شخصية الرسام ناجي، شخصية حقيقية، العضو السابق في الشعبة الثانية للمخابرات، الذي سيزود الراوي بالكثير الحادث في حقبة مفصلية من تاريخ سوريا ودمشق المدينة، وسيأتي ذكر أدونيس من قناة الرسام العجوز، زميلهُ في ذلك الجهاز الرهيب، بصورة لعلي أحمد سعيد وشخصيته المؤسَّسة على اقتناص الفرص، وسيتم ربط الانتهازية كتكوين نفسي وأخلاقي بما يحدث في البلد منذ عام 2011، حيث ينتصر المثقف الذي انتصر لقضايا الشعوب للطرف الآخر الدموي والمستلب والقائم أساساً على نظام بوليسي. إظهار التاريخ/ المفارقة هنا من خلال دورين يتوازعه الراوي والرسام، يذهب بالدلالات إلى أقصاها، حين يرتبط الأمر بالبنيةِ الطائفية للمثقف الذي قدمَ نفسه على الدوام علمانياً ومحدّثاً، بل وما بعدَ حداثي.
يظهر المحامي هائل اليوسفي في برنامجه «حكم العدالة» ومن خلاله يمسك السارد بخيوط الجاسوس الإسرائيلي كوهين وقدرة الأخير على تنفيذ برنامجه في اختراق الدولة وعرابيها، بفضل ما تأمنَّ من بطانة وأرض خصبة وفرَّها الفساد، المتمثل بالعسكر الذين احتكروا السياسة، وقد يكون نموذج حافظ الأسد وزير الدفاع الذي رآهُ أنصاره الشخصية الأكثر نفوذا وتأثيراً في التاريخ العلوي بعد الإمام على بن أبي طالب، الشخصية الأكثر نصاعة التي ساهمت في رفع الغطاء عن الرغبات والأفعال لتغيير وجه المدينة المسماة من قبل قائد روماني بـ»عين الشرق» حيث اعتمد الوزير المهندس إيكو شار الكاره لدمشق بتنفيذ مخطط جديد، تمثّلَّ في هدم مبنى البلدية القديم التاريخي، إذ تعارف أن إعلان استقلال سوريا لطالما كان من هناك، ومبنى البريد والبرق وفندق فيكتوريا وجامع يلبغا ثاني أكبر أثر إسلامي بعد الجامع الأموي، وأوصى بهدم محطة الحجاز والمدرسة الشامية والسوق العتيق، ساندَ هذا الطرح التخريبي في ما بعد سنان وهو المقرّب من (الرئيس) حافظ الأسد، وليس الوزير حافظ الأسد.
لا تأتي الشخصيات اعتباطية بحكم قيمتها التاريخية والسياسية، فشخصية كالأمير عبد القادر الجزائري، شخصية ثائرة، مسلمة ومتجاوزة للحدود، سواء على صعيد الجغرافيا والأديان، إذ نجده حامياً للمسيحيين ونصيراً لهم، في الوقت الذي لم يستطع الولاة العثمانيون إلّا التأليب، وتأتي شخصية عصام العطار في السياق ذاته كمسلم ذي حجة ومتخلصٍ من لوثة ليّ عنق النصوص، ورجلٍ قادر على تقديم خطابٍ حضاري، يتساوق مع روح الإسلام، بعيداً عن الراديكالية التي يريد بعض الغلاة وسمهُ بها، ونجد النازي صائد اليهود (برونر)، واليهودي إلياهو ساسون، الذي يتلمس فشلَ مشروع القومية العربية ويتحول ليكون متماهياً مع مشروع إسرائيلي.
نجدُ لغة الرواية عند الجبين، تستند إلى الثقافي بالدرجة الأولى تحفيزاً للذاكرة وتوثيقاً للمشهد، وهو محاط بالكثير من الشخصيات، التي مازالت سيرورتها مستمرة، كالناقد والمثقف اليساري صبحي حديدي كرائد فكر في منطقة ملتبسة الهوية، وكذلك لعلاقة بيولوجية بالراوي بحكم الخؤولة التي تربط بينهما. أيضاً نتعرّف مجموعة (حراس الأرض) وجمال ورشيد ومعسرتي وآخرين، هؤلاء وإن جانبتهم التسميات الحقيقية، إلّا أنْ الداخل في الحياة الثقافية السورية، سيجد من السهولة تعرفّهم، وبالتالي الوصول إلى التاريخ الشفاهي لهم ولوصوليتهم، وتشكل ذواتهم الجديدة في المدينة الكبيرة والإشكالية، إذا عرفنا أن أغلبهم أبناء ريف ودخلوا من بوابة الثقافة، أو لنقل ادعاء الثقافة، حين نلمح ذلك الغمز من قبل الراوي إلى هذه الحيثية.
تأخذ الرواية القرين إخاد، مساكن الراوي والروي في قبو ما، قرين راصد، متعلم، يساهم كثيراً في إضفاء بعض الميتافيزيق على الحالةِ ويساعد في إعطاء الشرعية للتقصي، الذي لن يُعيّ الراوي بردِ مصادره إليه كقرين، يتّسم بالمصداقية، يقول الجبين» حالة هيبرالية» و» عدم تمييز الواقع عن محاكاة الواقع» وقد يكون صاحب الشرق هنا، تقصّد هذه التقنيةَ فهوَ بالحالة الهلامية لكثير من شخصياته، والحالة الغائمة للأحداث يريد أنْ يحاكي الواقع بالواقع الذي يصل حدَّ الخيال، ويحاكي الخيال بالواقع أيضاً، وربّما القصدية ذاتها، جعلتهُ يترك شخصياتهِ المعروفة والتي مازالت قادرة على الفعل بالذهاب إلى شأنها، بحيث لا يجد المتلقي تنامياً لها، بل يُكتفى بمراقبتها واستدلال أماكنِ تواجدها، في حين أعطى نهايات لشخصيات رافقته وإن بشكل ثانوي، وبدت هامشية مقارنة مع أسماء لها ثقلها الوجودي والكياني، بعضها انتهى بالموت وبعضها انتهى إلى غير ما يريد، وهذه دلالة على فشل المشاريع والإحباط الذي رافق فترة تاريخية عميقة، سواء على المستوى الشخصي للشخصيات أو على المستوىَ العام لبلد مضطربٍ، بدأت رحلتهُ الجديدة مع أطفال خطوا على الجدران «الشعب يريد إسقاط النظام».
لا يركن ابراهيم الجبين في روايته إلى المنجز الروائي، فهو لم يعقّد الحدث، ولم يخلق البؤرة المحرقية، وعلى العكس تماماً راح إلى ما يشبه المونتاج السينمائي في تقطيعاته وتنقلاته، وقد يكون هذا مربكاً بادئ الأمر، غير أنَّ الصورة تتضح، ما أنْ يمسك المتتبع المفاصلَ الرئيسة والمرامي النهائية للقول، والفكرة التي تأسست عليها الرواية، هو يتحدث عن سلمى بشكل مقتضب يتساوق مع لغة الرواية ولا ينفلت عنها، بعيداً عن الإيروتيك، وكذلك الحال مع ذكر الشركسية (ستناي)، وإنْ دلَّ هذا على أمر، سيدلُّ إمّا إلى ضعف في الإمساك بجميع خيوط اللعبة الروائية وإمّا إلى ضياع الحدث الرئيس في زحمة الأحداث الكثيرة، وإمّا إلى طموح باجتراح بديل روائي جديد، وهو برأيي سيبقى طموحاً مرهوناً بالزمن، إذ أن علامات نجاحه غير واضحة، لكنهُ الأقرب دراسة.
رواية «عين الشرق» وثيقة إدانة لقتل المدينة، وقتل شخوص فاعلة، تقتربُ من الشفاهي أكثر من المكتوب، لكثرة القائلين والشخصيات وعدم محوريتهم ، وعلى مدى أكثر من 350 صفحة، سيجدُ أكثرنا نفسهُ في مكان ما منها، إمّا قائلاً وإمّا مقولاً، اللغة المعتمدة هنا لا تذهب إلى الصرامة.
شغل إبراهيم الجبين وطموحه، تحملهُ روايته في التعالي الذي يبديه، حين لا يجدُ نصّا عربياً شعرياً يمنع عنهُ ازدراءه للمنجز إلّا قصيدة الكردي سليم بركات، وهو بالضرورة يبدي تعالياً أخلاقياً ونفسياً بنقدهِ المستمر لكثرٍ قاسموه الحياة كما بدا في «عينِ الشرق»، ومهما يكن من أمر هذا التعالي، فإنّهُ سيكونُ خاضعاً لما هو قيّمي وإبداعي وسيرتبط في حال من الأحوال بما ستتركُ الرواية من أثرٍ علىَ سيرةِ إبراهيم الشخصية، ودفاعه عن الشكل الذي كتب فيه.
صدرت «عين الشر» أواخر عام 2016 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
(القدس العربي)