فلسطين الحديثة تستعين بماضيها
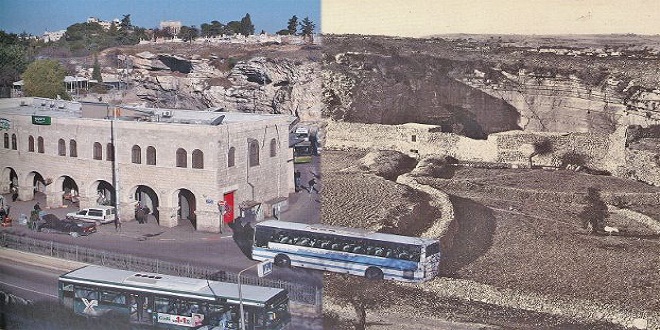
فيصل دراج
حاول الفلسطينيون، في عقود سبقت، توسيع زمنهم الوطني بتجربة «الكفاح المسلح»، التي جعلت من «الشهيد» كلمة رائجة إلى أن أرهقها الحصار ووقعت على مفردة جديدة: الانتفاضة، التي استهلكها زمنها، ووصلت إلى حرب السكاكين والأجساد العارية. وبعد البندقية وانتفاضة الحجارة والأجساد العارية، التي عالجها الإسرائيليون بوابل من الرصاص، جاء، فجأة، شعار أقرب إلى الوعد منه إلى الحقيقة: دور الثقافة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
في الأسبوع ما قبل الأخير من كانون الثاني (يناير) المنقضي، وفي التاسع عشر والعشرين منه عقد الفلسطينيون في العاصمة الأردنية، وبمبادرة من وزارة الثقافة الفلسطينية، «لقاء جامعاً» شعاره: رواد الثقافة الفلسطينية، من عام 1917 إلى اليوم ، مع إشارة إلى كلمة «التنوير» التي تقضي بها المرحلة الراهنة، وينظر إليها كثير من الفلسطينيين، كما غيرهم من العرب، بارتباك أو بسوء نية مضطرب المنظور.
الرد على «وعد بلفور»
اتخذ اللقاء من 1917 مناسبة للرد على «وعد بلفور»، الذي أسس لنكبة الفلسطينيين، حدّد الحاضرون فيه أسماء مثقفين، جديرين بالتكريم، ولدوا في ذاك العام وفي السنوات اللاحقة. وإذا كان في الرد على «الوعد المشؤوم» ما يحيل إلى «إرادة البقاء»، مهما تكن وفرة أحزانها، فإن في تقصي الأسماء الثقافية التي أنجبتها فلسطين، ما يشهد على ثقافة حيّة. ففي عام 1920، وما تلاه، ولد مثقفون يحسنون التعامل مع القراءة والكتابة، حال جبرا إبراهيم جبرا المثقف الرومانسي المتعدد الأصوات، وإحسان عباس الناقد والمؤرخ الأدبي ومترجم «موبي ديك»، وإميل حبيبي الذي سخر من ذاته ومن وجوده وأنتج عملاً أدبياً ساخراً متميزاً، في انتظار غـــسان كنفاني ومحمود درويش وتوفيق زياد وسميرة عزام، التي ولدت في عكّا وتعاملت، مبكراً، مع القصة القصيرة إلى حدود الريادة… اقترح اللقاء أن يُحتفى كل عام، بدءاً من 1917، بمثقف فلسطيني ولد فيه، أكان رساماً كاريكاتورياً، مثل ناجي العلي، الذي قتله إيمانه بصدق الكلمة، أو مؤرخاً حال أنيس صايغ، الذي أشرف، ذات مرة، على: مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت.
أعلن المجتمعون عن تميّز «اللقاء» بديمقراطيته، إذ حاول أن يتجنّب النسيان و «التحزّب البسيط»، وبجديده، فالاحتفاء المنهجي بالثقافة ليس شأناً شائعاً لدى مسؤولين فلسطينيين، وبهوية ثقافة حديثة، حين اختاروا فدوى طوقان، المولودة عام 1917، أن تكون أول «المكرّمين». فهي أديبة أنثى جديرة بالتكريم، على رغم زمن مريض يتطيّر من مساواة المرأة بالرجل، وشاعرة تنتمي إلى ذاتيتها المستقلة، لا إلى أخيها إبراهيم طوقان، الذي كان يعتبره محمود درويش حالة شعرية عالية، أسكتها موت مبكر. وفدوى طوقان، وفقاً لكتابها «رحلة صعبة»، صوت نسائي متمرد، ندّدت «بالتربية الذكورية» وأوغلت في الدفاع عن «كيانية المرأة»، من حيث هي وجود لا يختصر في إرادة العائلة.
ما الذي يجعل الفلسطينيون اليوم، أي هؤلاء الذين يعيشون في «منطقة السلطة»، كما يقال ـ يتحدثون عن كتابة بالحبر والورق، بديلاً عن «الكتابة بالدم»، الذي كان شعار «اتحاد كتّاب» في حقبة ماضية؟ ولماذا استحضار أسماء ثقافية غفت واستقر فوقها الجهل والنسيان؟ ولماذا يبدو وزير الثقافة الفلسطيني، هذه المرة، مثقفاً واسع الاطلاع، بعيداً عن ممارسات إدارية، شكلانية تتعامل مع الثقافة بمعايير غير ثقافية؟
لا وجود لإجابة ناجزة. بيد إن الناظر، إنْ قرّب الأمور تقريباً، لمح مقدمات الجواب: هناك دور بعض المثقفين الممتازين المؤمنين بفاعلية الثقافة، فقبل فترة قصيرة كان هناك مؤتمر في جامعة بيرزيت عنوانه: «ثقافة البقاء»، وذلك بعد أن وصلت «عملية السلام»، باللغة المتخشبة، إلى أفق مسدود، بسبب منظور إسرائيلي متوالد، يرى أرض فلسطين ولا يرى الفلسطينيين، كما لو كان في يقظة الثقافة الفلسطينية احتجاج على سياسة لا تفضي إلى شيء. لا يستطيع المثقف الفلسطيني، بداهة، أن يتدارك مالا يستطيع رجل السياسة القيام به، وإن كان عليه أن يجتهد في سياسة ثقافية لا يحسنها رجل السياسة إلا في فترات سعيدة؛ سياسة توقظ الذاكرة الوطنية وتؤكد الهوية الكفاحية، وتخبر أن التاريخ الثقافي والسياسي الفلسطيني لم يبدأ اليوم، فله مداه البعيد، الذي فرض عليه الظلم المتواتر أن يرى في 1917 عاماً يختلف عن غيره له. بيد أن المثقف الفلسطيني الذي «يرغب» في إيقاظ إمكانيات الثقافة الفلسطينية، لم يرغب بما رغب فيه، لولا سياسة إسرائيلية «تهوّد» فلسطين بلا هوادة، ولولا واقع فلسطيني مرهق «يتناسى» وقائع ثقافية، عرفها الفلسطينيون «قبل النكبة» وبعدها، مثل المسرح والسينما والحوار وحرية الفكر، وظواهر أخرى لم تكن «حراماً» إلا في زمن تراجع «النظر الوطني» الذي معناه تحرير الوطن، من حيث هو تحرير للإنسان وعقله وقدراته، قبل استظهار شعارات يختلط قديمها بجديدها ولا يقترحان ما هو مفيد.
قد يكون في عمل المثقف الفلسطيني النقدي اليوم ما يمكن أن يدعى «ترهين الماضي»، حين كان الفلسطينيون موحدين، ولو بقدر، ينتسبون إلى أحزاب لا تختصر في «جماعات» ويساهمون في «نقابات» لا تختزل في ثقافة الأدعية. وينشرون ترجمات ومجلات ثقافية، …. أنشأ إميل حبيبي مع غيره مجلة الطليعة عام 1938، وهجس بدر لاما بصناعة السينما في أواخر عشرينات القرن الماضي، وبدأت سميرة عزام بكتابة القصة القصيرة وهي في عكا قبل عام الرحيل، واقترح ابن القدس خليل السكاكيني، منذ عشرينات القرن الماضي، أن تكون «المكتبات العامة» مساوية لدور العبادة. كان ذلك في زمن آخر، واكب زمناً عربياً مختلفاً.
قد يرى البعض أن تأكيد دور الثقافة يسحب الفلسطينيين من «اختصاصهم» الأساسي، أي «الكفاح الوطني» ويلقي بهم في اهتمامات لا تليق بشعب مقاتل. مع ذك فإن الفلسطنيين، لا يستطيعون الانسحاب من «اختصاصهم»، إلا إذا ائتلفوا مع ثقافة الجهل المهزومة، وهو افتراض يحفظ فلسطين ككلمة ويستبعدها كقضية تحرر.
لقاء عمّان، الذي أراد أن يكون مشروعاً ثقافياً إستراتيجياً، كما قال المتحاورون، يصطدم بعقبات، يرتبط بعضها بإرادة الفلسطينيين، وبعض آخر بالأسى الواقع عليهم. فمثقفو غزة، الذين دعوا إلى اللقاء، لم يتمكنوا من الحضور، ولم يكن بإمكان مثقفي «الشتات» أن يحضروا لأسباب حالها من حال الفلسطينيين. السؤال الضروري: كيف يمكن إنتاج ثقافة وطنية جامعة لشعب وزعته أقداره على أقاليم قريبة وبعيدة؟ يريد اللقاء أن تكون له وظيفة «دولة» في شرط ظالم يمنع عن الفلسطينيين ما هو أقل من الدولة بكثير!
طموح صعب
وهناك، في الحالات كلها، صعوبات الطموح الفلسطيني المتعددة: تفترض الثقافة الوطنية سياسة ثقافية موحدة، تتقاطع فيها سياسات متعددة، تتضمن التربية والإعلام والاقتصاد ووحدة النظر، فهل لدى الفلسطينيين خيارات حرة تمكنهم من القيام بما يجب القيام به؟ وإذا كان في مصطلح «الثقافة الوطنية» ما يؤكد «الوطن» مرجعاً فكرياً ـ سياسياً، فما هي حظوط تحقيق مشروع ثقافي موّحد إذا كان «الانقسام» يخترق الشعب الفلسطيني في أكثر من اتجاه؟. ما هي الشروط التي تحوّل الثقافة إلى قوة شعبية فاعلة، ترى في «الوطن» مرجعاً يتجاوز «الحمائل» والعقائد؟ كان خليل السكاكيني يشكو عشية سقوط فلسطين، من انقسامات طائفية، قبل أن ينتج الضياع الفلسطيني أفراداً يسألون عن «نيات غسان كنفاني وعقيدة محمود درويش».!
في المشروع الذي اقترحته وزارة الثقافة الفلسطينية، مؤخراً، ما يراهن على «قوة الثقافة»، انطلاقاً من «فكرة فلسطين»، التي التزم بها، في التاريخ الفلسطيني، شعراء وروائيون ومؤرخون وفنانون، بقدر ما أن فيه طموحاً مضمراً، يكاد يقول: ما لا تقوى السياسة على القيام به، قد تنجزه الثقافة، التي ساهمت في بنائها، القديم والحديث معاً، متواليات من المثقفين، لا تبدأ باللامع «روحي الخالدي»، أحد مؤسسي الأدب المقارن عام 1905، ولا تنتهي بحسين البرغوثي، صاحب «سأكون بين اللوز» و «الضوء الأزرق»، اللذين أعطى فيهما نثراً عربياً يكاد أن يكون فريداً.
من هو الطرف الذي ينقل «المشروع الثقافي الفلسطيني»، في مفرداته المتعددة، إلى شعب محاصر ومطارد ومقاتل معاً؟. إذا كان كل تلميذ، حتى لو كان نجيباً، في حاجة إلى معلم، فما هي الوسائل التي تنتج معلماً وتلميذاً مشغولين بالحفاظ على الثقافة الفسطينية؟ وإذا كان لا وجود لسياسة ثقافية صحيحة إلا بسياسة عامة صحيحة، فما هو الطرف الذي ينتج السياستين؟
كان خليل السكاكيني، وهو يتحدث عن «المدرسة الدستورية» قبل مئة عام تقريباً، يقول: «مدرستنا تقبل الطلاب جميعاً، ولا تعرف الفصل ولا التفرقة «. لست أدري إن كان الفلسطينييون اليوم يستذكرون مدرسة السكاكيني، التي جمعت بين الوطنية والحداثة معاً.
(الحياة)




