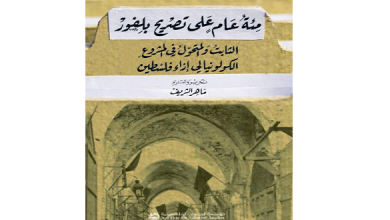لعنة المكان في «بيت السناري»

شاكر عبد الحميد
يكاد المكان أن ينطق ويملأ الفراغ في رواية الكاتب المصري عمار علي حسن «بيت السناري» (الدار المصرية اللبنانية)، بحيث نجد تصويراً دقيقاً لهذا البيت الأثري، يتعدى معماره إلى حنين ساكنيه ومعاناتهم، بل السياق الاجتماعي التاريخي الذي يحيط بهم. وهذا كلّه يكتسي بصبغة أسطورية، تحيط بالبيت بتاريخه وجغرافيته، وبالبشر الذين عاشوا فيه أو نظروا إليه، منذ اللحظة الأولى من عملية بنائه حيث «ملأ القاهرة خبر القصر الذي يبنيه العبدُ الذي صار سيداً». وقال فيه الناس: «يطاول قصور المماليك ويفوقها في موقعه قرب الناصرية» حيث الونس في الليل والنهار. وقد انشغل الجميع بتكاليف البيت والهيئة التي صار عليها بنيانه، وكيف تم تجهيزه بالطنافس والبسط والثريات والرياش والآثاث الفاخر، وكيف بناه أبرع البنائين والنجارين والنشارين والحدادين واللحّامين.
في الرواية تصوير جلي للبيت بجدرانه ونوافذه ومشربياته البديعة، وشخاشيخه النفيسة، وأبوابه العالية، وغرفه وأجنحته ومقاعده، التي تطلّ على باب الحرملك حيث تعيش أربع زوجات ومحظية هي المقربة والمحببة. ويبدو صاحب البيت؛ إبراهيم السناري، وهو شخصية تاريخية حقيقية لرجل جاء من السودان وبيع بلا عناية في سوق العبيد ليصير بعدما ذاع صيته كعرَّاف؛ نائباً لحاكم القاهرة.
روح هائمة
نجد في هذا النص ما يشبه روحاً شاردة هائمة بين صعيد مصر والقاهرة والإسكندرية بعدما طردت خارج مكانها، وهو البيت، أو ربما شبح يحوم حوله، يريد أن يقيم صلة من خلاله بين زمان الفرنسيين الذين احتلوا مصر وزمن المماليك الذي مضى. يبدو البيت في الرواية ساحة للحب والصراع والاضطراب والغربة، ثم صار موقعاً للعيش والعلم والفن، بعدما اتخذه علماء الحملة الفرنسية مقراً لهم، كما صار مكاناً لحفظ الكنوز والأسرار، وطاقة خاصة مشعة تجتذب الحنين المتعلق به، والقلوب الملتفة حوله، وصار موضعاً للألفة والوحشة، وللعدل والظلم، للجلي الواضح من الأمور والخفي، وللسكينة والرعب، وللقديم والجديد، أو الماضي والحاضر، والإدراك والتذكر، والعز والذل.
ويبقى البيت بكل هذا، أيقونة ذات روح خاصة تزخر بالبشر والذكريات والآثار التي محيت، والكنوز التي لم تُكتشف بعد، بخاصة الخبيئة التي تحتوي على سبائك من الذهب والفضة والجواهر والعملات؛ وكذلك وثيقة أو وصية بوقف البيت وتوزيع ثروات صاحبه وممتلكاته على أهل بيته، وعلى الفقراء والمحتاجين وأبناء السبيل، وعلى مسجد السيدة زينب القريب، على أن يكون الكنز، من نصيب محبوبته، زينة.
يصف عمار علي حسن البيت بتفاصيله من الداخل والخارج، لكنه لا يكتفي بهذا، بل يصور أيضاً تفاصيل الحياة التي كانت تدور حول ذلك البيت، فيرصد المقاهي والعملات المتداولة والمشروبات والسلع والمهن والحلي والطيور والحيوانات ووسائل النقل والبيوت والشوارع وأنواع الذخيرة وملابس النساء وصراع المماليك والأتراك والفرنسيين والإنكليز والغياب الواضح للمصريين عن المشهد، إلا في ما ندر. ثم جاء وصف المعارك، ومد الخط لإظهار التباين والصراع الحضاري بين المدفع والسيف والنبوت والسكاكين، وبين المطبعة والبيرق، وبين المشايخ الذين جلسوا حين اشتد وطيس المعركة ليقرأوا البخاري حتى يوفق الله جند المماليك وأهل المحروسة/ مصر في صد الغزاة، وبين القادمين ومعهم لجنة علمية لدراسة كل شيء على أرض هذا البلد.
في الرواية، وكما جرى في الواقع، تم إخلاء بيت السناري من ساكنيه فيخصصه الفرنسيون لإقامة مصوري الحملة وعلمائها. لكنّ هذا الواقع الحاضر يختفي خلف شخصية متخيلة هي زينة، بنت البلد التي أُجبرت على أن تكون محظية لأحد الأتراك ثم أحبت السناري وصارت فتاته. تتقدم الأحداث لتصير زينة البطلة الحقيقية للرواية، وتبذل كل جهدها في سبيل الحفاظ على البيت الذي تركه صاحبه، المشارك في مؤامرات ذلك الزمان.
أسرار وغموض
هرب السناري إلى الصعيد حين دخل الفرنسيون القاهرة، فيما تشارك مع زينة في جهدها هذا، ابن البلد حسن جعيدي الذي أحبَّها بصدق منذ ميعة الصبا، واكتفى منها بأن يراها وينصت إلى أوامرها وينفذها بلا تردد. لم يكن بيت السناري، كما ظهر في هذه الرواية بيتاً كغيره من البيوت، ولا قصراً كغيره من القصور، بل كانت له هذه الطبيعة الشبحية كما قلنا، وكان له حضوره الخاص في قلب من سكنه، أو دخله أو مرَّ حتى بجواره. وقد كان السناري نفسه يحس بمشاعر متناقضة تجاه البيت الذي بناه على نحو باذخ. لقد كان يكن له الحب، والخوف في الوقت ذاته. وهو قال عنه ذات مرة خلال أحاديثه مع زينة: «أشعر أن هذا البيت صار لعنة»، وعندما تسأله عن سبب شعوره هذا؛ يقول: «منذ أن استوى في عيون الناس، والحسد يطاردني». ويقول عنه كذلك: «بنيته لغيري»؛ وأيضاً: «انقبض قلبي حين دخلتُه للمرة الأولى بعد اكتمال بنائه». وكان خلال حواراته مع زينة يتوه منها؛ «ويرى الأحجار ترقص، وبعضها يطير في الهواء، ثم يتفتت إلى حصوات صغيرة، ويعود ليتجمع من جديد حجراً حجراً، فيصير مدماكاً في حائط، وتتقابل الحوائط لتصبح غرفة، هي تلك التي يجلس بين جدرانها». لم يهنأ السناري ببيته؛ إذ سرعان ما أعدمه الأتراك مع كثير من أمراء المماليك في مياه الإسكندرية عام 1801 بعدما خدعوهم.
وفي رسالة أخيرة تركها لزينة، التي طمع فيها ضابط فرنسي وآخر إنكليزي وقائد تركي، كتب السناري عن شعوره بالضعف والغربة، وعن الناس الذين بالغوا في تقديره والخوف منه، لأنهم رأوه ساحراً بارعاً، وكيف جاراهم في ذلك، وكيف استغل تصديقهم للسحر والشعوذة وقراءة الطالع والنجوم- وهي لم تكن كلها سوى لعبة استمرأها ونفخ فيها فصارت أمراً كبيراً هائلاً- لأنهم كانوا يبحثون عن أي وهم يمنحهم الأمل، ويجلي لهم غموض ما يحيط بهم، ويريهم ما يغيب عنهم، وسيأتيهم حتماً. غاب السناري بالموت أو القتل، وغابت الشخصيات كلها التي عاشت في ذلك الزمن، سواء كانوا من الغزاة أو أصحاب الأرض، وبقي «بيت السناري» شاهداً على ما جرى، وبقيت داخله «الخبيئة». بقي الكنز، أو بقي البشر، وبقي المعنى أكثر خلوداً من المبنى، وبقيت الروح التي تبحث عن نفسها، وعن كنزها، الذي هو رمز المعرفة الغامضة والأسرار المخبوءة هناك في البيت الأكبر، في مصر.
«بيت السناري»؛ رواية تحفر في الشخصية المصرية وفي المكان والتاريخ في وقت واحد، وتصف حياة الناس الذين يعيشون في هذا البيت وحوله، وتعطيه صبغة أسطورية، كما تصف أحوال وطرائق عيش المصريين أيام الحملة الفرنسية وقبلها، بما يظهر البيت على أنه تعبير عن حالة مصر وقتها، وبما يجعل الرواية حافلة بالتصورات الأنثروبولوحية والتاريخية معاً، ويجعلها أشبه بمطالبة بالبحث عن الروح الحقيقية للناس والمكان. ربما كان الكنز موجوداً هناك في بيت السناري أو في غيره من البيوت، ربما يحتاج إلى من يكشف عنه. وبذا تبقى هذه الرواية في مجملها وكأنها دعوة إلى اكتشاف روح الشعب المصري وعبقرية المكان في أقدم دولة في تاريخ البشرية، وربما تحتاج إلى من يبحث عنها ويستخرجها، ويدرك أن المصريين هم الأكثر خلوداً من بيوت السلاطين والوجهاء وكبار التجار وقادة الجند.
(الحياة)