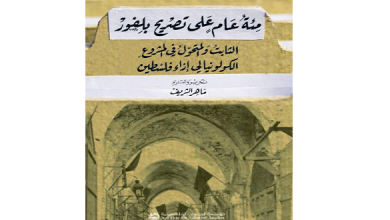المطر في شوارع المغربي محمد الشايب… دلالة اللفظ

رشيد امديون
باعتبار الشعر كان – ولا يزال- أعمق تعبير وأسمى خطاب عند العرب في الجاهلية، فإن الشاعر كان يعبر من خلاله عن متطلبات الحياة المادية والمعنوية، وشؤون المجتمع والقبيلة، وبما أن البيئة العربية القديمة ولطبيعتها الصحراوية كانت في أمس حاجة إلى القَطْر أكثر من أي بقعة أخرى، كما أنه لشدة تأثر شعراء العرب بالماء استعاروا من السحاب والمطر والبرق صورا لبناء أساليب بلاغية، كقول أوس بن حجر وهو يصف بياض السحاب:
يا منْ لبرقٍ أبيتُ اللّيلَ أرقبُهُ٭ في عارِضٍ كمضيءِ الصُّبحِ لمّاحِ
من شدة هذا التعلق عاش الشاعر حالة القلق التي أرقته وهو ينشد رؤية المطر منهمرا. ويبقى للماء وللمطر أهميته، سواء في الصحراء أو في الأماكن الخصبة، لأنه الحياة وأمل البقاء ووسيلته، على هذا ورد في القرآن في سياق ذكر تعدد آيات الله الكونية ونعمه «وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا».
كما أن الأمثال العربية القديمة لم تخلُ من ذكره مثل قولهم: «يَحْسَبُ الْمَمْطُوْرُ أن كُلاًّ مُطِرَ». ثم يأتي الشاعر الرومانسي فيراه بدلالات أخرى.. ففي بعض من النصوص الحديثة كالقصيدة المشهورة «أنشودة المطر» لبدر شاكرالسياب، تُساق لفظة المطر للتّعبير عن حالة وجدانية وعاطفية ـ للشاعر- وعن منظوره للأوضاع العامة، فهو خطاب من خلف الدلالات.. وهو الحزن تارة والميلاد المتجدد وهو الثورة والحياة والأمل والتفاؤل تارة أخرى. وكذلك قصيدة «على وقع المطر» لنازك الملائكة التي بدورها تخاطب من خلاله الموجودات وتبث مشاعرها المنهمرة كالمطر.. وكإيقاع موسيقي حين يُصغي إليه شاعر رومانسي مثل أبي القاسم الشابي:
وأطرقتُ أصغي لقصف الرعود * وعزف الرياح ووقع المطر
وهو «مطر ناعم في خريف بعيد» عند محمود درويش، وهو الحنين إلى الأنثى والحبيبة في «عقدة المطر» عند نزار قباني:
«أخاف أن تمطر الدنيا ولست معي/ فمنذ رحلت كانت عندي عقدة المطر».
وله ترسم الطيور بجناحاتها «فوق جبين الريح/وزخّ الأمطار/ إسم الحرية» عند هشام بوقمرة. فالكلمة واحدة وتتعدد الدلالات وفقا للسياقات النصية ووفقا للنسق الثقافي الذي ترد فيه، ووفقا لحالات الشاعر أو الكاتب النفسيه والعاطفية.
في مجموعة قصص «الشوارع» للقاص محمد الشايب، نكاد لا نجد قصة تخلو من ذكر المطر/الماء أو تلمح إليه بدلالة صريحة أو مجازية، أو باستعارة حركته الطبيعية التي هي الهطول، للتعبير عن فعل ما أو حركة ما أو حالة وجدانية معينة. تأخذ الدلالة بعدها الرمزي فتفيد الأمل وحينا الفرح والسعادة، وتظل هذه المدلولات عالقة بين سماء الانتظار تترقبها الشخصيات كترقب الفلاح للسحب الحبلى.
في القصة الأولى نجد السارد مثقلا بها، فيمضي في غربة يطارد صوتا يعلن له عبر الهاتف أنه في شارع الحرية، ذلك الشارع الذي لم يعثر عليه – في النهاية- وبالتالي تنكشف فكرة النص في القفلة المفاجئة، لتفضي إلى أن الحرية عنوان متعلق بخياله ظل يطارده بين الأماكن. وفي هذا البحث المضني يمثل المطر سمة غالبة تدل على فسحة من أمل ضعيف جدا يتوق إليه السارد كما تتوق الأرض العطشانة إلى الغيث وإلى الفرج، نقرأ: « نعم أنا أواصل السير في دروب غربتي، ولا، لا تملأ فراغاتي سحب ماطرة، ومع ذلك أناشد ذاك المطر المؤجل أن يهطل، مع ذلك». بهذا يضعنا الكاتب خلال هذا النص أمام أسئلة الذات، هل الحرية غائبة عن الإنسان العربي بالخصوص «بكل المعاني والمعاجم واللغات»؟ هل رغم كل إرادة هذا الإنسان وقدرته في التنقل والحضور في أمكنة متعددة والانطلاق – كما شخصية النص- فهو مازال يعيش غربته مقيدا بسلاسل التيه والضياع واستمرار البحث عن شارع الانعتاق.
العبارة نفسها تتكرر، بالحمولة الدلالية نفسها، في القصة الأخيرة «محاولة هروب». السارد بضمير المخاطِب يقول إنه: «بين أسوار العطش.. والسماء ترسم قوافل السحب، والأمطار لا تريد الهطول»، فهل هي الأفراح الغائبة يا ترى، ومحاولة استمطارها؟ يقول: «والمطر يطل من شرفة العطش، ثم يبتعد»، ثم بعد انتقال في المكان وتقدم في سياق القصة نحو اللاحق، قال مخاطبا صوتا مجهولا ولعله صوت الأنا أو صوت الذكرى المستصرخة من أعماق الذات: «أين غبت يا شجرتي الظليلة، يا فاكهة الجنون، يا مطر السعادة؟» فهي إذن مناجاة، وبحث عن قيمة ضائعة، عن إحساس مفتقد، عن شعور ضائع في الزحام.. ثم هبت لحظة كرَشّة المطر الخفيف، قال: «هبت أنغام، وهطلت أمطار»، ولكنها سرعان ما انقضت كوقت جميل بارق في ظلمة وكهف الاحزان. فقال: «ولبستني البراثين القديمة، وعادت الرياح تكتب هيجانا مزمجرا، والسماء ترسم قوافل السحب، والأمطار لا تريد الهطول، والليل يستعد للهبوط».
إن دوام الحال من المحال لذلك عاد السارد إلى حالته الأولى مُرغما «على السير في شارع العطش»، العطش إلى المطر، ولا مَطر. وبهذا كان المطر في القصة الأولى كفتح مؤجل أو كأمل عالق بين السماء، كسحب لا تُمطر أو كسعادة وقعت في أسر الغياب، والسارد يُناشد هطول مطرها لتملأ فراغاته، لتروي عطش حيرته، لكنها لا تردُّ على سؤاله الوجودي الذي يطرحه من خلال هذه الأشياء. أما الشخصية في قصة «محاولة هروب»، فهي متعطشة للحظة سعادة مخبأة في كهف الحزن، أمطارُها لا تريد الهطول أيضا، ولما هطلت سرعان ما توقفت أنغامها وعادت رياح الحزن وليله المسود. إنها لعبة الفرح والحزن، فرغم كل تمظهرات الفرح وتأثيث أجوائه يظل غائبا غريبا مجهولا عن شوارع الذات.. تماما كالقصة التي تحمل هذا العنوان «الفرح» التي تحوَّل فيها العرس إلى شجار وضرب وعنف، كأنه انتقام من الحياة لأن الإنسان العربي لم يعد يقدِّر قيمة الفرح ولا يعرف كيف يفرح في تيهه العظيم.
قال: «ولسان حال خدوج يقول: كثرت الأعراس وقل الفرح».
بين تحولات الحياة يقول الكاتب حكاية العوالم التي وصل فيها التناقض بين الذات ومحيطها، قصة «شوارع الليل»، وصارت التزامات الحياة كمطارقَ في الرأس لا تُعدُّ ولا تحصى، قصة «كم مطرقة في الرأس؟»، إنه يقول حكايةَ امتلاك الفرح وفقدانه في الآن نفسه بين شوارع الضياع والتيه والجنون، وألم ضياع أمجاد الماضي، ضياع إشبيلية/ الأندلس/ اعتماد، غربة المغرب في (شارع غريب) يطل على التاريخ وتناقضاته.
حكايات نصوص «الشوارع» تشير إلى عزلة الذات بين تناقضات الحياة وضجيج العالم وزيفه، قصص لا تقول الخارج والمادي، بل تقول وتعبر عن الحميمي واللامرئي والمغيّب، وذلك الوجود في عمقه الإنساني. إنها نصوص توحي أكثر مما تنص، وتثير أكثر مما تعين، وحافزها الدائم إنسانية لا تستكين.
إن السير في شوارع محمد الشايب يؤهلك كقارئ أن ترى شخوص قصصه تفكر، تحزن، تتذكر وتحن- عفوا، بل إنك تعيش كل حالاتها- وتبحث عن فرح مؤجل عن أمل غائب، عن حرية لم تمطر سحابتها.. يؤهلك أن ترافق السارد يدا في يد يقودك إلى مشاهده وينقل الصور كما رآها. إن القاص لا يحكي حدثا بشكل تقريري، لأن الفكرة لديه لابد أن يحوِّلها إلى إحساس وشعور، لهذا وأنت تقرأ له ستبتل بالمطر الذي ابتلت به شخصية النص، وستجري وتركض في طرقات المدينة حتى تتعب من البحث عن أشياء مفقودة، ستسمع نداءات الذات.. والماضي والمستقبل والحاضر والتاريخ، سترى طيف اعتماد الرميكية قد لاح كانبعاث جديد.. ستسافر في القطار وتجلس مع الشخصيات، وتزاحم الركاب الصاعدين والنازلين في المحطات، كل ومحطته.. ومحطتك أنت هي نهاية النص، وهي العتبة إلى الدخول لنصك المفترض.. ستقف في ساحة الحافلات بالقنيطرة، وتشاهد حركة الصراع فيها والنيران التي شبت.
محمد الشايب لا يصف لنا المطر أو يحكي لنا شعوره حين بللته قطراته، ليس هذا هو رهان القصة الفنية عنده، بل الرهان أنه يجعلنا نبتل فندرك الشعور ونعيش الحالة بأنفسنا، ثم يجعلنا نحتار في شخوص قصصه، ونندهش للنهايات تارة ولسحر التأويل والغرابة نستسلم تارة أخرى. إن الذي يلج شوارع محمد الشايب لن يتوه إن تخلى عن القراءة السطحية وغاص في النصوص كي يستخرج لؤلؤها لتستسلم وترخي مفاتنها التي تواريها عنك.. أيها القارئ.
– «الشوارع» مجموعة قصصية من 76 صفحة صدرت بدعم من وزارة الثقافة، 2015. سليكي أخوين للطباعة والنشر.
(القدس العربي)