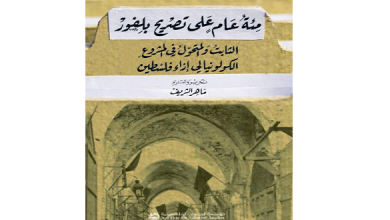«بينما ينام العالم» لسوزان أبو الهوى: رواية المنفى الفلسطينيّ في عيون جيل ما بعد النكبة

سمير حاج
تقوم الرواية الفلسطينية على ثلاث أثافٍ: إميل حبيبي وغسّان كنفاني وجبرا إبراهيم جبرا . حبيبي يندرج في التشبّث والبقاء في الوطن وإشكالية الهوية، وكنفاني في فكر المقاومة واسترداد المكان المسلوب، وكلاهما اهتما بالنقلة الفنية الروائية وإن كان حبيبي مزج بين التجريب واستلهام التراث. بينما وجبرا يهتم في دور المثقفين في الحراك الاجتماعي وصبغ الفلسطينيّ الفرديّ بالكاريزما الخارقة في مجتمع الشتات، إضافة إلى معمارية الرواية.
حبيبي حامل صخرة البقاء أكثر من خمسين عاماً والمتأبط بها في طوفانه في شوارع وحارات وأزقة حيفا، والصاعد بها رغم ثقلها نحو جبال الكرمل ليصرخ في وجه العالم بالهتاف الذي اجترحه في مسيرته وتجربته في وطنه «باق في حيفا» و»لا تلوموا الضحية»، وكنفاني الباحث عن خلدون في حيفا والمتخلّي عنه رغم عقدة الذنب لإيمانه أنّ الإنسان قضية وموقف، والواعي لإشكالية الهوية، وجبرا الباحث عن وليد مسعود المختفي فجاءة، والمشغل أصدقاءه في متاهة استقراء وتحليل الشريط السيريالي الذي تركه.
سوزان أبو الهوى، المقيمة في أمريكا، والمنتمية إلى جيل ما بعد النكبة تخوض من منفاها تجربة روائية رائدة في استقراء النكبة الفلسطينية رغم الفاصل الزمني بينهما، تحكي تشريد عائلة أبو الهيجا التي اقتلعت من قريتها عين حوض عام 1948. وترصد الرواية بأسلوب دراميّ أعراس الدمّ في حياة عائلة أبو الهيجا مدّة أربعة أجيال متعاقبة، بدءًا من الترحيل القسريّ من «عين حوض» والقتل والهدم العام 1948 ومروراً بهزيمة يونيو حزيران 1967، وأحداث أيلول الأسود عام 1970، ومذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982، ونهاية بمجزرة مخيم جنين عام 2002. تبدأ الرواية من المكان أو الفضاء الضيق وتنتهي بين عامي 2002-2003 خارج المكان الفلسطيني، في ولاية «بنسلفانيا» الأمريكية حيث تقيم الذات الكاتبة.
هل يستطيع توثيق النكبة الفلسطينية من لم يعشها؟
في نظر إميل حبيبي من لم يعش المكان، لا يستطيع الكتابة عنه وهذا يتطابق مع نظرية غاستون باشلار القائلة إن المكان ليس البنيان الظاهريّ إنّما النواة الداخلية اي الارتباط به (باشلار، جماليات المكان، ص 78 )، وحتى كنفاني في نظر إميل حبيبي أخطأ الاتجاه في «عائد إلى حيفا»، هذا ما صرّح به حبيبي في آخر مقابلة أجريت معه قبل وفاته «الآن في قضية المكان: أنا أستغل، بعمق وبألم، واقع أنّني أستطيع أن أزور المكان، فيما إخوتي وزملائي في المنفى لا يستطيعون ذلك. أنا تعلمت بمفاجأة مؤلمة، من رواية غسان كنفاني «عائد إلى حيفا» شيئاً عن المكان. في هذه الرواية يصف غسان حيفا والشوارع والأحياء التي قطعها أهل المدينة في هروبهم عبر البحر. ولا أذكر إن كان غسان رحمه الله عاش في حيفا أم لا. لكن مع ذلك، أنا حاولت أن امشي مع غسان الطرق التي وصفها وجعلها الطرق التي انتقل عبرها اللاجئون الفلسطينيون في حيفا إلى شاطئ البحر. ووجدته، أحياناً، بدل أن ينزل بهم إلى البحر يصعد بهم إلى الجبل» (مشارف، ع9 – حزيران 1996، ص21).
هذا الكلام ينسحب بعض الشيء على رواية «بينما ينام العالم» فقد وردت في الرواية بعض الأخطاء في الوقائع، مثل الحديث عن طالب في جامعة بيت لحم عام 1967 (ص147)، والجامعة لم تكن موجودة بعد، فقد تأسست الجامعة عام 1973. وكذلك الأمر في القول إن قرية «عين حوض» بعد احتلالها في العام 1948، هدمت عن بكرة أبيها (ص54 ).، والصواب أنّها لم تهدم، فقد احتل بيوتها وسكن فيها يهود أوروبيون، وكما ورد في كتيب توثيق قرية عين حوض، الصادر عن جامعة بير زيت :
«ففي بعض القرى مثل عين حوض قرب حيفا وعين كارم قرب القدس بقيت معظم البيوت قائمة كما هي وسكنتها عائلات يهودية بعد ان أخليت كليا من سكانها الأصليين من العرب الفلسطينيين» (القرى الفلسطينية المدمرة عين حوض، جامعة بير زيت، مركز الوثائق والأبحاث، ص3).
في نظري من يقرأ التاريخ الشفويّ والكتابيّ للنكبة الفلسطينية بالرواية الصحيحة للمكان، ممن عاشوا النكبة أو من مصادره الثقة، يستطيع الكتابة عنها وتوثيقها بنجاح في العالم التخييليّ المشيّد، وإلا من سيكمل الرسالة في أرشفة تاريخ النكبة، والمكان المشظّى والمسلوب في الذاكرة الجمعية لشعبه، خاصة أنّ معظم جيل النكبة رحل، وترك تاريخه وروايته أمانة ورعبونا للأجيال بعده.
كتبت رواية «بينما ينام العالم» باللغة الإنكليزية وصدرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام (2010) تحت عنوان Mornings in Jenin، وترجمت إلى اللغة العربية عام 2012 من قبل سامية شنان تميمي، وصدرت عن دار بلومزبري- مؤسسة قطر للنشر ب 476 صفحة.
الرواية تحكي بنجاح من منظور نسوي فلسطينيّ سفر العذاب الفلسطينيّ، وملحمة الاقتلاع من المكان والنفي في أمكنة متعدّدة، وانشطار الذات والغربة النفسية والاختفاء، والهدم والقتل والحروب والمذابح التي أحاقت بالشعب الفلسطينيّ، وحياة الشّظف في المخيمات، والمقاومة والانتفاضة، في العقود الستة الأخيرة.
تبدأ الحكاية لتؤسّس لهوية المكان الفلسطينيّ المدمّر، بشرا وحجرا وشجرا، ولتلمّح بالاقتلاع والنفي، ومحو الهوية والمعالم، لسبع سنوات خلت قبيل التشتيت والترحيل في العام 1948 .
عنوان الرواية مستقى من قصة «بينما ينام العالم من حولنا» والتي كان والد آمال، الساردة الرئيسية، يقرأها على مسمعها عام 1967 بعد تدمير مخيّم جنين.(ص121) .
تتماهى الرواية مع عائد إلى حيفا (1969) لغسان كنفاني ( 1936-1972 )، من حيث التربية اليهودية للطفل الرضيع خلدون، الذي اضطرت أمّه إلى تركه في البيت، في حيفا أثناء احتلال حيفا عام 1948، وذهبت تبحث عن زوجها ثمّ أرغما على النزوح . وحين عادا إلى بيتهما عام 1967 ليبحثا عنه، وجداه جندياً إسرائيلياً يحمل اسم «دوف»، وقد بقي دوف منحازاً لأفكاره الصهيونية.
ففي «بينما ينام العالم» حين احتلت عين حوض عام 1948 وأثناء هروب عائلة أبو الهيجا إلى مخيّم جنين، سرق الابن إسماعيل ابن الستة أشهر بعد أن سقط من حضن أمّه داليا، من قبل ضابط يهوديّ يدعى موشيه، قام هو وزوجته يولانتا العاقر بتربيته، وأطلقا عليه اسم دافيد. في جنين، في حرب حزيران 1967 حين احتل الجنود الإسرائيليون المخيّم، التقى يوسف، الأخ الثاني لآمال بأخيه إسماعيل المدعو دافيد والذي أصبح جندياً إسرائيلياً، وقد عرفه من خلال الندبة التي في وجهه. وقام دافيد بتعذيب وضرب أخيه إسماعيل من حيث لا يدري أنّه أخوه.
تشكّل الندبة شيفرة لتفسير النصّ وتفكيك مضامينه وهي صورة سيميائية ودالّة على هوية إسماعيل، كما أنّها تحيل إلى الحقيقة التاريخية التي لا يمكن إخفاؤها، والخاصّة بهوية الإنسان والمكان الفلسطينيّ فطبوغرافية الجسد مثل طبوغرافية الأرض، مهما شوّهت وحرّفت تبقى تدلّ على الحقيقة. حتى «يولانتا» التي ربّت دافيد وأخفت السرّ عنه مدة طويلة، لم تكن تنوي إخفاء الحقيقة عنه إلى الأبد.
تشير الرواية الى أنّ دافيد، رغم صورته البشعة وسلوكه القذر، هو ضحية النكبة والتهجير، ومرآة لثقافة المحتل الذي هجّر الفلسطينيّ ونهب أرضه. هذا ما تجسّد في مونولوغ يوسف، في أكثر المواقف تراجيدية بعد أن ضربه دافيد حتى أغمي عليه، فقد اتهم اليهود أنّهما فصلوا بينهما ولم يتّهم دافيد أي إسماعيل سابقاً.
صورة «دافيد» السلبية هي نتاج ثقافة الاحتلال الإسرائيليّ، وهي قريبة من «دوف» في رواية غسّان كنفاني، بسبب القطيعة مع جذورهما الفلسطينيّة، وبسبب الثقافة العسكريّة الصهيونية التي نشأ عليها. إنّ دافيد لم يغيّر هويته رغم إضافة اسمه السابق لاسمه الحاليّ، ولم يصبح فلسطينيّا من ناحية فكريّة وآيديولوجيّة، إنّه كما خلدون في «عائد إلى حيفا» الضدّ لأخيه الفدائيّ المقاوم، رغم التراجع الضعيف في موقفه.
إنّ بناء شخصية دافيد في الرواية جاء مبتوراً ومفتعلًا، كما أنّ المصالحة بينه وبين آمال، التي هي أخته في الولادة، جاءت مقحمة ومهزوزة وبعيدة عن الواقع، مما أضعف الرواية وأدى إلى خلخلة بنائها رغم نجاحها في تصوير النكبة وأعراس الدمّ في حياة الشعب الفلسطينيّ بامتياز، فلا يعقل أن الجندي دافيد نتاج الثقافة العسكرية الصهيونية المصاب بالاستعلاء والغطرسة يتغيّر فجأة، ويتجرّد من الأفكار التي ترعرع عليها وانتمى إليها، مقابل الجينات الوراثية والروابط البيولوجية مع آمال. وفي الرواية نفسها يظهر التقاؤه بأخته آمال في ولاية «بنسلفانيا» الأمريكية فاتراً وخالياً من الحرارة والشّوق رغم القطيعة الطويلة. كما أنّ اللقاء حصراً في أمريكا جاء مرسوماً ومقصوداً ليعبر عن الفتور في العواطف واستحالة اللقاء في فلسطين.
هذه المصالحة بين آمال ودافيد شكّلت ندبة في الرواية، وهي مثل عملية تجميليّة غير ناجحة. كما أنّ اللقاء بينهما جاء بعد أن اندثرت الأسرة إبادة وقتلاً من قبل الإسرائيليين، باستثناء سارة ابنة ماجد وآمال، لذا بقي كل منهما غير منتم للآخر.
من ناحية فكرية، هذه المصالحة على النقيض من رسالة رواية «عائد إلى حيفا»، رغم كون خلدون ضحية الحرب والاحتلال، فقد انتبه كنفاني قبل غيره من الكتاب الفلسطينيين في تلك الفترة (1969) الى أنّ الإنسان قضية وموقف، فحين أنكر خلدون أباه سعيد وأمّه صفية بسبب قطيعة عشرين سنة، صرخ سعيد في وجهه: – «لا حاجة لتصف لي شعورك فيما بعد، فقد تكون معركتك الأولى مع فدائيّ اسمه خالد، وخالد هو ابني، أرجو أن تلاحظ أنّني لم أقل أنّه أخوك، فالإنسان كما قلت قضية، وفي الأسبوع الماضي التحق خالد بالفدائيين …أتعرف لماذا أسميناه خالد ولم نسمه خلدون؟ لأنّنا كنّا نتوقّع العثور علبك، ولو بعد عشرين سنة، ولكن ذلك لم يحدث. لم نعثر عليك …ولا أعتقد أنّنا سنعثر عليك « (عائد إلى حيفا 2006، ص66) هذه الصحوة الفكرية والإشراقة اللغوية الكنفانية، تتماهى مع قول محمود درويش:
«أتيت، ولكنني لم أصل . ووصلت ولكنني لم أعد»
رغم المصالحة المقحمة في نهاية الرواية، تقدّم الرواية للقراء الأجانب وللرأي العام العالمي، وثيقة وشهادة هامّة ومثيرة عن النكبة الفلسطينية لأرشفتها في الذاكرة، وصرخة في وجه عالم لا مبال. إنّها تقدّم بجدارة صوتاً فلسطينيّاً نسويّاً مبدعا في الرهافة وتوثيق الأحداث والأمكنة وتغريبة الفلسطينيّ، بعاطفة مؤثرة ومتناغمة والمشاهد …إنّها رواية الإنسان والمكان، رواية المخيّم والشّتات المعصورين بخميرة الحب والتضحيات.
(القدس العربي)