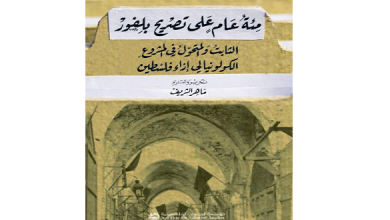الرسامة المصرية هبة حلمي في تعريف مؤلم لحقيبة

محمود قرني
لا أظن أن الفنانة التشكيلية هبة حلمي، وهي تكتب مجموعتها السردية الأولى، «بنت في حقيبة»، كانت مشغولة بما أثاره غبار المعارك التي احتدمت وما زالت حول قضية الأنواع الأدبية لا سيما في ارتباطها بما يسمى تيار الوعي، الذي سخرَ من التوصيف الأرسطي للكتابة باعتبارها نوعاً من المحاكاة، ثم أمعن في تحطيم التقاليد النسبية التي أسست لها النظرية الأدبية.
القضية، طبعاً، كانت جزءاً من مشاغل عشرات الكتاب على المستويين العربي والعالمي. ولعل ما أثاره بطرس حلاق في مقالة له تحت عنوان «وظيفة الأدب لدى تيار الكتابة عبر النوعية»، كان يشير إلى أن تصنيف الأدب باعتباره فرعاً من فروع المعرفة منذ «العقل الخالص»، كان له أثر مباشر في تحديد وظيفة الفن باعتباره ابن المعرفة التي لا تقوم على واقع موضوعي، بل على تفاعل الذات مع هذا الواقع. وهنا، في تلك المجموعة، تبدو سجلات الألم مكتنزة بواقع يبدو مريراً، على رغم أن راويته تقف على أعلى سلم التصنيف الطبقي، فهي تتحدر من جرَّاح «الأب» وطبيبة تخدير «الأم»، وقروي شديد الثراء «الجد». وهي عبر رحلة طويلة تكثف تجربتها عبر تقطير لغوي يبدو أحادي الدلالة في كثير من أحواله، ربما لأنه يبدو غير قابل للتأويل، لأن الكاتبة لم ترغب قط، عبر ثلاثة وستين مقطعاً تضمنها الكتاب، في أن تفصح عن انحيازاتها بسفور أدباء الالتزام أو بمنطق الكتاب العضويين وفق تعبير غرامشي. وذلك لأن تعبيراتها الموضوعية عن انحيازاتها تنتمي إلى وعيٍ ربما بدا أكثر انتماءً لما بعد الحداثة، لا سيما في تصوراتها عن تحطيم مركزية الحدث وقداسته.
وهي صورة تتبدى بجلاء منذ السطور الأولى لتقدمة الكتاب: «إن الحسم والوضوح الذي تفترضه الذاكرة في قصتها لا حياد ولا موضوعية فيه. أرتب الأحداث القديمة في عقلي كحلم نسيته أثناء لحظة الاستيقاظ. أستعيد صوره وأُكَوِّن بها قصة لها مطلق الحرية أن تتشكل مؤلفة من الألف إلى الياء». تلك التقدمة تعني بالضرورة أن ثمة مسافة تؤشر إليها تلك النصوص بين الكاتبة وسرودها، بما يعني أن فكرة التطابق لا تمت للقراءة النقدية بصلة.
قراءات ذكورية
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فهي ربما تكون إشارة انتباه إلى بعض القراءات الذكورية نقداً وإبداعاً، عندما تمضي متربصة بنصوص تتضمن اجتراءات على هذا القدر من الحيوية والصدق. ومع ذلك فإن منطقة الحلم الفرويدية التي تشير إليها الكاتبة في تقديمها تبدو توطئة مناسبة لإعادة الاعتبار إلى أوقيانوس اللاشعور باعتبار أن كثرة من الأحداث التي تلم بنا ربما تشكَّلت صورتها كلية في منطقة اللاوعي.
من هنا تبدو تلك المجموعة من النصوص أكثر ارتباطاً بمفهوم «اللعب» بمعناه الفلسفي. وهي على ذلك تحطم مركزية أحداثها بانتظام، ما يعني فقدانها الثقة بفكرة الحقيقة المطلقة، بعد أن كشفت أحداث نصوصها عن مساحات غير محدودة من الإيلام التي تجسدها مناخات خيانية جائرة في السياسة كما في العلاقات الإنسانية. يتجسد ذلك عبر خيانات كبيرة وصغيرة، تبدأ من خيانة الثورة ولا تنتهي بخيانة العاشق الذي يقدم نفسه عادة في براءة آلهة الأوليمب، عبر أداءات طليعية متقدمة ثم يتبدى سلوكه عبر أبشع صور الرجعية، وربما الوحشية أيضاً، لا سيما في تلك الصورة البشعة عندما يقتحم ذلك العاشق بيتها ويدلف مباشرة إلى غرفة النوم ويطلبها إليه، فتعيش لحظات مؤرقة تفقد فيها القدرة على التفكير حتى تتذكر أنها حائض، فترفع ملابسها لتريه بقع الدم على ملابسها الداخلية فيضطر آسفاً إلى الانصراف، لتكون تلك الحكاية في ما بعد حديثاً شائعاً على لسان أصدقائه. أيضاً تمثل محاولات الاغتصاب غير المكتملة التي تعرضت لها راوية الأحداث جانباً من تلك الصورة المعتمة. سيضاف إلى ذلك سجل من المخازي تجسدها تلك العلاقات الأسرية التي تنطوي على شيء غير قليل من الاضطراب، لا سيما في صورة خيانات الأب للأم ثم في انفصالهما، وعبر هواجس الابنة بوجود رجل في حياة أمها بعد رحيل الأب، فقط لأنها تهتم بزينتها الداخلية كما بزينتها الخارجية.
وكذلك عبر أخطاء طفولية ذات طبيعة مدرسية تدفع فيها الراوية ثمن صدقها عندما تقول إنها «المغفلة» التي اعترفت لمديرة المدرسة بأن صديقها لم يفز منها إلا بقبلة، بينما أنكرت الأخريات ما حدث لهن، فيخرجن من التهمة بريئات وتظل هي في مرمى سهام طائشة. كذلك تبدو تلك الصورة عبر تجسيداتها لفكرة الأمومة بداية من حملها بابنتها الوحيدة حتى ولادتها التي بدت رديفاً لولادة ثانية للأم نفسها، وكذلك في تحولات مفاهيم القيم الاجتماعية عبر رصدها لحقب تاريخية متباينة تبدأ من هزيمة حزيران (يونيو) 1967، عندما تشير إلى أن «عبدالناصر عندما أراد أن يغير التاريخ غير الجغرافيا»، ثم عبر تداعيات حقبة الانفتاح الاقتصادي وانهيار الطبقة التقليدية «المتوسطة»، ضمن تداعيات بناء اجتماعي أرادت له الدولة أن يكون كذلك.
الهرب من الذكريات
لا تأخذ قصص المجموعة عناوين لها بل انتظمتها سلسلة رقمية، ما يعني أن الكاتبة تريد القول إن ثمة خيطاً يربط بين تلك القارات الشعورية أو اللاشعورية التي تنتظمها الأحداث، حيث تبدأ المجموعة بقصة صفرية تحمل عنوان المجموعة وهي عن تلك الحــــقيبة التي تمتلئ بالكثير من الأشياء المنسية.
في هذا السياق، تتبدى محاولة الراوية تطهير تلك الحقيبة من مهملاتها رديفاً لرحلة تطهرية تقطعها للكاتبة للتخلص من تلك الذكريات عبر الكتابة، كما بـــدا باطـــن هذه الحقيبة المملوء بالغبار رديفاً لتلك الحياة الإنسانية التي عاشتها الكاتبة بكل ما فيها من طيب وكدر.
اختارت حلمي تجاوز تلك المفاهيم الرومانسية حول الفن كما حول الحياة؛ لإدراكها أنها لا تحتاج إلى قوة قاهرة خارج حدود التصور لإنقاذها من حياة بدت قدَراً صعباً. هذا يعني بالضرورة أن كل تصورات الكاتبة حول الفن ارتبطت بمحنة الإنسان نفسه، حيث أصبح الإبداع يقرأ صورته في هوامش تبدو مهملة ولم تكن يوماً إلا صورة ناصعة لحقائق قديمة. وربما كانت اللغة المقطرة للمجموعة تفسيراً لذلك الملل من تفاصيل بدت، في قياساتها المنطقية، ضد العقل، على رغم أن فهم الكاتبة للعب هنا بدا تعبيراً عميقاً وواعياً عن مفهومها للحرية، التي لا غاية لها سوى إعادة إنتاج الخبرة الإنسانية ضمن أبنية مهجوسة بالإدانات الأخلاقية أحياناً، وبرفض الواقعين السياسي والاجتماعي في معظم الأحيان، من دون أن يكون ذلك تعبيراً عن خطابات أيديولوجية تعرفها هبة حلمي بحكم انتماءاتها اليسارية القديمة. ويبدو أنها ما زالت انتماءات حية وفاعلة تتبدى في عمق وبساطة تحليلاتها الطبقية للمشهد الاجتماعي، الذي تتساوق فيه صورة الكاتبة مع صورة الثورة وهما تمضيان معاً كبنتين مغدورتين في أحراش العالم الواسع.
(الحياة)