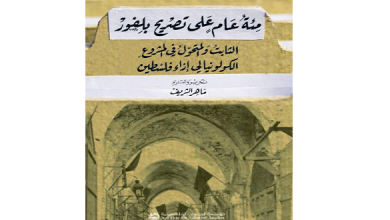شعرية المنجل أو طوباوية أبي بكر مُتَّاقي في»عواطف مادية ومشتقاتها»
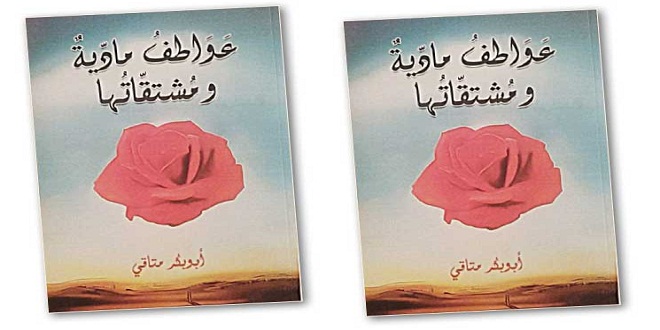
محمد العرابي
يوتوبيا: «أُنَظِّفُ مَكَانًا فِي أَعْمَاقِي مِنَ الهَلْوَسَاتِ يَكُونُ جَدِيرًا بِشَجَرَةِ العَوَاطِفِ وَالعَواصِفِ الْمُلَازِمَةِ لَهَا»
(أبوبكر مُتَّاقِي، عواطف مادية ومشتقاتها).
تتملكنا الحماسة أحيانا لنجزم، بإطلاق، أن الشعر لا يستجيب لغير ذاته، ولا يصغي لغير نبضه، وهو يتحسَّس مواطئ أقدامه ويترسَّم الآفاق التي عليه أن يفتحها. هذه الحماسة تنكفئ حينما يراد للشعر أن يضطلع بمزاعم تصل في أقصى حالاتها حدَّ تغيير العالم. لا ينفي ذلك أن الشعر، كما هو كائن وكما تجري ممارسته فعليا، يشمل أنماطا متعددة تتكئ على ما يقع خارجه، ويمرِّرُ رسائلَ بحكم الاختلاف في التصوُّر الذي بموجبه يتم النظر إلى الشعر.
حسب الإدعاء الأول، لا يخرج الشعر عن إرادة الحلول في ذاته وإعادة تسمية أشياء العالم اعتمادا على طاقة اللغة وخصوبتها وحدها. وهو مَنزَعٌ يكشف عن نقصٍ تكوينيٍّ ضروري للذات، يضعها في مقابل اكتمال أو يوتوبيا ذات هوية منشطرة وترقٍّ معرفي بالأساس: «حُلُولُكَ فِي إِرَادَةِ الْمِنْجَلِ. أَوْ إِرَادَةِ الْمِقَصِّ. أَوْ هُمَا مَعاً. لَكِنَّ ذَلِكَ يَجْعَلُكَ مُعْوِزًا وَفَقِيرًا إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ أَنْتَ تَحْدِيدًا». إرادتان يمكن لإحداهما أن تحلَّ محلَّ الأخرى، لتنضعهما في إرادة واحدة، ويمكن لهما أن تتضايفا وتُبقيا على اختلافهما وفروقهما الطفيفة؛ إرادة المنجل وإرادة المقص؛ إرادة تجتثُّ وتقطع بلا رحمة. لحظة قطيعة لها ما قبلها وما بعدها، حاملة لكل توتر ذي طبيعة ثنائية ميتافزيقية. الإرادة التي تنتزع مجمل شعرية أبي بكر متاقي في ديوانه: «عواطف مادية ومشتقاتها»(2017)، يمكن وسمها بـ»شعرية المنجل»، ذلك أنها تحمل في ذاتها قدرة خارقة على القطع والتدمير وبث الفوضى، لتبقى كذلك وفي الأقل، وربما في الأغلب لإقامة الكيانات الهجينة المنتمية لعالمها الخاص، الذي أُسمِّيه باليوتوبيا. هي يوتوبيا إذن، تختلف عن اليوتوبيات التاريخية منذ أفلاطون في جمهوريته الفاضلة، مرورا بيوتوبيا توماس مور التي تفتح خزائنها للجميع، أو يوتوبيا إنجلز المضللة للجماهير، وليس انتهاء بيوتوبيا الجسد لميشيل فوكو. بمعنى يوتوبيا تحمل نقصها الخاص الذي هو من قبيل الكيان الذي تجري على مسرحه كلُّ الرجَّات وكلُّ الزلازل التي تعيد طرح الأسئلة الأولى البانية للذات والكاشفة للصيرورة: «من أنتَ؟»، «من تكون؟» وهل يتدفَّقُ الزمن بشكل سلس يحفظ لهذه الهوية وحدتها وقدرتها على التكيف مع أبجديات الحضارة والتاريخ؟ أم ينزع إلى القطائع المؤلمة والضرورية لمواصلة العيش، اعتبارا لهويات أخرى بديلة أو مستنسخة؟ هكذا لا يهدأ أبو بكر متاقي وهو يلاحق ذات الشاعر بأسئلته المؤرقة المنذرة بالقيامة: «مَنْ تَكُونُ قَبْلَ الزِّلْزَالِ. مَنْ تَكُونُ بَعْدَهُ. أَسَاسَاتُكَ اِرْتَجَّتْ أَمْ كَابَرَتْ. تَدَاعَتْ أَمْ صَمَدَتْ؟».
لا يخفى أن الزلزال يحصد هو أيضا الحياة والعمران، تماما مثل المنجل الذي يُبيد الأشياء التي تطالها يده. لكن في كلتا الحالتين لا يئد الزلزال كل الحياة ولا يذر المنجل كل هشيمها في ريح العدم، بل تعتبر هاتان لحظتين ضروريتين تبشران بميلاد قوانين جديدة تعرِف كيف تدَّخر نقصها لترتقي في «تَعَالِيمِ الزَّنْبَقَةِ البَيْضَاءِ»، وكيف «تَتَهَجَّدُ لِتَحْتَكَّ بِسَاقِهَا الرَّهِيفِ بِارْتِقَائِهَا فِي النَّدَى. بِارْتِخَائِهَا دِفَاعًا عَنْهُ وَخُضُوعًا لَهُ: الضَّوْء». الضوء هذا المكون الغائب عن ليل الذات الطويل، الذي يضرب أطنابه ويخيم في الداخل كما على الحوافي ويداوم على الحرمان: «فِي الَّليْلِ الكَهْفِ/ الَّذِي عَلَى مَدْخَلِهِ أَقَمْتُ أَحْرُسُهُ/ مِنْ غَيْرِ أَجْرٍ سِوَى مَا تَتْرُكُهُ عَابِرَاتُ السَّبِيلِ/ أَجُوعُ / وَأَسْهُو عَنْ جُوعِي مَا أَنْ أَسْتَعِيدَ ذِكْرَى شَبَعٍ قَدِيمٍ».
وإذا كان لابد أن تقطع مناجل الذات كل هذا الليل، وإذا كان لابد من الخضوع لإيقاع المناجل الكفيلة وحدها بإلقاء الضوء على «جهاتي الباطنية المهدَّدة بالزلازل»(من مسودة الديوان التي خصني بها الشاعر وأسقطها من النشر في النص الحالي)، فما ثمة من طريق مرسومة أو معدة سلفا، ما من نموذج تطرحه الأيديولوجيات المتصارعة على عرش الكلام والعالم يمكنها أن تنتج «معيار الشاعر الخاص»، وما من سبيل مؤكدة بإمكانها أن تزرع الثقة والاطمئنان، وإن توسلت بكل ترساناتها العلمية والفلسفية وغاباتها البعيدة الموغلة في التأويل، على اعتبار أن لا أرض ثابتة في الشعر ولا طريق، والذات على هذه الأرض تبدأ من الظن وتنتهي إليه: «مَا مِنْ مِعْيَارٍ تُعِيدُ وِفْقَهُ تَقْطِيعَ رُكَامِ الأَفْكَارِ المُرْسَلَةِ إِلَيْكَ عَبْرَ المَجْرَى. مَا مِنْ تَصْرِيحٍ رَسْمِيٍّ مُصَادَقٍ عَلَيْهِ يُبِيحُ لَكَ إِنْتَاجَ مِعْيَارِكَ الخَاصّ. إِلَّا أَنِّي لَسْتُ عَدُوًّا أَوْ حَلِيفًا لِلغَابَةِ البَعِيدَةِ لَكِنَّ النَّظَرَ وَإِعَادَةَ النَّظَرِ وَالتَّمْحِيصَ وَالتَّأْوِيلَ، كُل ذَلِكَ غَيْرُ مَأْمُونِ النَّتَائِجِ. وَالتَّفْكِيرُ لَيْسَ خَلَّاقًا أَبَدًا مَا لَمْ يَبْدَأْ مِنَ الظَّنِّ وَيَنْتَهِي إِلَى الظَّن»، وبوحي هذه الظنون يتهيأ لي أنني أعرف، ليس على وجه اليقين طبعا، هذه المناجل التي لا تحصد فقط، وإنما فضلا عن ذلك، تزرع الحياة وتخصِّب (بكل ما تحمله من حمولة عشقية وجنسية) كل ما تُقبِّله في طريقها وتتركه رهن ارتعاشات الجسد واللغة. هذا مما خبرته بالتجربة من طول معاشرتي للأبقار والماشية وما كان يفرضه عليّ توفير الكلأ، واستعمال المناجل والإنصات لإيقاعاتها، بحيث أن أنواعا من المزروعات والحشائش تتجدَّد وتندلع فيها خصوبة الحياة بمجرد أن تلقى فيها المناجل وتُعمِل فيها مضاء الحديد حشًّا وتقطيعا، ولن أمثل بغير نوع واحد معروف: الفَصَّة، أو البرسيم الحجازي. لكن مناجل أبي بكر متاقي أكبر بكثير من ظنوني الصغيرة هذه، وعلى إيقاعها تتفكك، بالتدريج، خيوط البداهة وما انطمس فيها من أنظمة رمزية عليا للغة وما جاور: «بِالْمَنَاجِلِ يُحْسَمُ العِرَاكُ مَعَ حَقْلِ كَلِمَاتٍ»، وأيضا «عَلَى إِيقَاعِ المَنَاجِلِ وَالأَهَازِيجِ الخَشِنَةِ (…)/ للطّيْرِ أَضْعَافُ مَا لِلْحَصَدَة/ عَلَى الأَرْضِ/ وَفِي السَّمَاءِ/ بَرًّا / وَجَوًّا/ تُرْسِلُ الْشَمْسُ خُيُوطًا مُشَفَّرَةً تَنْشَغِلُ المَنَاجِلُ بِفَكِّهَا». (من المسودَّة، مما سقط من الديوان).
لا ينسى أبوبكر متاقي وهو في غمرة عراكه مع الكلمات وفي غمرة تصفية حساباته مع العواطف المادية المتسامية مع الذكرى أن يحمل معه آلته المفضلة التي تخصِّب عالمه الخيالي الذي وسمناه سابقا باليوتوبيا: «مَعِي مِنْجَلٌ تَحَسُّبًا لِحَقْلِ عَواطِفَ مَنْسِيٍّ فِي الرَّأْس»، ما دام يكثف فيها، في نهاية التحليل، رؤيتَهُ الجماليةَ للشعر «…وَالجَمَالُ أَخِيرًا مُجَرَّدُ مِنْجَلٍ».
(القدس العربي)