القطارات.. الحب الذي كان
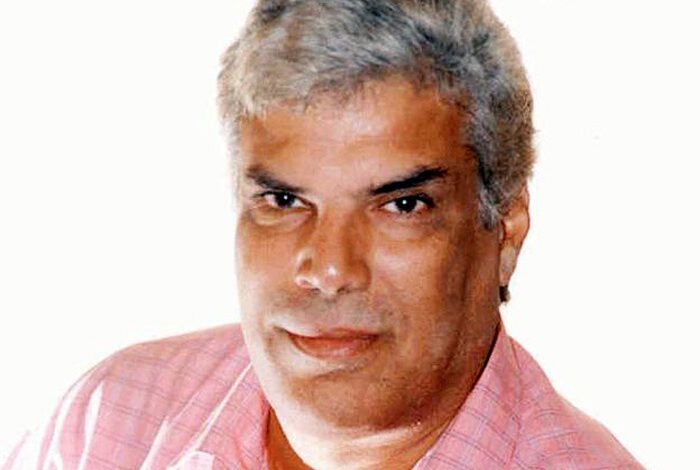
- اعتذار للمتنبي - 2024-04-11
- أوديب في الطائرة - 2024-03-14
- حوارات صحفية ولكن.. - 2024-02-24
عشت مغرمًا بركوب القطارات أكثر من أي مركبة أخرى. توقفت عن ذلك في السنوات الأخيرة بسبب ارتباك المواعيد والتأخير الذي يتكرر كثيرًا. لم يكن ركوبي القطارات لأنها أكثر أمنًا فقط، لكن لأنها كانت أرخص سعرًا من غيرها وأكثر راحة. طبعًا كان ركوبي دائمًا أيام الشباب في الدرجة الثالثة. كانت عرباتها دائمًا مزدحمة حتى جاء يوم في عام 1971 أو 1972 وكنت في القاهرة أسجل قصة قصيرة لي في البرنامج الثاني للإذاعة. جاءت سيرة القطارات، ونحن نجلس في الاستراحة قبل التسجيل، وعشقي لها، فإذا بمذيع يسألني لماذا تركب في الدرجة الثالثة ولا تركب قطارًا مكيفًا. كانت الإجابة العادية أن تذكرة الدرجة الثالثة أرخص. أشار إلى السيجارة التي في يدي وقال، امتنع عن السجائر يوم السفر، ووفر ثمن علبة السجائر وضفه إلى سعر التذكرة، واركب الدرجة الثانية المكيفة. أعجبتني الفكرة وفعلتها، لكنني لم أمتنع عن السجائر. وجدت الأمر أفضل وفي طاقتي المادية. صار ركوبي القطار المكيف فرصة للقراءة. اكتشفت أن ركوبي الدرجة الثالثة هو ابن العادة. وأن قطار الدرجة الثالثة مزدحم جدًا بالناس، فليس فيه فرصة التأمل والتفكير، لأن الزحام يشمل الطريق بين المقاعد والرفوف العالية التي أيضًا يجلس أو يتمدد عليها بعض الركاب، وقلت لنفسي لن أجد جديدًا فيه.
صرت أرى الطريق بشكل أفضل، المزارع والحقول المترامية على الناحيتين التي مع الوقت قلّت وارتفعت فيها المباني، وصارت الرحلة بالقطار تجعلني أرى دليلًا على العشوائية التي تتمدد في البلاد. دخل القطار في كثير من قصصي ورواياتي وكذلك عمال السكة الحديد. لقد كان والدي يعمل فيها، وكثيرًا ما حدثني عن كل شيء. كان طريقي إلى المدرسة الابتدائية يمر بين السكة الحديد في منطقة القباري وأرصفة قطارات البضائع، حين كان في مصر نقل بالسكة الحديد، قبل أن يتم القضاء على هذا النقل لصالح أصحاب المقطورات وسيارات النقل الكبيرة، فصارت مصر تقريبًا هي الأولى في العالم في حوادث الطرق. كانت القطارات تأتي إلى الأرصفة، التي بنيت منذ عصر إسماعيل باشا، حتى إن من بينها رصيفًا اسمه رصيف الباشا محملة بكل شيء. من القطن إلى الفول السوداني والبصل والثوم وغيره. كانت السقوف الصاج التي على شكل جمالون فيها أعشاش العصافير واليمام التي كنا نصطادها بالنبال، بينما نشاهد من معه بندقية صيد ونتمنى أن نكون مثله. أخذ حبي للقطارات مكانه في روايات كثيرة لي مثل «الصياد واليمام» و«المسافات» و«لا أحد ينام في الإسكندرية» و«طيور العنبر». انتقل هذا الحب إلى العالم، صرت حين أسافر إلى أوروبا، أو بلد عربي مثل تونس أو المغرب، أتنقل بين مدنه بالقطارات. كنت أعرف أني سأخرج بحكايات أو بشر.
من القطارات التي ركبتها قطار من موسكو إلى كييف في أوكرانيا منذ ثلاثين سنة. كانت رحلة ليلية. ما إن دخلت غرفة القطار التي كانت فيها أربعة أسرة، اثنان منهما مرفوعان فوق اثنين وكانت معي مستشرقة روسية وفتاة روسية لا أعرفها وقف يقبلها شاب روسي وانصرف بعد أن نظر إليّ. عاد بعد لحظات ومعه شاب روسي ليكون بدلًا من الفتاة الروسية، وعرفت من المستشرقة أن الشاب الروسي خشي على حبيبته مني، فاتفق مع شاب في عربة أخرى على أن يتبادل معها مكانه. ضحكت وقلت وكأني لم أغادر مصر. تركت الغرفة طول الليل وجلست في الطرقة الرفيعة بين الغرف وجانب القطار، حيث كانت فيها مقاعد صغيرة ملتصقة بالجدار يمكن فردها والجلوس عليها. جلست طول الليل أنظر إلى الجليد وأتذكر الليالي البيضاء لدوستويفسكي، فهذا هو ما يهمني، بل كان ذلك أملي ومصدر بهجتي أكثر من وجود فتاة معي في الغرفة.
قطار آخر ركبته ليلًا من ولاية رود آيلاند في أمريكا إلى شيكاغو عام 1996. بتنا فيه أيضًا لكن هنا لم يحدث ما حدث في روسيا. لم يكن الطريق مضاء بالجليد، لكن ظللت طول الليل مندهشًا من شاب أسمر يمسك في يده تمثالًا من الخشب رفيعًا جدًا وصغيرًا جدًا وينظر إليه يضحك ويبتسم. طول الليل ينظر إلى التمثال الذي كان من أعواد الخشب الرفيعة، لا يزيد طوله عن ثلاثين سنتيمترًا، ولا تعرف هل هو لذكر أم لأنثى. صارت مشكلتي في القطارات هي التدخين، فوجدت حلًا أن أحجز مقعدًا في العربة التي يُمنع فيها التدخين، وحين أدخن أنتقل لأقف في عربة مسموح فيها بالتدخين ثم أعود. انتهى ذلك منذ سنوات وصار التدخين ممنوعًا في كل القطارات ووجدتها فرصة طيبة. القطارات خارج مصر جاءت في سن متاخرة فلم تتحول إلى قصص كما حدث مع روايات سابقة فيها القطارات التي عشقتها منذ الطفولة. من أغرب القطارات التي ركبتها قطار الساعة الحادية عشرة صباحًا من القاهرة إلى الإسكندرية، صباح وفاة جمال عبدالناصر عام 1970. كنت في القاهرة حين عرفت خبر الوفاة وكان لا بد أن أعود إلى الإسكندرية. وجدت القطار خاليًا تمامًا ليس فيه غيري والكمسارية. راكب واحد هو أنا في كل عربات القطار، بينما كل القطارات تأتي إلى القاهرة أراها في الطريق محملة بالبشر داخلها، وعلى سطوحها قادمون لحضور جنازة عبدالناصر. لم تكن حوادث القطارات شيئًا يتردد في الصحف أو الحياة إلا نادرًا. لكنهم دمروا نقل البضائع في القطارات، ولم يهتموا بتطوير منظومة العمل فصارت الأحداث تتكرر بشكل كبير. صارت أعداد الضحايا كثيرة جدًا في السنوات الخمس عشر – الخمس عشر من فضلك – الأخيرة في عهد مبارك. سمعنا كثيرًا عن اهتمام الدولة بمنظومة السكة الحديد لكن لم تتوقف الحوادث وازدادت. وعلى رأي أحد الأصدقاء، كلما خرج قطار عن القضبان أحس قطار آخر بعد أسبوع بالغيرة وفعل مثله. كان من أغرب الحوادث منذ سنوات خروج قطار عن القضبان ونزوله إلى السوق في محافظة البحيرة، وتوقفه بعد اصطدامه بمحل عصير قصب. وكان من أغربها أيضًا خروج قطار من منطقة ورش القباري، دون سائق وظل يمشي حتى اصطدم بسيارات عند مزلقان منطقة سموحة فتوقف وحده. كانت غيرة هذا القطار أكثر من غيره، فخرج وحده دون سائق.
كان من أبشع الحوادث حادثة قطار العياط عام 2002. كنت يومها مسافرًا إلى فرنسا وركبت تاكسي في الصباح إلى المطار. في راديو التاكسي عرفت بالحادثة وكيف اشتعلت النيران في عربات القطار، وكان الخبر يقول إنه لا يوجد ضحايا. وصلت إلى باريس ودخلت الفندق فتحت التلفزيون لأعرف أن الضحايا أكثر من خمسمائة. كان القطار متجهًا من القاهرة إلى الصعيد، وغادر قرية العياط في الجيزة في طريقه إلى الجنوب. قبلها بحوالي سبع سنوات كنت عائدًا من الإسكندرية في العربة الأخيرة للقطار، فرأيت قطع الزلط تصعد عاليًا جوار النافذة، والناس تصرخ. لقد خرجت العربة عن القضبان. لم أصرخ واتجهت مسرعًا إلى الباب فتحته ونظرت فتأكد لي ذلك. مددت يدي إلى ذراع الإنذار وجذبته فتوقف السائق قبل أن تتسبب العربة في حدوث ذلك لعربات أخرى وينقلب القطار. لاحظت أن الحوادث تتكرر كثيرًا حول قرية العيّاط، حتى إني في جلسة مع صديق قلت ساخرًا: الحل يغيروا اسمها، فالعيّاط في مصر تعني البكّاء. في الشهر الماضي وحتى الآن ثلاث حوادث. الأولى كانت الأسوأ، حيث اصطدام بين قطارين وضحايا وجرحى. الأخريان كانتا خروجًا عن القضبان دون ضحايا والحمد لله. للأسف وأنا اكتب هذا المقال حملت الأخبار خروج قطار قرب مدينة طوخ عن القضبان، والمصابون مئة والقتلى أقل من عشرة حتى كتابة المقال. هل حقًا تشعر القطارات بالغيرة وتقوم هي بالحوادث. ألا توجد طريقة لإقناع القطارات أن تتوقف عن هذه الغيرة الحمقاء؟
المصدر: القدس العربي



