البحث العلمي في العالم العربي: أعمى في نفق مظلم
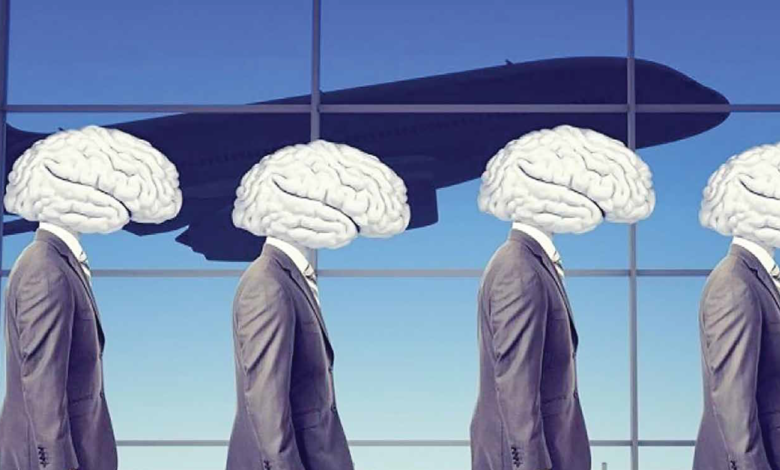
- الواسطة والمحسوبية والرشوة - 2021-11-02
- البحث العلمي في العالم العربي: أعمى في نفق مظلم - 2021-05-04
تعدّدت تعريفات البحث العلميّ، وتنوّعت حتّى بات من الصعب حصرها في تعريف واحد، فمعظمها ظلّت تلتقي في أنّه كناية عن دراسة مشكلة ما، والعمل على إيجاد حلول لها بالطرق العلميّة، أي محاولة الكشف عن معلومات جديدة تُساهم في تطوير المعارف الإنسانيّة وتوسيع آفاقها.
الكثيرون عرّفه على أنّه عبارة عن كلّ إنتاج فكري يحرّره الباحث أو الأستاذ المحاضر في موضوع من الموضوعات العلمية، المتمّثلة في فكرة جديدة، لم يُتطرّق لها من قبل، ويستوجب إيجاد حّل مناسب لها.
أو كذلك على أنّه أسلوب تقصٍّ دقيق، ومنظّم يسعى إلى اكتشاف الحقائق، والوصول إلى حلّ المشكلات عبر جمع الأدلّة والبيانات، والعمل على اختيارها علميًّا بقصد التحقّق من صحّتها، أو تعديلها، وإضافة معلومات جديدة لها، بغية التوّصل لنتائج معيّنة من خلال وضع النظريّات والقوانين المواتية لذلك.
إنّ البحث العلميّ، الذّي يشمل كلّ مناحي الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والعلميّة، يشّكل أحد أهمّ العوامل الأساسيّة لتقدّم المجتمعات، وسببًا من أسباب تقدّمها وتطوّرها في جميع مناحي الحياة
كما يعتبر أداة فعّالة، تسهم في تطوير المجتمعات وتقدّمها، ونشر الوعي والثقافة، إذ بقدر ما يرتبط البحث بالواقع المعاش، بقدر ما تزداد أهمّيّته، وتتجّلى قدرته على كشف الحقائق المبهمة.
إنّ البحث العلميّ، الذّي يشمل كلّ مناحي الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والعلميّة، يشّكل أحد أهمّ العوامل الأساسيّة لتقدّم المجتمعات، وسببًا من أسباب تقدّمها وتطوّرها في جميع مناحي الحياة. فهو المصدر الرئيس للتنمية، ورفاهيّة الشعوب، والركن الأساسيًّ الذّي تقوم عليه المعرفة البشريّة، وخير علاج لمواجهة المشكلات، خصوصًا في ظلّ ما يشهده هذا العالم من تطوّر مذهل في مجالات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات، والاتّصالات، مجالات ساهم ازدهارها في زيادة قوّة ورفاهيّة الدول المتقدّمة بامتياز.
قيمته تكمن فيما يتوّصل إليه من حلول ومقترحات مناسبة لحلّ المعضلات، وبلورة الأفكار العلميّة حيث المنفعة المادّيّة، والمعنويّة للمجتمعات من خلال تسريع خطى التنمية، وبالتالي خدمة المجتمع والفرد على حّد سواء.
من غير الجائز -إذن- أن يُنظر إلى البحث العلميّ على أنّه ترف علميّ، أو ذهنيّ، وهو العنصر الأساسيّ الذّي يدعم تقدّم الأمم والشعوب ويساهم في بناء مجدها العلمي الحضاري. إنّ البلد الذي لا يعير البحث العلميّ أيّة أهمية مصيره البقاء في الظلام إلى الأبد، وجدير به أن لا يصّنّف ضمن قائمة البلدان المتقدّمة الراقية.
نحن نعيش في زمن أيًًا كانت تسميته، لا تتحدّد مقومات البقاء والتميز فيه بالاقتصار على قوة السلاح أو امتلاك الثروة، وإنما تتحدّد قبل هذا وذاك بامتلاك مفاتيح المعرفة المشّكلة للقوّة الحقيقية بلا منازع، وكذا القدرة على إنتاجها وخلقها.
كما أنّ معيار الرّقي والتطوّر لم يعد يحسب باستدامة الرفاهية الاقتصادية والنمّو المتواصل للناتج المحلي الإجمالي، وإنما بالمخزون القومي المعرفي العلمي البحثي، لا غير.
نحن نعيش في زمن، أيًًا كانت تسميته، لا تتحدّد مقومات البقاء والتميز فيه بالاقتصار على قوة السلاح أو امتلاك الثروة، وإنما تتحدّد قبل هذا وذاك بامتلاك مفاتيح المعرفة المشّكلة للقوّة الحقيقية
من هنا أصبح لزامًا على أيّ باحث مجتهد، أن يوجّه اختياره لمواضيع ذات الفائدة، تلك التّي تهمّ المجتمع بالدرجة الأولى، وتقدّم خدمة معرفيّة وعلميّة للناس. فالمريض الذي يتألّم، بحاجة إلى طبيب يخفّف عنه الألم، ويقدّم له العلاج النافع، وليس إلى طبيب يفلسف له العلّة ويمنحه محاضرة عن تاريخ ظهورها وآليات تطوّرها ومدى خطورتها.
وما دام إنتاج المعرفة العلميّة يشّكل عصب التقدّم الحضاريّ، فلا بدّ له من أن يقوم على أسس وطيدة من ناحية الأمانة في البحث، والحذر، والتدقيق في تسجيل المعطيات والبيانات، واحترام جهد الآخرين، وإعطاء الفرصة للباحثين على اختلاف أجناسهم ومستوياتهم، وترك نتائج الأبحاث العلميّة متاحة لكّل طالب علم مجتهد، فضلًا عن تفادي سائر أشكال الانتحال، والخداع، والسطو، والسرقات العلميّة.
إنّ الدراسات، والأبحاث التي يكتبها الباحثون في جميع الاختصاصات تقدّم للإنسانيّة خدمات جليلة، بتسجيل آخر ما توصّل إليه الفكر الإنسانيّ في موضوع ما، وبالتّالي نشر الوعي وإثراء الرصيد العلمي للمجتمع بالمعلومات، التّي من شانها المساهمة في دفعه نحو الخروج من دائرة التخلف والتبعية، إلى فضاء التطوّر الفسيح، ومنحه فرصة مواكبة السباق الحضاريّ القائم بين الأمم.
وإذا نظرنا اليوم إلى البحوث العلميّة، نراها تميل إلى التخصّص، بمعنى أنّها تعالج المشكلة التي تتناولها، ثقافيّة، أو اقتصاديّة، أو اجتماعيّة أو غيرها، بأدقّ التفاصيل، وتبحث عن أسبابها، فتبيّن الصحيح من الخطأ، وتسعى للتوصّل إلى اكتشاف الجديد، الذّي من شانه تغيير الواقع المعاش للأفضل، وعلى كّافة الأصعدة.
إنّ التطوّرات الذّي تشهدها المجتمعات الإنسانيّة، عوامل تحّض الباحث أن ينطلق من حيث توقّف من سبقه حتّى لا يقع في التكرار وتضيع جهوده هباءً منثورًا، فهي ترشده إلى الوجهة السليمة، كي لا يحيد عن أهداف البحث العلمي الجّاد، فيتقيّد بشروطه وقوانينه، التّي ستؤدي به حتما إلى حّل المشكلات بطريقة نظاميّة، والاهتداء إلى ابتكارات جديدة، واختراعات حديثة في مجال التخصّص، وبالتّالي الحصول على نتائج يمكن تعميمها وتنفيذها باستعمال آليات مناسبة ومناهج مدروسة.
الحديث عن أزمة البحث العلمي في هذه البقعة، يعني بكل تأكيد الحديث عن أسباب التخلف العربي عن ركب الحضارة والنهضات العلمية المتلاحقة في دول العالم المتحضّر
بالنسبة للعالم العربي، الحديث عن أزمة البحث العلمي في هذه البقعة، يعني بكل تأكيد الحديث عن أسباب التخلف العربي، عن ركب الحضارة والنهضات العلمية المتلاحقة في دول العالم المتحضّر.
فمن غير المعقول أن نرى العالم من حولنا يحقق أرقامًا متقدمة في مجالات الإنفاق على البحث العلمي وبراءات الاختراعات واستثمار البحوث، في الوقت الذي يتراجع فيه بحثنا العلمي عامًا بعد عام، وإن تقدّم خطوة فإنه لا يواكب مئات الخطوات التي اجتازها الغرب.
هو واقع أليم مزرٍ لا يحتاج إلى تشخيص معمّق لمناقشة مشكلته القائمة منذ زمن طويل، بل إنّ حلّ معضلته يكمن في توّفر إرادة الفعل المنجز المحقّق على أرض الواقع، لا إرادة الكلام والمقالات والخطابات الجوفاء الرنّانة.
مشكلة تخلّف البحث العلمي العربي، ومتلازمة العراقيل والعوائق التّي ظلّت تلازمه، أسالت الكثير من الحبر، لكن لازلنا نلاحظ أن النتائج والتوصيات بقيت كما هي، وبقيت معها المشكلة قائمة تنتظر أن يُفصل فيها، أن تتحوّل خطب المؤتمرات واللّجان العلمية إلى تطبيق ملموس.
إنّ عالمنا العربي الكبير، الممتّدة رقعته من المحيط للخليج، لازال قابعًا في بؤرة التقليد والاستهلاك، يتباهى مسؤولوه، في وسائل الإعلام وباختلاف أنواعها، بعدد الجامعات المُدّشنة بداية كّل موسم جامعي، مشيدين بثراء مكتباتها ذات التصميم المعماري الفريد من نوعه، والتّي تزخر رفوفها بالمراجع الورقية والإلكترونية المستوردة من الخارج بأبهظ الأثمان، بالضبط كما تتباهى النسوة الحمقاوات بمجوهراتهنّ، وكثرة الألبسة الفاخرة التّي تحتويها خزائنهن.
الواقع العربي “العلمي” يجزم ويقسم، أنّ رجل السياسية في عالمنا العربي أفسد على رجل العلم حياته الأكاديمية، وإلاّ من المسؤول عن البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، والفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي الحكومية، إضافة إلى تدني أجور الباحثين، وبقاء كثير من مراكز البحوث العربية تحت رحمة قيادات سياسية قديمة مترهلة، غير مدركة لأبعاد التقدّم العالمي في ميادين البحث العلمي، لا سيّما في علوم التكنولوجيا والبيولوجيا.
إن المجتمعات العربية ما زالت غير قادرة على التعاطي مع إنتاج المعرفة على الوجه الكافي واللازم، بالرغم من مقوّماتها المادية المهدورة، من أجل ذلك فإن الدول العربية، ممثلة بوزارات التعليم العالي ومؤسساتها التعليمية، مطالبة اليوم بإعادة هيكلة البحث العلمي، بهدف رسم سياسات وطنية للبحث والتطوير، واتخاذ قرارات جريئة تجعل البحث العلمي مؤثرًا وفاعلًا في مختلف جوانب الحياة، تستند عليه العملية التعليمية في مجالات التدريس والتفكير الإبداعي والتواصل العلمي بين الباحثين، كأحد المؤشرات الأساسية الدّالة على رقي وتطور الجامعات المعتمِدة لمختلف الاستراتيجيات، في تشجيع الأساتذة على التأليف والنّشر العلمي بكّافة أشكاله وفي مختلف تخصّصاته.
لقد وصل حال كثير من مؤسسات البحث العلمي في العالم العربي، إلى تهميش الكوادر البحثية والنخب العلمية البارزة، ومن ثمّ دفعها للهجرة ومغادرة الوطن للاستقرار بأوربا وأمريكا، أين تجد البيئة العلمية المناسبة لها، المقدّرة والمثّمنة لمواهبها وقدراتها.
فالتقديرات تقول أنّ نسبة كبيرة لا يستهان بها، من علماء العالم ينحصرون في أمريكا وأوروبا واليابان، وهذا يعني أن نصيب البلدان النامية ـ والتي منها الدول العربية – من البحث العلمي لا يتعدى نسبة ضئيلة جدا، بينما حّظ الأسد من الأبحاث العلمية، فهو من نصيب الدوّل المتقدمة.
لقد وصل حال كثير من مؤسسات البحث العلمي في العالم العربي، إلى تهميش الكوادر البحثية والنخب العلمية البارزة، ومن ثمّ دفعها للهجرة ومغادرة الوطن للاستقرار بأوربا وأمريكا
إذا أردنا الحديث عن نهضة حقيقة للبحث العلمي في الوطن العربي، فهناك عدّة نقاط أساسية يجب تفعيلها والأخذ بها لإنجاح دينامكيته في البقعة العربية، نذكر منها زيادة الدعم المالي لمؤسسات البحث العلمي، والسّعي من أجل إقامة علاقة متينة بين مؤسسّات العلمية المختّصة والتكامل بينهما، مع وجوب الاستقلالية لكل منهما، وسنّ قانون يتيح للجامعات أن تستثمر بحوثها بإقامة شركات حاضنة مستقلة، وتحرير مؤسسات البحث العلمي من روتين السيّاسات الحكومية المقيّدة لحريّاتها العلمية، الجاثمة على عقولها، المسيطرة على تدّفق شلال أفكارها وقدرتها على الابتكار والإبداع.
كما يستوجب في هكذا مضمار تحسين وتيسير التواصل بين قطاع البحث العلمي والمنشآت الصناعية، بتفعيل العلاقات بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، سعيًا وراء حلّ مسائل بحثية محددّة، مع وجوب الاستفادة من الأعمال البحثية والتعليمية لتحسين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التواصل بين الباحثين والمنشآت الصناعية، ومنح صلاحيات مناسبة تمّكن الباحثين من الاستفادة المباشرة من أعمال وبرامج المنشآت الصناعية، والعمل على استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية من نفوذ السلطة، وإعطاء الحرية الكاملة للمؤسسة العلمية في رسم سياساتها وبرامجها، وتعيين من تشاء في سُلمها الوظيفي.
في خضم المعركة العالمية الدائر رحاها في المخابر العلمية من أجل إيجاد لقاح لمرض فايروس كورونا المستجد، نجد معظم مراكز الأبحاث العلمية العربية، وبكّل أسف، بعيدة كّل البعد عن السّباق.
و إن وُجِدَ البعض منها في غمار المعركة التّي شّنّت ضّد الفيروس التاجي، فهو حضور محتشم مقارنة بالعدد الكبير من المخابر والهيئات البحثية، لدول أوروبا وأمريكا وغيرهما من الدّول المتقدّمة.
لقد بات من المخجل، أن تحدّد منظمة الصحة العالمية أكثر من أربعين لقاحًا مرّشحة للاستخدام التجريبي السريري، ولا توجد أي دولة عربية مشاركة ولو بمحلول طبيعي لتنمية الفيروسات، في هكذا مضمار.
لقد بات من المخجل، أن تحدّد منظمة الصحة العالمية أكثر من أربعين لقاحًا مرّشحة للاستخدام التجريبي السريري، ولا توجد أي دولة عربية مشاركة ولو بمحلول طبيعي لتنمية الفيروسات، في هكذا مضمار
إذ بالرغم من التدابير الآنية التي اعتمدتها العديد من الدول العربية في سبيل وقف انتشار الجائحة، فالوباء كشف عن ضعف كبير في البنيات التحتية المتعلقة بالقطاع الصحي، كما أبرز غياب إستراتيجية مستقبلية للتعاطي مع هكذا حالات وبائية، بشكل يجعلها قادرة على تحويل الكارثة إلى فرصة للإبداع والاجتهاد.
إنّ أغلبية المحاولات، التي أجرتها مراكز بحثية عربية، لمعاضدة المجهود الدولي في المجال البحثي بغية تحقيق نتائج تخدم البشرية وتنقذ حياة الأشخاص من شراسة الفيروس المستّجد، إلا أنها ظلّت مجرد مساع لم تأتِ بنتائج مهمة، ولم تتوّصل حتّى لأية نتيجة مرضية في هكذا مجال، بسبب وضع مخزٍ للبحث العربي، شكّل وصمة عار في جبين المنظومة البحثية العلمية العربية.
وعلى الرغم من بعض التقدم الذي تم إحرازه على مستوى إحداث المعاهد والمخابر والجامعات، وتزايد طفيف في الإنتاج العلمي، وتضاعف عدد العلماء والمهندسين في المنطقة العربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلاّ أنّ الوضع ما زال دون المستوى ودون المعدّلات الدولية في هذا المجال.
لقد كشفت أزمة كورونا عن أهمية البحث العلمي، وحيوية الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي الكفيل بتحويل الأزمات والمخاطر إلى محطّات لاستخلاص النتائج، وإرساء الاستراتيجيات الكفيلة بتحصين المستقبل، كما بيّنت أنه يترتّب على الكثير من الدول العربية المسارعة إلى تطوير منظومتها العلمية، في أسرع وقت ممكن، وقبل فوات الأوان.
لقد وضعت أزمة كورونا صانعي القرار، داخل عدد من دول العالم تحت ضغط غير مسبوق، وشكّلت بذلك منعرجًا هامّا في تاريخ البشرية، يمكن الخروج منه وتجاوزه بعدد من الدروس، وعلى رأسها الاستثمار في البحث العلمي، والمراهنة عليه كأساس لتحقيق التنمية، ومواجهة كل التحديات والمخاطر بقدر من الثقة.
لقد أشارت إحدى التقارير إلى أن المعلومات المتاحة حول نتاج منظومات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان العربية، من حيث التقارير العلمية المنشورة أو البراءات المودعة والممنوحة، تظلّ ضعيفة جدّا كمّيا ونوعيا، مقارنة بنتاج البلدان المتقدّمة، حيث نبّه أحد الباحثين إلى أن الفجوة المعرفية بين الدول العربية ودول العالم المتقدّم، تتضاعف كل ثمانية عشر شهرًا، بعد أن كانت تتضاعف كل ستّ سنوات في الثمانينيات من القرن المنصرم.
إنّ طبيعة التحدّيات التي تواجه الوطن العربيّ اليوم تختلف كثيرًا عمّا كانت عليه في السابق، لأنّ حكومات البلدان العربيّة الحديثة التي نالت استقلالها بعد النصف الثاني من القرن العشرين عملت على توسيع نظام التعليم، كان من نتائجه تخرّج الملايين من العرب من الجامعات العربيّة بينهم العديد من المهندسين والعلماء، لكنّ هذه الكفاءات العلميّة تبقى عاجزة عن تحسين الحال الوطنيّ من خلال تعزيز الثقافة السياسيّة عبر تشكيل منظومات وطنيّة علمية، أو توظيف قدرة الحكومات على تبنّي سياسات بحثٍ علمي قويّة فعّالة.
تبقى أبرز هذه تحدّيات تتمثّل في الثقافة، فإذا لم يتمكّن العرب من التمسّك بماضيهم، واستعادة تلاحمهم السياسيّ، والاقتصاديّ المفقود، سوف يصعب عليهم البقاء كمجتمع متلاحم مع حضارته الخاصّة.
ومن هنا يبرز دور البحث العلميّ في مسألة التغيير في المجتمع، والجماعة المبدعة والناشطة علميًّا، الوحيدة القادرة على مساعدة مجتمعها للدخول في عمليّة حكيمة تؤدّي إلى المشاركة الجماعيّة في النسيج المجتمعي عبر مؤسّساته المدنيّة.
وأمام هذه التحدّيات الخطيرة التي يواجهها العرب، لا بدّ من دعم البحث العلميّ، بهدف الابتكار والتغيير، كما أنّه لا بدّ من أن يتّخذ المسؤولون موقفًا جديًّا حيال هذه التحدّيات من أجل توفير الدعم اللازم له، بإيلائه اهتمامًا أكبر عبر توفير مستلزماته، بغية التمكن من ردم الهُوّة المعرفيّة والتكنولوجيّة بين البلدان العربيّة والبلدان المتقدّمة، تفاديًا لمكوث البلدان العربيّة تحت وطأة تبعية علمية وثقافيّة، يصعب التخلّص من سيطرتهما فيما بعد.
ومن هنا تتضّح أهمّيّة وضرورة السّعي إلى تأمين كلّ المستلزمات في سبيل تطوير البحث العلمي العربي، ودفع عجلته في المسار الصحيح، وإعداد الباحثين المتخصّصين القادرين على مواصلة الارتقاء إلى شتى أنواع المعارف بطرق أكاديمية حديثة، وخلق أجيال من الأساتذة الجامعيّين، وبالتالي من الباحثين، فالبحث العلميّ يقوم على تربية القدرة على التفكير والملاحظة العلميّة، وهي كلّها قدرات لا تتوفّر إلاّ بتوفّر حبّ البحث وتقّصي آثار المعرفة في شتى ميادين الحياة.
فمن غير المقبول والمعقول، أن يظّل عالمنا العربيّ بعيدًا عن أسباب التطوّر، تصرفه عن ذلك صراعات عبثيّة لا طائل منها سوى تراجع المواطن العربيّ للوراء، وجعله أكثر تخلّفًا.
إنّ قمع الشّعب الفلسطيني، والتهديدات العسكريّة الممارسة ضّد الدّول المستضعفة، وفرض العقوبات ضدّ الدول العربيّة المتمّسكة بموقفها الممانع للخضوع والسيطرة، وحروب الصومال التّي لا تنتهي، والصراع القائم في سوريا، وحرب ليبيا، والإنزلاقات الأمنية في العراق، كلّها أمور مأساوية، يجب أن تشّكل حافزًا قويًّا للتغلّب على العقبات التي تمنعنا من فرض وجودنا بين الدّول التّي فرضت هيمنتها علينا، وذلك بما تمتلكه من قوّة وعلم وأبحاث، وتكوين قاعدة علمية عربية خاصة بنا، تدعم جهودنا للرّقي برصيدنا العلمي لمرتبة البلدان المتقدّمة.
أما آن الأوان أنّ ننهض بالبحث العلميّ عوض أن يبقى مهملًا، ونعمل على تأمين مقوّمات نجاحه لتحقيق رفاهيّة الشعوب العربيّة؟
أما آن الأوان كي نعتمد البحث العلميّ الموجّه، والذي يعالج قضايا يعاني منها الوطن العربيّ لا سيّما الغذاء، ومصادر الطاقة، وإدارة الموارد الطبيعيّة، والتصحّر الناتج عن التغيّر المُناخي، وتكنولوجيا المعلومات، والاتّصالات، والأمراض التي تؤذي الثروة الحيوانيّة والنباتيّة، وغيرها من الأمور التي تؤذي البيئة، وتؤثّر على السيرورة الطبيعية لحياة الشعوب العربيّة؟
تظّل الأسئلة مطروحة، إلى أن يستفيق من بيدهم القرار الحاسم من غيبوبتهم، ويعملوا على وضع أسس متينة لإستراتيجيّة عربيّة لمواجهة التحدّيات التّي ظلّت تقف عائقًا أمام أي تطوّر علمي، يرقى بالشعوب العربية، ويثمر عن ثراء معرفي يسهم في التثقيف والنماء الفكريّ، وكذا في بناء بيئة بحثيّة غنيّة بالمصادر المعرفيّة، وداعمة للإبداع العلمي، تعمل على الحدّ من هجرة الكفاءات العلميّة، والاهتمام بالباحثين عبر تقديم الحوافز المادّيّة، والمعنويّة، ووضع خطّة تعاون بين الجامعات في الوطن العربيّ، مع دفع عجلة البحث العلميّ في المسار الصحيح، الذّي يسهل إتباعه والسير عليه، لتحقيق النجاح العلمي الأمثل.
مجلة الجسرة الثقافية – العدد 57 – شتاء 2021




