خطيئة الكُتَّاب
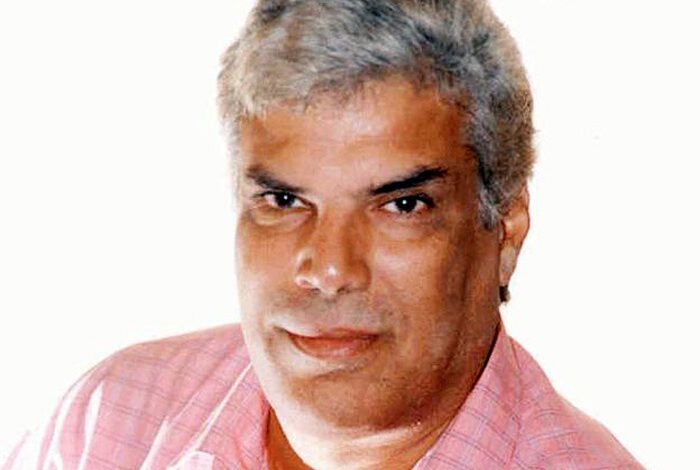
- اعتذار للمتنبي - 2024-04-11
- أوديب في الطائرة - 2024-03-14
- حوارات صحفية ولكن.. - 2024-02-24
هل للكُتَّاب خطيئة؟ نعم. والعجيب أنهم لا يدركونها. هل يمكن أن توجزها في كلمة أو جملة؟ الإجابة هي عدم التوافق مع المجتمع. كيف لا يدركونها؟ لأن الكتابة ليست فعلهم، هي قدرهم أو نتاج موهبتهم. أقصد هنا بالكتاب المبدعين وليس المفكرين. المفكرون على وعي بما يفعلون. وعي تام فهم يكتبون عن أفكار يمكن الاتفاق أو الاختلاف معها، بينما الإبداع يمكن الإعجاب أو عدم الإعجاب به. بمعنى أنه ابن النفس البشرية أو الروح، ليكون الأمر أكثر وضوحًا، فكلما اكتمل رسم الشخصية رأيتها أمامك. بينما الفكر ابن العقل تفهمه ولا تراه. الفارق بين العمل الأدبي الرديء والجيد هو اختفاء الروح وظهور العقل، لأن العقل يمكن أن يجعل الكاتب يرسم شخصيته الشريرة بطريقة تجعلك تكرهها، بينما الروح تجعلها شخصية فنية تحبها. تحبها هي ولا تحب الشر. تندهش منها وتنصرف عنها ما دمت قارئًا، إلى شخصيات أخرى أجمل فنيًا، شريرة أو فاضلة. هل كره أحد فاوست الشيطان كشخصية فنية رغم كراهية الناس للشيطان؟ هل كره أحد محمود مرسي كفنان بعد أن شاهد فيلم شيء من الخوف، وهل فعل مثله أحد إلا الأشرار من الأصل لا من القراءة. أما لماذا لا يتوافق المبدعون مع المجتمع فلأنهم يشعرون بما لا يشعر الآخرون. فمهما كانت الإنجازات حولهم في كل مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية طيبة، يرون العالم غير مكتمل. أدرك ذلك أفلاطون مبكرًا فجعل مدينته الفاضلة خالية من الشعراء، لأنهم حتى في الجنة كما يتصورها لن يجدوها مكتملة. هل يقصد الكاتب ذلك؟ لا طبعًا. هو مفعول به، فالموهبة تجعله في قلب العاصفة يلوذ مثل قطة بجدار، ويكتب منصرفًا عما حوله، وكما يمكن أن تداهم القطة سيارة، يمكن أن يداهمه مدعٍ بارتكاب الآثام، ما دام في البلاد حُكم شمولي يضع خطوطًا حمراء وخطوطًا بيضاء لكل شيء، دون إدراك أن الإبداع لا يقف عند الخطوط البيضاء، فالطبيعي للبشر ولكل نظم الحكم أن تقوم بعملها، لكن الخطوط الحمراء هي ما يُشعل روح المبدع. كل الدول التي وضعت هذه الخطوط الحمراء مثل ألمانيا النازية أو إيطاليا الفاشية أو روسيا والصين الشيوعية، غادرها العدد الأكبر من المبدعين في الأدب والفن إلى أوروبا وأميركا، وتوقف آخرون عن الكتابة أو انتحروا، أو كتبوا ولم ينشروا أعمالهم، انتظارًا ليوم أجمل تتسع فيه الحياة، والذين كتبوا كانوا في معظمهم من متوسطي الموهبة لم تصمد أعمالهم للزمن. هل يقصد المبدع أن يفعل ذلك؟ لا. لأنه إذا قصد يكون قد أدخل العقل ليحثه أن يفعل ذلك، لتتم محاكمته ويزداد شهرة. والذي يفعل ذلك بإرادته، عادة يكون أقل موهبة، باحثا عن الشهرة، لا متعة الكتابة. عدم التوافق مع المجتمع أو الخروج على المألوف أمر يتصل بالمشاعر المرهفة. المبدعون يصل بهم عدم التوافق مع المجتمع إلى درجة أنهم يرون الحياة هي شخصيات رواياتهم، أو قصائدهم عن الأرض الخراب. ورجال ونساء حياتهم، هم شخوص الرواية، وبعض الكتاب يبحثون عنهم في الطرقات، كما يحدث معي دون قصد، وأكتشف ذلك بعد أن أفعله. الشخصيات هي من يعيش معها الكاتب معظم وقته، إن لم يكن كله وهو يكتب، لدرجة أنه كثيرا ما ينادي من يقابلهم من شخوص الحياة بأسماء شخوصه، ويتسبب الأمر كثيرا في الضحك. أحيانا ينتبه الكاتب إلى ذلك قبل أن يفعله، ويكون سبب الانتباه أنه جالس في مكان عام مثل المقهى مع آخرين ويتحدثون في أمور الحياة الواقعية، لكنه ما إن يعود إلى نفسه، حتى تعيده شخصياته إلى عالمها. المدهش أن المبدع كلما توحَّد بعالمه إذا عاد إلى ماحوله يراه يزداد خرابا عن ذي قبل، وكأن في الكون قوة تدفعه أن يظل غريبا. لذلك لا تسمع من المبدعين عادة أيّ كلمة رضا عما حولهم، كأنهم يتفاجأون به. يمكن جدا ويحدث، أن يكتب المبدع عن شارع مليئ بكل الموبقات، لكن الصدق الفني يجعلك تحب الشارع، الذي إذا مشيت فيه حقيقة ستكرهه، وتسخط على المحافظين الذين تركوه هكذا لا علي الكاتب. بينما يفعل المبدع ذلك، فالعقل يدخل في فهمه لتاريخ الأدب والفن، وكيف تطورت الأشكال الأدبية والفنية، وهنا يحاول أن يبني بيته الخاص بينها، بيت جديد، أوبيت فوق القديم بشكل فيه اختلاف. تحكم المبدع في ذلك أشياء أخري مثل اللغة، التي حين تخرج من عقله لتتماهي مع الشخصية، تصبح كالسحر ويسأل القارئ نفسه، كيف تكون لغة الشخصيات مختلفة الإيقاع هكذا؟ ولماذا لا تكون كلها بلغة الكاتب نفسه؟ والجواب أن التوحد بين الكاتب وشخصياته هو من يفعل ذلك، ومن هنا، من عدم فهم ذلك، يأتي من يتصورون أنهم عقلاء الأمة، ليقولوا كيف يستخدم كاتب هذه الألفاظ، ناسين أن الذي استخدمها هم شخصياته، وهم من أجبروه في حالة التوحد معهم، أن يفعل ذلك. السيناتور جوزيف مكارثي في أمريكا في بداية خمسينات القرن الماضي، وضع للكتابة خطوطا حمراء، فترك له الكتاب والفنانون البلاد، ومنهم ويا للعجب شارلي شابلن، لأنه سيادته، مكارثي، اتهمهم بالشيوعية، ونسي أن شارلي شابلن هو صاحب أجمل فيلم عن الديكتاتور هتلر وكذلك غادر اميركا هنري ميللر وهو الذي تحفل رواياته بالجنس، والألفاظ والمسميات الجنسية التي كثيرا ما تكون فجة في وضوحها، والتي لا تحبها الكتابة فى الدول الشيوعية ذاتها، أو ليست من الخطوط البيضاء هناك. عقل المبدع يمكن أن يظهر في بداية الكتابة، لكن ما أن يبدأ فيها حتى تكون الروح والشخوص هي التي تمشي به. المبدع لن يضع على لسان العاهرة ألفاظا لا تتسق معها، فلو فعل ذلك خسر كثيرا من الصدق الفني. هذا يعرفه الكتاب، وهنا يأتي العقل قبل الكتابة في شكل نيّة وتأهب، أو بعد الكتابة في شكل مراجعة ليزداد الصدق الفني بحذف ما لايتناسب مع الشخصية لا مع المجتمع، لكن ما يهمني أن أحدا ممن ينكر ذلك على الكاتب، لايدرك معني الكتابة، فيقيم له المحاكمة، ولاينظر أحد خلفه، ليري أن كل المحاكمات للكتاب، أو منع والهجوم علي أعمالهم، فلوبير بعد مدام بوفاري، أو مثل ديفيد هربرت لورانس بعد عشيق الليدي تشاترلي أو مثل بودلير أو نجيب محفوظ بعد أولاد حارتنا، وكثيرون جدا، سواء كانت المحاكمة في المحاكم أو في الصحف والرأي العام، قد انتشرت أعمالهم باتساع مع الزمن، وصارت الأكثر رواجا. كما لايدرك ذلك الآن هواة المحاكمة وهواة الميديا معا، فتنتشر الأعمال على الميديا بسرعة رهيبة، ويدخل عليها القراء بالآلاف يصلون إلى ملايين أحيانا. لايدرك أصحاب الخطوط الحمراء أنهم يروجون لما يتصورون انه سيئ. المبدع وهو يفعل ذلك، يجد نفسه دون أن يدرك، في منطقة الرفض، ومن ثم منطقة النبوءات التي لا يكتشفها إلا بعد حدوثها. من أين يأتي ذلك؟ يأتي لأن كل كاتب ينشد عالما أجمل، فنيا من فضلك، فشخوصه وأحداثه لا تمرعليك وتنساها في لحظتها، بل تستقر في روحك ولو بعض الوقت. وربما إلى الأبد. الصدق الفني والمعرفة الخفية بالواقع، التى هي الإحساس، تجعله أحيانا يصدح بما يمكن أن يأتي، لكنه عادة لا يكون على دراية بذلك. الكاتب ليس عرّافا لكنه مستشرف وتسبق مشاعره ما حولها. يوما ما بعد حرب الكويت الأولي، جاءني كاتب شاب يحمل روايتي ” بيت الياسمين” مندهشا جدا، وكانت قد صدرت عام 1986، ويطلعني على صفحة يقول فيها أحد الشخوص لزميلة “حتقوم حرب في الكويت والبترول يولع “. كان ذلك قبل غزو الكويت بخمس سنوات. كيف كتبت ذلك؟ ببساطة لأن شخصا يحلم أن يسافر إلى الكويت، ولا يكف عن الكلام عن رغبته ومعاناته هنا، حتى زهق منه أحد أبطال الرواية وقال له، كف عن الحديث ستقوم حرب في الكويت والبترول يولع!. لم يكن هذا تنبؤا لكنه الشخصية الأخري أمام إلحاح من يريد السفر، يقول له ذلك ليستريح من حديثه .عام 1992 كنت أنشر روايتي القصيرة “قناديل البحر” مسلسلة في مجلة نصف الدنيا، وكنت أعطيتها لهم بخط يدي وأذهب كل أسبوع أراجع البروفة بنفسي. يوما ما وأنا اصعد السلم إلى المجلة، وكانت في مبني صغير غير الموجود الآن، حدث الزلزال الشهير، ورأيت الكل يفرّ إلى الشارع ففعلت مثلهم. في اليوم التالي ذهبت لأراجع البروفة، فوجدت مونولوجا لبطل الرواية يقول فيه ” هذه البلاد التي تسمي مصر، والتي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، سوف تتعرض لحركات تكتونية عنيفة، تهز الأرض والجبال ” اندهشت جدا لأن الحركات التكتونية هي الزلازل والتغيرات العنيفة في الأرض. وببساطة أدركت أن مونولوج البطل لأنه يشعر بالاغتراب الشديد، فهو مقاتل من حرب أكتوبر يري الأمور تمشي عكس ما كانوا يتوقعون من رغد وعيش كريم. الصدق الفني هو الذي كان وراء مونولوج البطل. قبل ذلك بكثير وفي عام 1975نشرت قصة قصيرة بمجلة الطليعة بعنوان ” تعليقات من الحرب ” فيها جنديان محاصران بالجيش الثالث يتحدثان بالليل، عما فعله الجيش من بطولات فقال أحدهما ” بعد أن تنتهي الحرب ونعود إلى بلادنا سيأتي مقاولون وتجار خردة يفوزون بكل شيء ” وهذا ماحدث. كنت أعرف سياسة الرئيس السادات وأفهمها فقط لا غير. بعد ذلك نشرت رواية “في كل أسبوع يوم جمعة” عام 2009 قبل الثورة بعامين، وكان يوم الجمعة في الرواية يوم النهايات والبدايات والكل يعرف كيف كانت أيام الجمع في وقت الثوة وبعدها. كان سبب الاختيار هو أن يوم الجمعة في تراثنا يوم للنهايات والبدايات. توافق الأمر مع ثورة يناير، لكني كنت متوافقا في الكتابة مع المعني التراثي لليوم. الكتّاب لا يقصدون التنبؤ لكنه الصدق الفني، وصدق الشعور بما يكتبون، وخوفهم من الظلام وحنينهم إلى النور، يأتي بالنبوءات التي لا يعرفها الكاتب إلا بعد أن تحدث. لقد قلت مرة ضاحكا في إحدي الندوات أني كتبت رواية “لا أحد ينام في الإسكندرية ” حتى إذا وقعت نبوءة ما تقع بعيدا عنا هناك في الأربعينات أثناء الحرب العالمية الثانية. حين كتب أمل دنقل قصيدته كلمات سبارتاكوس الاخيرة قبل النكسة وكتب فيها محذرا من صيف قد يأتي مدمرا كل شيء أجمعت الدنيا بعد النكسة انه كان يتنبأ بها. هو نفسه لم يكن يدري ولا أي كاتب. هو كان يوجه انذارا بروحه الرافضة للظلم لأن المبدع أكثر غضبا مما حوله ومن ثم أكثر رؤية للأخطار القادمة. إنه لا يتعامل بالمنطق العقلاني رغم ثقافته، لكنها المشاعر التي تصل به إلى ماهو مطلق وغير نسبي. وتستطيع ان تمشي في ذلك مع كل من قيل عنه أو قال هو عن نفسه أنه تنبأء بكذا. المبدع الذي يتنبأ، وعادة تكون النبوءة بالكوراث والأحداث الكبري، لماذا اذا كان عرافا لايتنبأ بشيء طيب، ولماذا لايدرك ذلك فيعلنه مبكرا في أحاديثه؟ لأنه ببساطة ليس عرافا بقدر ما لا يري ماحوله طيبا ومن ثم تأتي نبوءاته متشائمة. المبدع الذي تحاكمه السلطات عن ذلك، لا تدرك انه يمكن حين يسمع نداء الفجر والدنيا صامته حوله، أن يبكي ويتمني الصعود إلى السماء بلا عودة. يتعاملون معه كأنه نجار يعرف ما يفعل، ويطلبون منه أن يصنع لهم كنبة تتسع لهم جميعا، هم الذين أخفوا المقاعد عن الناس. لا ألوم أحدا فالمشكلة ستظل، خاصة في بلاد كالتي ذكرناها وشعارات من نوع الحفاظ على القيم وغير ذلك، كأن المبدعون مدرسون تربية وطنية. الأدب يتوحد مع لحظات الضعف للشخوص، وكثيرا ما تكون القوة حبلا يلتف على عنق الشخصية. الخطأ او الخطيئة التي يراها من يضعون أنفسهم حماة للقيم كما يقولون قدر الكتاب. لم يكن الرضا أبدا منجما للإبداع. حتى أن كثيرا من المبدعين، وهم لايدرون أنهم غير راضين، قد ينتحرون يوما، أو يتركون أنفسهم في الحياة، إلى ما يهلكهم مبكرا. فالإبداع وحده رغم جماله لايكفيهم. المنتحرون بالعشرات إن لم يكن المئات حول العالم من الفنانين والكتاب. لقد امتد عدم الرضا للمبدع إلى نفسه، والوصول إلى نقطة أن هذا العالم لايستحق الحياة. ألا تكفي تجارب الأمم حتى ينصرف رعاة ما يسمي بالقيم إلى الحياة نفسها لتكون أفضل. أن يكون هناك تعليم وصحة أفضل للناس مثلا. لقد غاليت في قولي بالخطيئة لكني ركبت أعلي موجة للانتقاد، ولم يكن ذلك إلا لأنها مقررة سلفا، لا يستطيع المبدع أن يتخلص منها، لانه في اللحظة التي يفكر فيها أن يكون متوائما مع الشعارات الجوفاء، سينتج عملا رديئا فيه من العقل أكثر مما فيه من الروح. الفارق أن الخطيئة المقررة سلفا هنا، لن تكون مثل خطايا الأساطير سببا في الوباء يحل بالبلاد. لقد كانت خطيئة أوديب مقررة سلفا، وحل بعدها الوباء بطيبة، لأن أوديب لم يكن اديبا ولا فنانا. كان حاكما ارتكب الخطايا. قتل أباه وتزوج أمه وهو لايدري. ورغم أنه فعل ذلك دون إرادة منه إلا أن الوباء حل بطيبة. المبدع ليس حاكما ولن يكون، فجمهوريته أو مملكته كلها من اشخاص افتراضية غير حقيقية، قد يتجمعون حوله في المساء سعداء، أو هو يتمني أن يحدث ذلك، لكن حتى هذا لا يحدث ويظل وحيدا. يزداد اغترابه بما يكتب أكثر من تدهور الأحوال حوله، فهو لاينتظر إصلاحا من الأصل. لا أذكر من من الكتاب، أظنه أرنست فيشر إن لم تخني الذاكرة، قد كتب يوما معلقا علي أحلام الشيوعيين في الاتحاد السوفييتي، انهم حين ينجحون ويحل العدل لن تكون هناك حاجة للرواية، والذي حدث أنهم لم ينجحوا وانفجرت الروايات خارج وداخل الاتحاد السوفييتي، وانتهي الاتحاد السوفييتي نفسه، وبالمناسبة لن ينجح أحد في أي مكان لاقامة المدينة الفاضلة التي تنتهي معها الرويات أو الشعر فالسياسة فن الممكن. المدهش أن من جعلوا الناس تفكر في الآلهة والأديان التي يدافع بها البعض عن هجومه على الإبداع هم الفنانين أنفسهم ولا أحد يتذكر. هم المبدعون. تخيل أنه دون رسومات على الجدران للإنسان القديم عن الآلهة والأساطير الني نسجها، ودوّن بها الملاحم التي كانوا يحكونها في البلاد في كتب، هل كان أحد سيعرف بوجود الآلهة. حتى الكتب السماوية التي جاءت تحمل كثيرا من هذه القصص دوّنها الانسان في كتاب. تخيل لو أنه لم يدونها ماذا كان يمكن أن يحدث. وفي أي مكان كانت ستسقر الأديان.
المصدر: أخبار الأدب



