أنطون تشيكوف.. الأديب الروسي
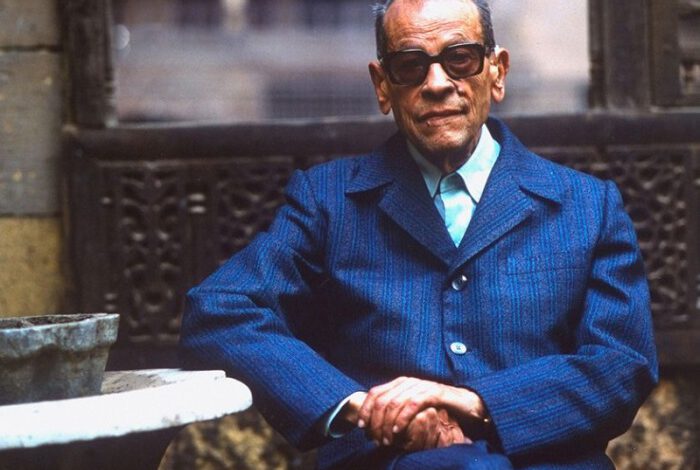
- أنطون تشيكوف.. الأديب الروسي - 2021-08-01
- احتضارُ معتقدات وتَوَلُّدُ معتقدات - 2021-06-11
- ثلاثة من أدبائنا - 2021-04-19
في 19 يناير سنة 1860 ولد أنطون تشيكوف ببلدة تاجازوج في أسرة فقيرة تافهة التاريخ، إذ كان جده عبدا لأحد الموسرين وقد اشترى حريته بما وفره من مال سيده، ونشأ ابنه (والد أنطون) مقتصدا مدبرا فاستطاع أن يترقى في وقت قصير من كاتب حقير الى صاحب حانوت وعميد أسرة مكونة من أربعة أخوة وأخت واحدة، وكانت الأسرة محافظة شديدة المحافظة، عظيمة الرعاية للتقاليد الدينية، فتلقى الأطفال تربية دينية عن الأب وعن الأم، وفى البيت وفى الكنيسة وبلغ من شدة غرام الوالد بموسيقى الكنيسة أن ألحق أطفاله جميعا بزمرة. اختلطت أصواتهم الرفيعة وهى تنشد الأناشيد الدينية، على أن هذه التربية الدينية وما بذل في سبيلها من شدة وعناية لم تأت إلا بعكس ما رجى منها، وقد كتب أنطون في كهولته يقول «عندما أستعيد ذكرى طفولتي، تبدو في مخيلتي مروعة، لما كنت أغنى وأخوتى في الكنيسة كان الناس يلقون علينا نظرات إعجاب ويثنوا على والدينا، ولكن كان يجرح نفوسنا إحساس ذلة كأننا من عبيد السفن الصغار»، ولكن هذه النشأة لم تضع هباء لأن الترتيلات الجميلة نقشت آثارا خالدة في نفس تشيكوف وأشربت قلبه بالهيام بها مما كانت نتيجته ميل الفتى الى اللغة الروسية واهتمامه بها.
ولما شب قليلا التحق بمدرسة الأبرشية وهنالك كابد مدرسا شديد القسوة ضحل الفطنة والمعرفة، بما أضاع عليه هذا العهد السعيد، وربطه في ذاكرته بالجفاف والفقر، وجعله يكرر دائما أنه ليس له طفولة!
ثم التحق بمدرسة الأجرومية، وفى باديء عهده بها عرف بالكسل والغباء وإن كان حبيبا الى النفوس، فذلك لنأيه بنفسه عن ميدان المنافسة ولابتسامة ساحرة لا تفارق شفتيه، إلا أنه في أواخر عهده بهذه المدرسة حدث انقلاب في نفس الفتي، فقد زال خموله وانفض عنه الكسل وصقل مخه وانحسر عنه الغباء، وتدفق في عروقه دم النشاط والحيوية من غير أن يسلبه ذلك روح الفكاهة فبقى مرحا يقرأ الروايات بصوت مرتفع حتى يثير الضحك في الصدور، ويغير من صوته، ويحاكى مختلف الأصوات، ويبدل من ملامح وجهه حتى لا يكاد يعرف، واخوانه من حوله يدهشون ويسرون.
ثم كان أن التحق بمدرسة الطب، وكان أن عبس الحظ لأبيه فهوى الى قرار الخراب حتى اضطر الى العمل ككاتب بسيط ولكنه يكف الأسرة بما اضطر معه الفتى أن يعمل لينقذ الأسرة من الموت جوعا، وفى الحق لقد كانت هذه الفترة من حياة الأديب من أشق ما عاناه في حياته، فهو طالب طب وأنت تدرى ما يقوم به طالب الطب من واجبات شاقة، وهو كاتب قصصى يؤلف لتسلية القراء بعد الغذاء، وأنت تعلم ما يعانيه الكاتب اذا كان دافعه الى الكتابة التكسب وسد العوز لا الإلهام والحب، ثم إنه يعيش في حى حقير تختلط ضوضاء الأطفال بصراخ الفتيان ـ مثل هذه الحياة أقرب الى الفناء والعدم لأننا لا نتذوق جمال الوجود ونحس بالحياة إلا في الساعات التي نقف فيها قليلا لنتأمل ونتملي، وكان يعلم أن أدبه غث وقد حاول أن يكتب كما يريد ويتمنى ولكنه لم يلق تشجيعا ما.
وأخيرا رضيت الحياة أن ترفع عنه بعض أثقالها، فنال دبلوم الطب والتحق باحد المستشفيات للتمرين، ولأول مرة أتيح له التعرف الى لون من ألوان الحياة وهو الحياة الريفية واختلط بكثير من الريفيين والضباط ما كان له كبير الأثر في خياله فيما بعد، ثم طلبه مدير جريدة نوفوفريميا ليكتب له قصصا محترمة ولعله سر غاية السرور لتخلصه من كتابة هذه القصص التافهة ونشط هنا لعمله نشاطا لفت إليه نظر بعض كبار الأدباء، حتى إن جريجوريفتش كتب له يقول «إن لك ملكة حقيقية، ملكة ترفعك الى مكان يسمو على دائرة أدباء الجيل الحديثين»، فبعد أن كان غرضه المال أصبح يتطلع الى الإجادة الفنية حتى فاز بجائزة بوشكين، وأخذ صيته في الذيوع، إلا أن الإجهاد المستمر والعمل المتواصل نالا من صحته كل منال وأنهكا قواه، فبدت عليه علامات السل! وكم كان ارتياحه لذلك عظيما! ولكنه أخفى الأمر وكتمه في صدره حذرا أن يتسرب الى علم والدته التي يشفق عليها من الحزن والألم. ولم يكن هذا ولا غيره بمانعه عن مواصلة عمله، فكتب للمسرح روايات ناجحة مثل «ايفانوف» و«الخال فانيا» وقد صد عن التأليف للمسرح زمنا بسبب سقوط إحدى رواياته، ولولا أن أعيد تمثيلها في موسكو ولاقت نجاحا باهرا لحرم المسرح من قلم تشيكوف.
زادت آفاق حياته وزخرت بالتجارب والفهم الصحيح للأمور، وتحسنت أحواله المالية فرحل الى موسكو إلا أن المرض كان يغالبه مغالبة شديدة حتى انكشف أمره وعلم به من كان يشفق عليه أن يعلم به، واضطر الى نفى نفسه من وطنه الحبيب الى جنوب فرنسا وهو أسيف، وهنالك بقى زمنا يكابد آلام المرض ويعالج لواعج الشوق والحنين الى موسكو وأناس بموسكو، ولما أحس بتحسن في صحته سارع بالعودة الى الوطن، ولأول مرة نرى حياته تصطبغ بذلك اللون الوردى الجميل، فقد عرف ممثلة هى أولجا ليوناردوفنا، وألف الحب بين قلبيهما فتزوجا وساحا سويا ينعمان بالحب، وعاد المرض يطارده ويحرمه من الطمأنينة وعاد هو الى منفاه تاركا زوجته ترجع الى موسكو لتباشر عملها، وتستطيع أن تتصور حاله وهو صريع القلب والصدر بعيدا عن وطنه.
واشتدت عليه وطأة المرض فرحل الى ألمانيا حيث لحقت به زوجه، وتحدثنا الزوجة عما كان يعانيه زوجها من الآلام، وتشير إشارة خاصة الى بقاء الصفاء مخيما على روحه التي احتفظت بفكاهتها ودعابتها، وهكذا لم تملك إلا أن تضحك وهى جد جزعة عليه، وأخيرا هزم ذلك الجسم الريفى القوى أمام المرض الخبيث وقضى صاحبه الأديب.
كان في طبيعة تشيكوف ما يمنعه عن الإبانة الصريحة عن ذات نفسه، فلم يخلف لنا مذكرات شخصية تنفع المؤرخ النفساني، حقا إن رسائله كثيرة ولكنها في الغالب ـ تتناول مواضيع عامة أدبية وفلسفية وعلمية فالمرجع الثقة لمن يريد أن يتعرف الى هذه النفس الأدبية هو مؤلفاته وبعض رسائله الخاصة، ومن الحق علينا أن نتكلم عن إيمانه، فإن إيمان الرجل أو عدمه أدق مقياس يزن أفعاله وتصرفاته، وتشيكوف يقول صراحة إنه فقد الإيمان وهو صغير، وطال عهده بهذه الحرية الدينية وبقى يلهو ويعبث ويعمل من غير ما يكدر صفو قلبه بأسئلة الايمان الملحة التي قد تبلغ حد العذاب، وكأنك بعد ذلك تحس بالجد في كتابته، فكأن نظرته إلى الحياة حالت وكأن الحياة في نظره كبرت، وتتوالى أسئلته عن الحياة والموت. وتكاد تلمس المرارة التي يفيض بها قلبه المرهف الحس، وخرج عن قبة نفسه ليواجه المشاكل الاجتماعية الكثيرة، واستحوذ عليه اهتمام كبير بها، أغراه بالتعرض لأهوال السفر لمجرد التعرف إلى أناس جدد وأخلاق جديدة.
ويظهر لنا اهتمامه هذا واضحا في حادث تنازله عن لقب العضوية بأكاديمية العلوم احتجاجا على الغاء انتخاب ماكسيم جوركى بسبب مذهبه السياسى.
وقد اهتم كبقية الكتاب الروس بمسائل العمل. ونحن ننقل هذه الكلمة له لتعلم منها شيئا عن خيال الاصلاحى قال: «إذا كنا جميعا ـ سواء من يسكن المدن أو من يقيم في الأرياف ـ نرضى بأن نقتسم فيما بيننا العمل الذى يبذله البشر في اشباع حاجاتهم الطبيعية، فإن أحدا منا لا يمكن أن يعمل أكثر من ساعتين أو ثلاث كل يوم. نبقى بعذ ذلك أحرارا بقية اليوم، ونهب هذا الوقت للعلوم والفنون. كلنا نبحث عن الحقيقة وعن معنى الحياة. وأنى لواثق في أن ينكشف لنا وجه الحق. ويستطيع الانسان أن يخلص نفسه من فزع الموت الدائم الذى يصليه نار العذاب».
وفى النهاية اهتدى الأديب إلى الايمان وكان ايمانه بالانسان بمستقبله وبرقيه، وانك لتحس بإيمانه هذا إذا قرأت له احدى رواياته، ويتأكد احساسك كلما أمعنت في القراءة، نعم إن حياته الانسان الواقعية تثير سخطه ورحمته، وهو دائما يصور شقاء الانسان ويتهمه بأنه السبب في كل ما يحيق به من أسباب الألم بما تفيض به نفسه من ميول للتشاحن والبغضاء وعواطف الأثرة والشر. ويخيل اليك وأنت تقرأ بعض رواياته أنك تقرأ «البيت الكسير الفؤاد لبرناردشو» إذا لاحظت الموضوع والغرض، فهو يتخيل العالم أو أوروبا في أسرة كل فرد من أفرادها مصاب بما يضلله عن طريق السعادة. فإذا قاربت الرواية النهاية سمعت نداء عذبا إلى السعادة وتفاؤلا صريحا بالمستقبل السعيد.
على انه بقى وسط هذه المذاهب الاجتماعية والمشكلات الانسانية فنانا خالصا لوجه الفن، وقد قال في ذلك: «الميل جذوره في عجز الانسان عن أن يعلو عن التافهات من الأمور، الفنان ينبغى أن يبقى شاهدا نزيها فقط، لست حرا ولست محافظا ولست مصلحا. انى أحب أن أكون فنانا فقط”.
صحيفة “السياسة الأسبوعية”، 8 مايو 1933


