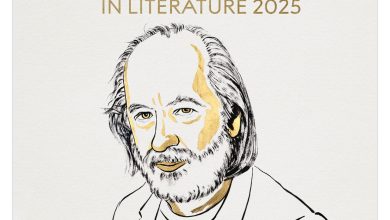أحوال زمننا من خلال السينما الأوروبية

ابراهيم العريس
شيئاً فشيئاً وعاماً بعد عام، يتجه مهرجان السينما الأوروبية الذي يقام سنوياً في بيروت، كما في غيرها من مدن عربية، إلى أن يصبح واحداً من أهم التظاهرات السينمائية التي تقام في لبنان، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وما برنامج الدورة الثالثة والعشرين التي افتتحت فعالياتها مساء أمس الخميس بالفيلم الإيطالي «غرباء تماماً» لباولو جينوفيزي، سوى برهان إضافي على هذا.
فالمهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى السادس من شباط (فبراير) المقبل في بيروت – سينما متروبوليس أمبير صوفيل في حي الأشرفية على بعد دقائق على الأقدام من وسط العاصمة – قبل أن ينقل العديد من عروضه الى سبع مدن لبنانية أخرى، يعرض هذا العام، ومن جديد، مجموعة مدهشة من أفلام أوروبية، ناهيك بالتظاهرة الخاصة التي يقيمها على هامش عروضه الأوروبية لسينما طلاب المعاهد والجامعات في لبنان مقدماً جائزتين لأفضل فيلمين قصيرين في هذا المجال.
أميركا الأوروبية
صحيح أن هذه التظاهرة المحلية تبدو مهمة في هذا السياق إذ تلفت النظر حقاً الى إنتاج يشكل جزءاً مما ستكون عليه السينما اللبنانية في المستقبل، وإذ تتيح للفائزين الدعوة لحضور مهرجان دولي بارز للسينما القصيرة في أوروبا، لكن المهم يكمن في سياق آخر تماماً. في تلك العروض التي تشمل ثلاثة وأربعين فيلماً آتياً من مختلف البلدان المنتمية الى الاتحاد الأوروبي، بما فيها بريطانيا التي لم يعتبرها المهرجان، بعد، خارج ذلك الاتحاد. وحسناً فعل إذ إنه بذلك يتيح الفرصة للجمهور المحلي لمشاهدة آخر أفلام المخرج كين لوتش «أنا، ويليام بليك» الفائز قبل شهور بالسعفة الذهبية في مهرجان كان الدولي. وفيلم لوتش هذا، والذي يعتبر صرخة اجتماعية مدوية ونزيهة لا تخلو من مرارة وطرافة، بأكثر مما يعتبر تحفة سينمائية يوقّعها ذاك الذي يلقب بـ «آخر اليساريين المحترمين» في السينما الأوروبية، ليس العمل الوحيد بين الأفلام العديدة المعروضة الذي سبقته سمعته ما يؤمّن له ازدحاماً كبيراً في حفل عرضه. كما أن لوتش ليس السينمائي العالمي الكبير الوحيد في المهرجان. فهناك أيضا توماس فنتربرغ من الدنمارك وأحد أعمدة «دوغما 95» الذي، بعد أفلام صورها في الولايات المكتحدة وغيرها، يعود في جديده «الكومونة». وهناك الكندي الفرانكوفوني كزافييه دولان، المعتبر اليوم الفتى المدلل للسينما الناطقة بالفرنسية مع فيلمه المدهش الذي عرض في «كان» الفائت «إنها نهاية العالم لا أكثر». وهناك الإسباني الكبير بيدرو المودافار برائعته الجديدة «خولييتا» الذي ظُلم في كان، بل حتى هاجمه النقاد قبل أن يعودوا بعد شهور لـ «يكتشفوا» قوته وجماله.
ولئن كانت السينما الأميركية غائبة عن المهرجان، وهذا من طبيعة الأمور في تظاهرة تعنى بالسينما الأوروبية، فإنها لن تعدم حضوراً من طريق الإنتاج الأوروبي لواحد من الأفلام الأميركية الأكثر شاعرية لهذا العام، «باترسون» من توقيع جيم جاموش المعتبر دائماً الأكثر أوروبية بين السينمائيين الأميركيين المعاصرين. وهذا الفيلم، كما فيلم دولان، يقدمان باسم فرنسا التي ترسل أيضاً فيلماً للفتيان وآخر جزائرياً للمخرج الفرنسي/الجزائري فريد بنتومي، هو «حظاً سعيداً يا جزائر».
وإذا كان هذا ما يتعلق بالأسماء ذات الرنين في السينما العالمية والتي من شأنها أن تجتذب جمهوراً عريضاً يعرف الكثير عن هذه الأفلام حتى من قبل مشاهدتها، فإن ما لا ينبغي الاستهانة به هو الوعود السينيفيلية التي تطرحها بقية العروض. فهي تتعلق بأفلام آتية من شتى البلدان الأوروبية، ولا سيما من بلدان من النادر أن تُعرض أفلامها في الصالات التجارية خارج حدودها لأسباب لا نجد ضرورة للعودة إليها وسط طغيان سينما الأكشن الأميركية التي تُعرض للمراهقين في مجمّعات المولات غير تاركة أية فرص حقيقية لاختبار ما يحدث حقاً على صعيد السينما الإنسانية في العالم.
ولئن كان من المنطقي اليوم القول إنك إذا ما أردت أن تعرف أحوال منطقة ما من العالم وأحوال مجتمعاتها عليك بسينماها: حسبك أن تشاهد أجمل أفلامها لكي تغوص في حياتها وأفراحها وشجونها وتوقعات أهلها أو خيباتهم. ومن هنا، يكفي استعراض دقيق لما يعرض في المهرجان آتياً من بلدان مثل إسبانيا وهنغاريا وهولندا والنمسا وبلجيكا وصولاً إلى قبرص واليونان والبلدان الإسكندنافية … وغيرها، ليجد المرء نفسه أمام خارطة حقيقية لحساسيات العالم القديم وأين صارت أحلامه. فالسينما ولا سيما منها الأوروبية اليوم تبدو المرآة الأفصح في تعبيرها عن ذلك كله. لكن الأهم من هذا هو الأجوبة التي تطرحها الأفلام حول سؤال يبدو شائكاً اليوم: أين هذه السينما الجادة والجميلة وسط التقدم التقني من جهة والتراجع الإنساني من جهة أخرى؟
السينما في خير!
لا شك في أن الجواب الذي يمكن العثور عليه من خلال العروض الموعودة سيقول لنا ان السينما في خير. السينما الأوروبية في خير. وهي لا تزال قادرة على أن تقول كلمتها سواء على صعيد فردية الإبداع أو جماعية التلقي. بل ربما في هذا المجال، وكما ترينا أفلام هذه التظاهرة الفذة والكاشفة والمستكشفة، يمكن القول إِن أوروبا لا تزال، في سينماها وفي واقعها الذي تعبر السينما عنه، لا تزال موئلاً للقيم وللفنون التي تعكس هذه القيم، أكثر من أي منطقة أخرى من العالم. بل يمكن المتفرج أن يلاحظ في بعض الأفلام الأوروبية المعروضة مرآة له ولأحوال مجتمعاته لا توفّرها له سينماه المحلية. وكأن قدر أوروبا وسينماها أن تحملا هموم العالم شرقه وغربه وشماله وجنوبه.
ولعل هذا ما ينقلنا في هذا السياق مباشرة الى تراثنا العربي من دون حاجة الى أية مقدمات. فإذا كان المهرجان يضعنا على تماس مباشر مع ماض ما للسينما الأوروبية الكلاسيكية من خلال عرض فيلم «فامبير» الفرنسي/الدنماركي للمخرج كارل ث.دراير، فإنه في سياق مقابل يعرض الثلاثية المدهشة التي حققها البرتغالي ميغويل غوميس قبل عامين عن بعض حكايات «ألف ليلة وليلة» في فيلم لا تقل مدة عرضه عن ثماني ساعات وشكّل حين عُرض قبل عامين في دورة مهرجان كان قبل الفائتة، واحداً من الأحداث السينمائية المهمة على الصعيد العالمي.
والحقيقة أنه يجدر اليوم بكل سينمائي عربي يتحدث عن «ضرورة العودة الى الأصالة» أن يشاهد هذا الفيلم، مرات ومرات على رغم طوله الإستثنائي، ليعثر فيه على أجوبة عن كل تساؤلاته حول الأصالة، ولكن حول … المعاصرة أيضاً. فـ «ألف ليلة وليلة» كما حققه البرتغالي غوميس حدث سينمائي وثقافي كبير بكل ما في هذه الكلمة من معنى. فكيف إن كان يُعرض في سياق تظاهرة توفر للجمهور اللبناني فرصاً نادرة لمشاهد أعمال لا يمكنه مشاهدتها طوال العام، أعمال تتراوح بين شريط عن الفوضوية نيللي كابلان حققته حفيدتها الأوكرانية ألينا دمياننكو، وبين استعادة لليدي ماكبيث في فيلم إنكليزي لويليام أولدرويد، والشريط القاسي واللافت «المعلمة» للسلوفاكي يان هريبيك الذي شكل حدثاً اجتماعياً قبل شهور في مهرجان كارلوفي فاري؟
(الحياة)