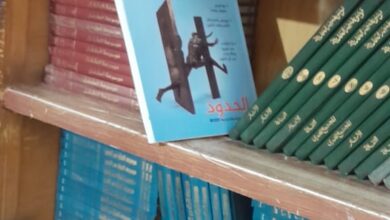“أم الروبابيكيا” … أمثولة أدبية لإنعاش الذاكرة

شهدت البشرية في عمرها المديد ألوانًا من “التاريخ المنسي” أو “المستبعد” حين أتيح للمنتصرين أن يكتبوا اليوميات والحوليات، فاستبعدوا منها كل ما يصنع للمهزومين أيامًا حاضرة
في فلسطين أخذ العجائز، نساء ورجالًا، على عاتقهم حفظ الذاكرة، حتى لا تمحى ولا تستباح.. وقد حفل الأدب الفلسطيني بأنماط من هذه الشخصيات
أصبحت هذه الفتاة تنسج من الحكايات القديمة التي كانت تسمعها عن بلادها وطنًا لها، تنتمي إليه حتى ولو في الخيال، أو على حد قول الراوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمار علي حسن
أول الطريق إلى اغتصاب الحق هو محو الذاكرة، فمن ينسَ يُفرطْ. والذاكرة إن ألهبت نفوس من كابدوا لحظة الاستيلاء على الإرث المادي، وفي مقدمته الأرض، أيام الصدمة الأولى والمواجهة البكر، فإن أي غشاوة تطمسها، أو تزييف يلحق بها، أو تغيير يجعلها تنحرف عن التمسك بحق الاستعادة والاسترداد والرجوع، سيؤثر، دون شك، على مواقف الأجيال اللاحقة، التي يعول المحتل على تغييب الحقوق من رأسها، فترضى بالسائد والمتاح، أو تسلم، بفعل وعي زائف مبتور، برواية المحتل، وتعتبرها قدرًا مقدورًا لا فكاك منه.
لهذا لا يكتفي المقاوم بحمل السلاح ضد المحتل، إنما عليه أن يتسلح أيضًا ضد تزييف التاريخ، وطمس الهوية، بالإبقاء على الذاكرة حية، لاسيما إن كان يواجه احتلالًا استيطانيًّا إحلاليًّا، يريد أن يلغي وجود السكان الأصليين، وهو إلغاء يبدأ بخلع الإنسان من تاريخه الشخصي، وقبله التاريخ العام الذي يشكل إطارًا يحيل إليه، وسندًا يتكئ عليه، وجدارًا صلبًا يحمي ظهره.
وطالما شهدت البشرية في عمرها المديد ألوانًا من “التاريخ المنسي” أو “المستبعد” حين أتيح للمنتصرين أن يكتبوا اليوميات والحوليات، فاستبعدوا منها كل ما يصنع للمهزومين أيامًا حاضرة، مثلما فعل الإنجليز والفرنسيون بالهنود الحمر، الذين صاروا أثرًا بعد عين، ومثلما فعل الاحتلال المتعاقب بالمصريين حين أزاح تاريخهم القديم قرونًا طويلة، إلى أن أُعيد اكتشافه بعد فك شفرات اللغة الهيروغليفية.
ويعي الفلسطينيون هذه المسألة جيدًا، لذا يحتفظون في ذاكرتهم بخرائط فلسطين قبل نكبة 1948، بل قبل وعد بلفور 1917، وما تلاه، حين تم تهجيرهم قسرًا، وتغيير أسماء قراهم ومدنهم عربية الأسماء إلى أسماء عبرية، بل إنهم يحتفظون بما هو أدق وأكثر تفصيلًا من الخطوط العامة، مثل مفاتيح بيوتهم التي أُخرجوا منها، وأزيائهم التي اعتادوا ارتداءها، وأكلاتهم الشعبية التي نسبها الإسرائيليون إلى أنفسهم، وطقوسهم في الأفراح والأتراح، فحملها المحاصرون في المعازل التي أزيحوا إليها في الضفة الغربية وغزة، ورافقتهم إلى الشتات في البلدان المجاورة، وإلى المهجر والمنافي البعيدة التي اضطروا إلى أن يتخذوها أوطانًا جديدة، توزعهم بلا رحمة على قارات العالم الست.
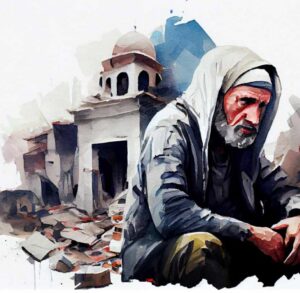

في فلسطين أخذ العجائز، نساء ورجالًا، على عاتقهم حفظ الذاكرة، حتى لا تمحى ولا تستباح. وقد حفل الأدب الفلسطيني بأنماط من هذه الشخصيات، تعد أبرزها امرأة أطلق عليها اسم “أم الروبابكيا” في رواية إميل حبيبي “سداسية الأيام الستة”، حيث كانت تفعل كل ما يحافظ على جزء من تاريخ الشعب الفلسطيني وعلامات تؤكد أحقيته في أرضه ووطنه، فهي، ومن خلال جمعها للأشياء القديمة “الروبابيكا”، أصبح لديها الكثير من الأوراق والأشياء القديمة، التي تشكل جزءًا مهما من الذاكرة الاجتماعية الفلسطينية.
ولم تكن هذه المرأة شخصية عادية، بل كانت واعية إلى دورها، فها هو حبيبي ينبئنا بقدراتها الذاتية حين يقول عنها: “كانت إذا دخلتم في الشعر دخلت فيه، وكنتم تسرعون إلى إكمال بيت إذا لم يأتها سوى شطره الأول، وكنتم تهمهمون استحسانًا -لؤمًا- إذا روت بيتًا وقد كسرته .. وإذا دخلتم في السياسة، كانت أشدكم حماسًا ورغبة في أداء المهمة، فإذا اعتقل أحدكم كانت أسرع من أمه إلى زيارته، وحمل الطعام إليه، وغسل قمصانه”. ورغم أن بعض الناس انتقدوا مسلكها، ورأوا في جمعها للأشياء القديمة متاجرة بجزء من حياة شعب، واستفادة من الكارثة التي حلت به، بتهجيره من أرضه، فإن الرواية تنصفها حين تقدم ما يفيد بأن أم الروبابيكيا، كانت مخلصة لكل ما يربطها بتاريخ وطنها من الحاجيات القديمة التي كدستها لديها، لتظل شاهدًا على أناس كانوا يقطنون هذه الأرض يومًا ما.
لم تنزح “أم الروبابيكيا” مع الذين تركوا دورهم بعد حرب 1948، ومن بينهم زوجها وأولادها، وبقيت مع والدتها القعيدة، وبعد أن كانت في نظر الجميع “ملكة الوادي المتوجة” أصبحت “أم الروبابيكيا” لأنها تاجرت في الأثاث الذي نهبه الإسرائيليون من بيوت الفلسطينيين، فتبرأ منها زوجها، وراح من يعرفونها يصفونها بأنها “عريقة في النهب”، ونسي الجميع أنها طالما وقفت إلى جانب المعتقلين في محنتهم. وغاب عن البعض أن ما تفعله هذه المرأة يحمل جانبًا إيجابيًّا لا يمكن إنكاره، يتمثل في الحفاظ على جزء من الذاكرة الشعبية والهوية الفلسطينية، وهو ما يوضحه الراوي حين يقول: “احتفظت بذكريات الوطن التي كانت تطلق عليها اسم “النوزي”، وتفسر أم الروبابيكيا نفسها معنى هذا بقولها: “لدي خرقات من أنوار الصبا، رسائل الحب الأول، لدي قصائد خبأها فتيان بين أوراق كتب مدرسية، لدي أساور وأقراط وغويشات.. لدي يوميات بخطوط دقيقة حيية وبخطوط عريضة واثقة”.
وهذه الأشياء والأوراق يتعدى وجودها وفائدتها مسألة أنها سلع، تباع وتشترى، إلى كونها تاريخًا جمعيًّا، أو نسيجًا متناغمًا من ذكريات لأشخاص عديدين، يرتبطون نفسيًّا بأشيائهم القديمة، ويعتبرونها جزءًا من هويتهم الوطنية.
وتجود الرواية نفسها بحكاية امرأة أخرى تدعى “جبينة”، لتثبت ارتباط الإنسان بذاكرته وهويته الوطنية، التي لا تعدو أحيانًا عن كونها أشياءه القديمة، فجبينة كانت قد نزحت مع زوجها وأولادها إلى لبنان، ثم عادت بعد عشرين عامًا، بإذن أسبوعين فقط من السلطات الإسرائيلية، لتفتح غطاء صندوق خشبي قديم كان مخصصًا لملابسها في طفولتها، وتخرج أثوابها القديمة، وتسمع أمها العجوز تهمس بجانبها قائلة: هذه ثيابك حفظتها لابنتك، فلماذا لم تحضريها معك؟ وتتكرر هذه الحكاية مع نساء ورجال عادوا من الكويت والأردن، كما تقص هذه الحكاية، ليعبروا جسر الملك حسين ويتفرقوا في أزقَّة البلاد التي نزحوا منها، ويتطلعوا نحو الشرفات والنوافذ في صمت، وبعضهم يطرق الأبواب ويسأل في أدب: هل كان يقوم هنا بيت من حجارة مكحلة؟ فيرد عليه طفل ولد بعد عام 1948 : “لقد ولدت بعدها يا عماه”.
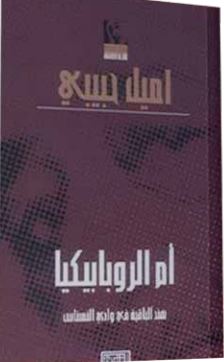
إن أثواب “جبينة” والبيوت التي اندثرت وصارت أطلالًا، إنما هي جزء من تاريخ أناس أجبرتهم إسرائيل على النزوح عن ديارهم، وهذا التاريخ الشخصي، يصب في معناه ومبناه الأخير في الذاكرة والهوية الوطنية.
وتكمل الحكاية الأخيرة من الرواية رحلة بحث أبطالها عن تاريخهم الوطني، من خلال فتاة من عرب 48، تم سجنها مع فتيات فلسطينيات كن يشاركن في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب يونيو 67، فهي تشعر بأن إسرائيل ليست وطنها على الإطلاق، وهو ما يتبين من قولها لزميلاتها: “إنني أشعر أنني لاجئة. أنتم تحلمون بالعودة وتعيشون على هذا الحلم، أما أنا فإلى أين أعود”.
ولذا أصبحت هذه الفتاة تنسج من الحكايات القديمة التي كانت تسمعها عن بلادها وطنًا لها، تنتمي إليه حتى ولو في الخيال، أو على حد قول الراوي معبرًا عن حالتها: “إنها لا تشعر بالوطن إلا حين تجلس في الليل قبل النوم إلى جانب والدتها على الفراش، وتحدثها عما مضى من أيام، حين كان إخوتها الستة في البيت”. لكن الإخوة تفرقوا في الكويت والسعودية والإمارات ولبنان والقبور، ولم يعد لها ما تستمد منه هويتها سوى حكايات تمثل تاريخ أسرتها في وطنها الأصلي.
إن “أم الروبابيكيا” والمرأتين الأخريين اللتين شاركتاها الوعي بالتاريخ، يمثلن جميعًا حالات واقعية متعددة، التقطها الأدب، وصنع منها أمثولات ناصعة، لقدرة الشعب الفلسطيني على أن يبقي ذاكرته حية، بالحكايات والأشياء والرغبات والأمنيات وحلم العودة الذي لا يموت.
المصدر:مجلة الجسرة الثقافية. العدد: 63