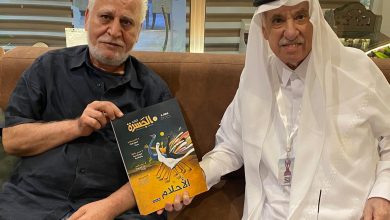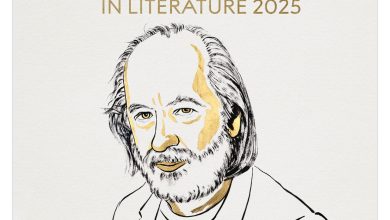الأزهر الشريف . . مسيرة ألف عام من الوسطية

الجسرة الثقافية الالكترونية -الخليج-
لم يكن الأزهر الشريف طوال مسيرته التي زادت على الألف عام، مجرد جامع، تقام فيه الصلوات، بل إنه يعد من أقدم جامعات العالم، ولتأكيد أهمية الدور الذي لعبه، فإن البعض قال إن للمسلمين قبلتين، قبلة دينية، وأخرى علمية، أما الدينية فيقصدون بها “المسجد الحرام” في مكة المكرمة، ويعنون بالعلمية الأزهر الشريف في القاهرة .
تتعدد الأدوار التي قام بها الأزهر طوال تاريخه، فكان حصناً للدفاع عن الإسلام والعروبة، وعلى المستوى المصري كان عنصراً من عناصر الحفاظ على الأمة، بتعميق الوحدة بين عنصريها الإسلامي والمسيحي .
وإذا كان البعض يربط بين النهضة المصرية وقدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام ،1798 فإن طلاب وشيوخ الأزهر كانوا أول من تصدى لهذه الحملة، التي لم تصمد سوى ثلاث سنوات، تحت وطأة الثورات التي كانت تخرج من الأزهر، ومنها ثورتا القاهرة الأولى والثانية، التي راح ضحيتها عدد من الشهداء من علماء الأزهر وطلابه .
وحين غزت بريطانيا مصر عام ،1807 فيما عرف بحملة رشيد، أصدر علماء الأزهر بياناً بتعطيل الدراسة كي يتفرغ طلابه ومدرسوه للدفاع عن البلاد، وتكبدت الحملة خسائر فادحة، وفر جنودها هاربين، قبل أن يعاودوا الكرة مرة أخرى في العام 1882 .
ولعب الأزهر دوراً وطنياً في الثورة العرابية، فكان علماؤه يحضرون اجتماعات الضباط، حتى إن الإمام محمد عبده هو من وضع يمين القسم الذي أقسم عليه الضباط، وكان شيخ الأزهر آنذاك الشيخ محمد الإنبابي على رأس الحضور في الاجتماعات السياسية، التي ينظمها العرابيون، ولما أخفقت الثورة عزل شيخ الأزهر، وتعرض العلماء للانتقام، وقدموا للمحاكمات العسكرية، التي قضت على بعضهم بالنفي والحبس والفصل، مع تجريدهم من امتيازاتهم .
كان الأزهر باستمرار قبلة الوطنية المصرية، ففي ثورة 1919 كانت التظاهرات تنطلق منه، وكانت الاجتماعات السياسية تعقد في داخله، وعلى منبره خطبت فئات تنتمي إلى شرائح اجتماعية مختلفة، حتى إن الرئيس جمال عبدالناصر استخدم المنبر ذاته في الحشد لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 .
استمر هذا الدور حتى اللحظة الراهنة في التاريخ المصري، فكانت الحشود تبدأ من الأزهر دعماً للقضية الفلسطينية والقضايا العربية عموماً، ومن أبوابه خرجت الاحتجاجات ضد نظام الحكم، كمقدمة لثورة يناير 2011 .
تاريخ الأزهر مملوء بالنقاط المضيئة، ففي العصر الفاطمي كانت النساء يدرسن فيه، وتعددت المجالس تبعاً لنوعية الدارسين، فكان هناك مجلس لعلية القوم من الفقهاء والعلماء وكبار رجال الدولة وموظفي قصور الخليفة، ويسمى مجلس الخاصة، وهناك أيضاً مجلس للعوام والطارئين على البلاد، ويسمى مجلس الكافة، كما كان هناك مجلسان للنساء، مجلس يجتمع في الأزهر بصفة دورية، والآخر خاص بنساء الخليفة وأسرته، وكما يقول د .عبد العزيز الشناوي في كتابه “الأزهر جامعاً وجامعة” فإن الأزهر شهد منذ عصره الأول أيام الدولة الفاطمية مجالس تعقد للنساء يحضرن إليها للاستماع إلى قراءة المراجع الدينية .
بعد 35 سنة من إنشاء الأزهر، أنشأ الفاطميون “دار الحكمة”، وكانت الدراسة بها أكثر تنوعاً، ويبدو أن الهدف من ورائها هو سحب البساط من تحت أقدام الأزهر، ففي كتاب الدكتور محمد عبدالله عنان عن “الحاكم بأمر الله” نقرأ أن “دار الحكمة في ظاهرها كانت جامعة حرة، يلتحق بها من شاء، ويدرس بها ما شاء من مختلف العلوم والفنون، لكن هذا المظهر العلمي لم يكن إلا ستاراً للغاية الأصلية التي أنشئت دار الحكمة لتحقيقها، وهي بث الدعوة الفاطمية السرية” .
كان الهدف من إنشاء الأزهر كما يقول د .عبدالعزيز الشناوي واضحاً منذ اليوم الأول، وهو أن يكون مسجداً رسمياً للدولة الفاطمية، ورمزاً لسيادتها الروحية، ومنبراً لدعوتها الدينية من دون إغراق في فرض المذهب الفاطمي على جماهير الشعب المصري، فالأزهر لم ينشأ في الأصل ليكون جامعة أو معهداً عادياً، وكانت فكرة تحويله إلى جامعة في عهد الخليفة العزيز بالله .
ورغم ذلك ظل الأزهر في العصر الفاطمي موئلاً للثقافة الدينية والدراسات اللغوية الأدبية مع الاهتمام بالمبادئ العامة للفقه الشيعي، مثل تعظيم آل البيت، بينما كانت “دار الحكمة” تقوم بتدريس المبادئ الفاطمية الخفية .
كانت الدولة ترعى “دار الحكمة” ما أثر في إقبال الدارسين على الأزهر، لكن ما يؤكده الدكتور الشناوي أن الأزهر ظل بعيداً عن تدريس المبادئ الفاطمية المذهبية الخطرة، وأن دار الحكمة أخفقت في تحقيق إحدى الغايات الرئيسية، التي كانت تصبو إليها الدولة وهي طبع المجتمع الإسلامي في مصر بطابع الفكرة المذهبية الشيعية، فقد ظل المصريون طوال الحكم الفاطمي محتفظين بالمذهب السني .
ولما دالت دولة الفاطميين تولى صلاح الدين الأيوبي حكم مصر، وكان شافعياً، يعمل على دعم المذهب السني في البلاد، فعطل صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، وقصرها على جامع الحاكم بأمر الله، وكاد أن يفقد الأزهر مكانته وكان عمره آنذاك 200 سنة، إلى أن أعاده إلى الواجهة الظاهر بيبرس في عهد الدولة المملوكية، وكانت الجماهير تلوذ به عند وقوع الكوارث، مثل وباء الطاعون الذي عصف بهم عام 1430 ميلادية، وعند اشتداد الأزمات الاقتصادية والفيضانات، والظواهر الطبيعية ككسوف الشمس .
وصل الأزهر إلى مكانة الزعامة الفكرية في مصر، وامتد أثره إلى أرجاء العالم الإسلامي، خصوصاً بعد سقوط بغداد على أيدي المغول، وتصدع الحكم الإسلامي في الأندلس، فانتقل إلى مصر علماء المشرق والمغرب، شدهم الأزهر فعملوا في رحابه، ونزلوا في أروقته، وظل يلعب هذا الدور حتى سقوط دولة المماليك على أيدي العثمانيين، حيث يجمع المؤرخون على أن تلك الحقبة أدت إلى تدهور الحال بالأزهر، ومع ذلك ظل يسهم في الحفاظ على الطابع العربي لمصر، فكانت لغة الدراسة به هي العربية، برغم أن التركية كانت لغة رسمية في دواوين الحكومة .
كانت أروقة الأزهر داعماً أكبر في انفتاح الأزهر على العالم الإسلامي، فكان يفد إليها الدارسون من آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويدرسون فيه بالمجان، ويوفر لهم السكن والجراية، ويمنحون فوق ذلك راتباً شهرياً، ولم تأخذ هذه الأروقة بنظام طبقي أو عنصري .
تعرض الأزهر الشريف للكثير من العقبات التي أدت إلى جمود أفكاره، ما دعا الكثيرين إلى إصلاح وتجديد الخطاب الديني الصادر عنه، ومن هؤلاء الإمام محمد عبده وتلميذه الشيخ محمد مصطفى المراغي، كان العقل الإسلامي في مصر والمشرق كما يذهب د .محمد عمارة يتنازعه تياران: أولهما ينكفئ على الموروث الذي كتب أغلبه في عصور التراجع الحضاري، وثانيهما تيار الوافد الغربي الذي رفض أصحابه هذا الموروث، وأمام هذا الاستقطاب الحاد، برز دور الإمام محمد عبده في حركة الإصلاح .
يقول د .عمارة: “جاء دور التيار الوسطي الذي ينتقد الموروث، ويختار منه الثوابت، التي تجعل لهذا الموروث فعالية في إصلاح الواقع واستشراف المستقبل” وقد عبّر الإمام عن هذا الموقف الوسطي عندما قال: “لقد خالفت في الدعوة إلى الإصلاح رأي الفئتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم، وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم، فقد ظهر الإسلام لا روحياً مجرداً، ولا جسدياً جامداً، بل إنسانيا وسطا بين ذلك” .
قبل هذه الخطوة الإصلاحية المهمة للإمام محمد عبده لا بد من التوقف أمام الشيخ حسن العطار، أول من امتص الصدمة الحضارية الناتجة عن الاحتكاك بالغرب أيام الحملة الفرنسية على مصر، فقد دعا إلى تجاوز الصدمة بالاجتهاد والتجديد وبالتفاعل الإيجابي مع الوافد النافع الذي فتحت أمامه الأبواب .
وأوصى العطار تلميذه رفاعة الطهطاوي، الذي ذهب إلى باريس في عام 1826 إماماً للبعثة المصرية التي سافرت للدراسة هناك، بأن يفتح عينيه وعقله وقلبه على التقدم الذي حدث في أوروبا، وأن يدون معالم هذا التقدم الذي يساعد على النهوض بمصر وبلاد الشرق .
وعاد الطهطاوي إلى مصر ليكون قائد كتيبة الفكر وإمام الثقافة والتجديد والتنوير، وظل الأزهر محافظاً على استقلاليته، حيث يحفظ التاريخ لشيخه “سليم البشري” أنه تقدم باستقالته من المنصب عام 1904 عندما تدخلت الحكومة في شأن من شؤون الأزهر، ثم عين مرة ثانية وفقاً لشروطه .
كانت الخطوة الأكبر في تطوير الأزهر على يدي جمال عبد الناصر حين أدخلت في مناهجه دراسة العلوم الحديثة، ليحمل كل مقومات الكيان الجامعي الحديث، ويبعث إشعاعه العالمي على أسس من الوسطية في الدعوة .