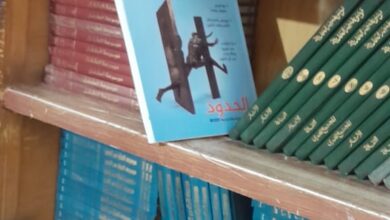الشيوخ الصغار.. لماذا يرتدُّ الشعراءُ أطفالًا عندما يكتبون عن أمهاتهم؟
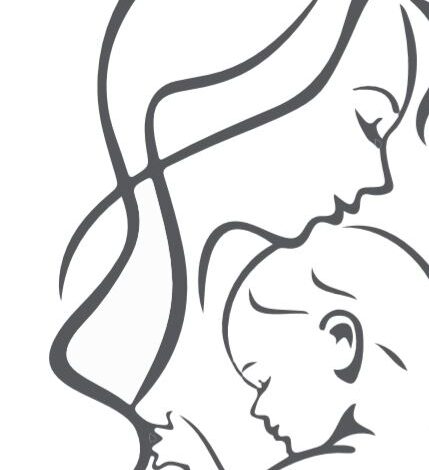

_______________ شيرين أبو النجا
حبيبتي ماما
أقبلك ألف قبلة بل مليون قبلة، وأدعو الله أن تكوني بصحة جيدة، كل سنة وأنتِ طيبة عشان عيدك، ولو أنها جاءت متأخرة كتابة (رأفت قال لى إنه بلغك تحياتي يوم 21 كما طلبت منه) أنا بخير ولو أنى مشغول جدًّا ومواعيد صحيانى ملخبطة للغاية.
أرجو تبليغ تحياتي وحبي لسامية ولبنى وميرت والجميع، وأن أتمكن قريبًا من المجيء إليك لأنك واحشاني جدًّا، وربنا ينفخ في صورة التليفون عشان أعرف أكلمك كل يوم.
علمت من مصطفى أنه متوجه إلى مصر الجديدة، فكتبت هذه الرسالة على عجل يحملها إليك.
وأخيرًا أدعو الله أن يمتعك بالصحة وأن يحفظك لنا خيرًا وبركة وحكمة.
وإلى اللقاء ..
صلاح
هذه واحدة من الرسائل التي كتبها الشاعر صلاح جاهين لوالدته -أمينة حسن- وقام الشاعر عزمي عبدالوهاب بنشرها في مجلة الأهرام العربي. بالإضافة إلى التلقائية التي تعززها العامية، يلفت النظر تلك الدعوة الأخيرة: “يحفظك (أي الله) لنا خيرًا وبركة وحكمة”. لا نحتاج إلى شرح الخير والبركة، فهي حالات ترتبط بالأم في كل سياق وخاصة السياق العربي، لكن الحكمة هي ما يدعو إلى التأمل. صاحب الرباعيات يقر أن أمه هي منبع الحكمة. تذكرنا شهلا العجيلي أن “هذه المجتمعات، ستبقى أمومّية، وإن راودكم الشّك في ذلك، فاسألوا الشعراء، عن السبب الذي يجعلهم يلوذون بأّمهاتهم، لحظة الخوف أو لحظة الشعر!” قد لا نحتاج أن نسألهم فهذا الانقسام الواضح كائن لدى الذكور، حيث سيفه مع أبيه وقلبه مع أمه.
في الخطاب الشعري العربي يبدو واضحًا ارتداد الشاعر إلى مرحلة الطفولة عندما تحضر أمه في القصيدة، وهذه العودة إلى الطفولة تبرر بحثه عن الأم كملجأ وهو ما يشعره بالأمان ويداوي جروحه ولو بشكل مؤقت. وهو ما عبر عنه الشاعر اللبناني سعيد عقل بقوله:
أُمِّيَ… يا مَلاكي يا حُبِّي الباقي إلى الأَبَد وَلَم تَزَلْ يَداكِ أُرْجوحَتي وَلَمْ أَزَلْ وَلَدْ
تؤكد كلمة “ولد” رغبة الشاعر في العودة إلى الطفولة، فقد استخدمها نزار قباني في قصيدة “خمس رسائل إلى أمي”. فبعد أن يقدم التحية في الرسالة الأولى “صباح الخير يا قديستي الحلوة”، يؤكد لها في الرسالة الثانية:
ولم أعثر..
على امرأةٍ تمشط شعري الأشقر
وتحمل في حقيبتها..
إليَّ عرائس السكر
وتكسوني إذا أعرَى
وتنشلُني إذا أعثَر
أيا أمي..
أيا أمي..
أنا الولد الذي أُبحِر
ولا زالتْ بخاطره
تعيشُ عروسةُ السكر
فكيف.. فكيف يا أمي
غدوت أبًا..
ولم أكبرْ؟
في عام 1995 وبعد صدور ديوان محمود درويش لماذا تركت الحصان وحيدا؟، أجرى الشاعر اللبناني عباس بيضون حوارًا مع درويش، حيث لاحظ أن الأب يظهر دائمًا مقترنًا بالرحيل والنزوح فيما تظهر الأم “متصلة دائمًا بالأرض والبقاء”، وكان رأي درويش أن:
الأم هي الأم، والأب هو الأب، إنهما بشر. لكنَّ كلا منهما يحمل دلالات مختلفة. لا يكفي أن تحمل الأم فكرة البقاء المكاني والتاريخي في الأرض الفلسطينية، لتقف عند هذه الكناية. كان الآباء عبر التاريخ كثرًا والأم واحدة. الأم ذات هوية مستقرة، والآباء متغيرون. الأرض التي ولدت عليها هي -كما تعلم- ملتقى غزاة وأنبياء، رسالات وحضارات وثقافات. ولكنهم عابرون، عبورًا يطول أو يقصر، فالأب لم يكن واحدًا ولا نهائيًّا ولا دائمًا. من هنا كان انتسابنا الحضاري والثقافي أكثر إلى الأرض، إلى الأم.
الأم محور ثابت والأب -بكل دلالاته- متغير، وهو ما يلتقي مع القناعة الدينية أن الناس تُدعى في الآخرة باسم الأم؛ وبما أن الأم ترمز بشكل دائم إلى الأرض -كما فعل غسان كنفاني في أم سعد– فقد اعتمد درويش هذه الدلالة أيضًا. لكن هذا لا يعني أن الأم لديه اقتصرت على هذا البعد الرمزي، فهو يؤكد أن في ديوان لماذا تركت الحصان وحيدا؟ “أسجل ما يشبه السيرة، وأعيد تأليف ماضيَّ، لذا أُحمِّل الأم والأب دلالات تتجاوز الصفة العائلية، دلالات مكانية وثقافية وإنسانية”. وفي قصيدة “تعاليم حورية”-وهي إشارة إلى والدته واسمها حورا- تظهر الأم عبر بعدين: بعد واقعي مباشر، وبعد رمزي ينهل من التاريخي والديني. في الحالتين هو حضور غير عادي، فالعنوان يؤكد أن القصيدة ليست عن الأم فقط، بل أيضًا عن تعاليمها، تراثها، خطابها، وكل ما تركته في نفس الشاعر. فهي الأم المتصلة بابنها بقوة حتى إنها تعرف ما يفكر فيه بدون أن يتكلم:
فَكَّرتُ يومًا بالرحيل، فحطَّ حَسُّونٌ على
يدها ونام. وكان يكفي أَن أُداعِبَ غُصْنَ
دالِيَةٍ على عَجَلٍ… لِتُدْركَ أَنَّ كأسَ نبيذيَ
امتلأتْ. ويكفي أَن أنامَ مُبَكِّرًا لتَرَى
مناميَ واضحًا، فتطيلُ لَيْلَتَها لتحرسَهُ…
ويكفي أَن تجيء رسالةٌ منّى لتعرف أَنَّ
عنواني تغيَّر، فوق قارِعَةِ السجون، وأَنَّ
أَيَّامي تُحوِّم حَوْلَها… وحيالها
أُمِّي تَعُدُّ أَصابعي العشرينَ عن بُعْدٍ.
تكتسب الأم مصداقية عبر هذه المبالغة المشهدية، وهي مصداقية تبرر موقعها في حياته حيث أيامه “تحوم حولها وحيالها”، وبنفس القدر تسمح باستعادة تعاليمها. لكن الشاعر لا ينتقل إلى التعاليم مباشرة بعد هذا المفتتح، بل يستعيد جزءًا من التاريخ بما يجعل الأم فاعلًا قويًّا في المشهد اليومي ويحولها إلى جزء من الجموع الفلسطينية التي تشبه أم سعد. إذا كانت أم سعد تشبثت بالأرض والأمل وزرعت غصن الدالية، فإن أم درويش تشبثت بلغتها الدارجة، واضطر الابن/ الشاعر أن يوظف الفصحى لبلورة صوته الشعري:
وأَنْشَأَ المنفي لنا لغتين:
دارجةً…ليفهَمَها الحمامُ ويحفظَ الذكرى
وفُصْحى… كي أُفسِّرَ للظلال ظِلالَهَا!
تبقى اللغة والذاكرة المشتركة هي ما يربط الأم والابن، “لم أَكبرْ على يَدِها/ كما شئنا: أَنا وَهِيَ، افترقنا عند مُنْحَدرِ/ الرُخام”. وليستعيد الذاكرة التي تربطهما يسألها: “هل تتذكرين/ طريق هجرتنا إلى لبنانَ، حَيْثُ نسيتِني/ ونسيتِ كيسَ الخُبْزِ (كان الخبزُ قمحيًّا)..”. في شحذه للرابطة الخاصة بينهما، يحول الابن نفسه وأمه إلى جزء من الحدث الكلي الذي أدخل مفردة المنفى في القصيدة. هو المنفى الذي يجعله يقر أن “عالمنا تغير كله، فتغيرت أصواتنا”.
يخرج الابن/ الشاعر من الحالة الشعورية التي يتواصل بها مع أمه كإنسان واقعي، ويرفعها إلى مصاف السيدة هاجر، مانحًا إياها بعدًا رمزيًّا تاريخيًّا: “هي أخت هاجر، أختها من أمها. تبكي/ مع النايات موتى لم يموتوا”. يحرص الشاعر على وضع أمه في نسب أمومي مع هاجر، فتكتسب صفتي الصبر والصمود اللذين مارستهما السيدة هاجر في سعيها بين جبلي الصفا والمروة بحثًا عن الماء لابنها. لكن بعد رفعها إلى مصاف النسب الأمومي المقدس يهبط بها مرة أخرى إلى اليومي والمعيش، “فيركض الزمن القديم بها/ إلى عبث ضروري”. بكل هذه السمات وقدراتها على معرفة كل ما يدور في عقل ونفس ابنها -محمود- يمهد الابن لصوت تعاليم الأم:
تزوّج أيّة امرأة من
الغرباء، أجمل من بنات الحيّ.
لكن، لا تصدّق أيّة امرأة سواي.
ولا تصدّق ذكرياتك دائمًا.
لا تحترق لتضيء أمّك، تلك مهنتها الجميلة.
لا تحنّ إلى مواعيد الندى.
كن واقعيًّا كالسماء.
ولا تحنّ إلى عباءة جدّك السوداء،
أو رشوات جدّتك الكثيرة،
وانطلق كالمهر في الدنيا. وكن من أنت حيث تكون.
واحمل عبء قلبك وحده…
وارجع إذا اتّسعت بلادك للبلاد وغيّرت أحوالها…
تتدفق تعاليم الأم متخذة من فعل الأمر المتكرر نبرة حزم، لكنه يتضمن توجيها بفعل يؤشر على التفهم والحكمة الكامنين في خطابها. وبما أن الشاعر هو الذي منحها صوتًا ليختم به القصيدة فيمكن أن نصل إلى استنتاج موقعها وحضورها في حياته، فهي التي “تضيء نجوم كنعان الأخيرة” حيث التشبث بالأمل حتى النهاية، “ترمي… شالها” في قصيدته.
لكن أحيانا ما تتكلم الأم منذ البداية لتسيطر على فضاء مفتتح القصيدة، كما فعل لانجستون هيوز -الشاعر الأفرو-أميركي- (1902- 1967) في قصيدة “الأم لابنها” التي نُشرت عام 1922. وقد برز اسم هيوز منذ أن نشر قصيدة “الزنجي يكلم الأنهار” وهو في السابعة عشرة من عمره، ثم تدفق في كتابة الشعر، والقصة القصيرة، والمسرح، والرواية. وقد كتب هذه القصيدة في ذروة نهضة هارلم التي استعادت الأصول التراثية للفن الإفريقي واستمرت هذه الحركة السوداء الجديدة حوالي عقد كامل، وكانت نهايتها 1930.
يمنح هيوز المساحة الشعرية كاملة لصوت الأم التي تحكي عن الصعاب التي واجهتها في حياتها وتوصي ابنها بعدم الاستسلام لليأس. وفي حين أقر درويش أن المنفى صنع لغتين، واحدة دارجة وأخرى فصحى، فإن هيوز يكتب القصيدة باللغة الدارجة (ولكنها لا تظهر في الترجمة) التي يستخدمها الأميركان السود، وهي وسيلة للحفاظ على الهوية في مواجهة تمييز عنصري صارخ واحتقار للون الأسود. تعتمد القصيدة بأكملها على استعارة ممتدة حيث تشبه الأم طريقها في الحياة بالدرج:
حسنًا يا بني، سأخبرك
لم تكن الحياة بالنسبة لي سلمًا من بلور.
كان فيها مسامير حادة،
وشظايا،
وألواح مخلوعة،
وأماكن بلا سجاد على الأرض-
جرداء.
ولكن طوال الوقت
كنت أتسلق
وأصل إلى منبسطات
وأنعطف عند زوايا
وأحيانًا ألج الظلام
حيثُ لا ضياء.
من الواضح أن الرحلة لم تكن سهلة، فهي مليئة بالمسامير والألواح والشظايا، حتى في حالة النزول لالتقاط الأنفاس كانت الأرض جرداء، والكثير من المساحات المظلمة. بهذا تعمل استعارة السلم على الربط بين الأعلى والأسفل، وهو ما يستحضر الإشارة إلى سلم يعقوب في سفر التكوين، ذاك السلم الصاعد إلى السماء الذي حلم به يعقوب فاطمأنَّ وزال عنه الخوف من أخيه عيسو. وقد انتبه العديد من النقاد لمغزى توظيف صورة السلم، وخاصة أن مارتن لوثر كنج الابن استخدمها أيضًا في واحدة من خطاباته، حيث قال: “الإيمان هو أخذ الخطوة الأولى، حتى لو لم تكن ترى بقية السلم”. المعنى متشابه في كل الأحوال: لابد من الصمود في وجه الصعاب وعدم الخضوع لليأس وهي الرسالة التي تحاول الأم شرحها لابنها. وكأنها خافت ألا تصل رسالتها كاملة، فراحت تشرح له في الجزء الأخير من القصيدة:
فإذًا، يا فتايَ، لا تتراجع.
لا تجلس على درجات السلم
لأنك تجد الحياة صعبة نوعًا ما.
لا تسقط الآن-
فأنا لا زلت أواصل يا حبيبي،
لا زلت أتسلق
ولم تكن الحياة لي سلّـمًا من بلور.
بالرغم من اختلاف السياق السياسي والمجتمعي، تتشابه تعاليم الأم في القصيدتين؛ فالأم عند درويش التي خبرت الاحتلال والنزوح وسلب الأرض تؤكد عليه: لا تصدق، لا تحترق، لا تحن -والحنين قد يكون نقطة الضعف التي هي على وعي بها ولذلك تقول: ارجع، لكنه رجوع مشروط “إذا اتسعت بلادك للبلاد وغيرت أحوالها”. تشترك أوامرها في كونها تهدف إلى الحماية. على الجانب الآخر، جاءت خبرة أم هيوز مختلفة في السياق ومتشابهة في القهر، فهي خبرة التمييز العنصري القميء، فتقول: لا تتراجع، لا تجلس، لا تسقط. وبذلك يُعد التشجيع على المواصلة والمثابرة هو المشترك الدلالي. وفي النهاية تقدم نفسها كمثال على الصبر: لا زلت أواصل… لا زلت أتسلق.
يكتب الشعراء عن أمهاتهم أيضًا من أجل التماهي معهن، الذوبان في كينونتهن، بحثًا عن الأمان أو هروبًا من واقع مؤلم، أو في محاولة لخلق حياة أخرى. في قصيدة “زهرة الحزن” للشاعر البحريني قاسم حداد يتجلى الواقع المؤلم لأحوال الوطن الذي يزج بالشعراء في السجن، فيستدعي الشاعر أمه مساويًا بين صوته الشعري وبين حضورها: “آه يا أمي/ لقد أعطيتني صوتًا له طعم الملايين/ التي تمشي إلى الشمس وتبني” ويكرر هذا التماهي قائلًا: “أنا منك كلام طالع كالبرق من ليل الأساطير”. ينسب الشاعر صوته لأمه، والصوت هو القصيدة، والقصيدة هي الوطن الذي خذله: “وطن يلبس قبل النوم تاريخًا/ وبعد النوم تاريخًا ويستيقظ بعد/ الموعد المضروب لا يعرف بابًا للدخول”.
كان الابن يحتمي بالأم: “كنت في صدرك عصفورًا/ رمته النار، سمته يدًا تخضر” لكن “ها عصفورك الناري في السجن يغني”. لم ينجح السجن في خنق الصوت، فهو لا يزال يغني، وهي صورة بلاغية معروفة في مقاومة القهر والسعي للحرية. وليدلل على عدم خنق الصوت يرصد أحوال الوطن في صور بلاغية متتابعة تعتمد على التشخيص، لكنه لا ينسى أن ينادي على الأم “التي خاطت لي الثوب بعينيها” ويتمنى في شكل سؤال بلاغي: “لماذا لا يمر الثوب بالسجن/ لماذا لا تخيطين لنا أثوابنا الأخرى/ تمدين المناديل التي تمسح حزني/ ولم الرعب الذي حولني شعرًا/ على جدران سجني”. وكأن الثوب الذي يربط ما بين الداخل أي السجن والخارج وهو الأم وعينيها هو الأمل الذي يتشبث به حداد في مواجهة “وطن يلبس عنوان السلاطين وسروال الملوك”. لكن هذا الوطن بالنسبة له ليس إلا غربة لا يكاد يتعرف عليها؛ فالوطن الذي يعرفه هو وطن أمه “التي تنسج ثوبًا للسجون”. تتقوض هذه الفكرة مباشرة؛ لأن هذه الأم “تخرج الآن مع الحلم”. في هذا التأرجح بين الأم والوطن الغريب والوطن الذي يعرفه، يصل حداد إلى فكرة الوطن الأم وتسقط الحدود بينهما: “هذي بلادي، هذه أمي/ لا أدري حدود الوطن الأم”. الأم هي الوطن وهو ما يجعله قادرًا على المواصلة.
أحيانًا ما تتخذ رغبة التماهي مع الأم والذوبان فيها أشكالًا أخرى، كأن يتحول الابن والأم إلى جزء من الطبيعة. يتجلى هذا التماهي في قصيدة “غيوم وأمواج” للشاعر الهندي (البنجالي) روبيندورات طاغور (1861- 1941) والذي حصل على جائزة نوبل للآداب عام 1913 بعد أن قام بنفسه بترجمة ديوانه “قربان الأغاني” إلى اللغة الإنجليزية عام 1912. يكتب طاغور قصيدة “غيوم وأمواج” من خلال صوت الطفل (الابن) الذي يقاوم كل إغراءات اللعب واللهو البرىء من أجل البقاء مع أمه، وكأنه يحتمي بها من الوقوع في الإغراء فيقول:
أماه، إن قاطني العلاء، بين النجوم، يدعونني قائلين:
نحن نلهو منذ يقظتنا حتى آخر النهار، عابثين بالفجر الذهبي، وبالقمر الفضي.
وأسألهم: ما السبيل للوصول إليكم؟
فيجيبون: تعالَ إلى حافة الأرض، ثم ارفع يديك نحو السماء، فتُرفع إلى النجوم.
أمام هذا الإغراء يتذكر الطفل أمه التي تنتظره في المنزل، ويقول لهم “كيف لي أن أتركها وآتي؟” ويعمل مباشرة على تعويض خسارة اللعب بإيجاد لعبة أخرى تسمح له بالبقاء مع أمه: “سأكون أنا الغيمة، وأنت القمر، يا أماه/ وسأغطي محياك بيديّ كلتيهما/ وسيصبح سقف بيتنا سماء زرقاء”. عبر أنسنة الطبيعة يتيقن الطفل من بقائه مع أمه في لعبة أبدية. وعندما يتكرر الإغراء مرة أخرى من قاطني الأمواج يسأل الطفل: “ولكن عندما يحين المساء، لن تحتمل أمي غيابي، فكيف لي أن أهجرها وأمضي؟” وعندها يبتكر لعبة “أكثر مدعاة للتسلية”:
سأكون أنا الأمواج، وستكونين أنت يا أماه، الشاطئ البعيد، وسأزحف وأزحف، ومثل موجة تتكسر، سترتمي ضحكتي على ركبتيك.
ولن يعلم أحدٌ في العالم مكاننا، أنا وأنتِ.
بهذه الاستعارة التشخيصية المركبة، يقاوم الطفل إغراءات اللهو واللعب التي تقدمها الطبيعة عبر التحول هو وأمه إلى جزء لا يتجزأ من الطبيعة، وهو ما يشي بالاتساق النفسي والتناغم الزمني والاعتماد المتبادل في العلاقة بين الأم والابن.
إذا كان طاغور الهندي قد لجأ إلى الطبيعة ليتماهى مع أمه، فإن الفلسطيني محمود درويش لجأ إلى اليومي والمعيش لتحقيق هذا التماهي. اشتهرت قصيدة “أحنُّ إلى خبز أمي” بسبب قوله: “وأعشق عمري لأني/ إذا متُ/ أخجل من دمع أمي!”. من كثرة اقتباس هذا المقطع تحول إلى كيتش يتم توظيفه في سياقات متعددة وأحيانًا متنافرة. لكن ما يلي هذا المقطع يُحول القصيدة إلى فكرة مبنية على اليومي والمألوف؛ فالابن يناشد أمه:
خذيني، إذا عدت يومًا
وشاحًا لهدبك
وغطّي عظامي بعشب
تعمّد من طهر كعبك
وشدّي وثاقي..
بخصلة شعر
بخيط يلوّح في ذيل ثوبك..
عساي أصير إلاهًا
إلاهًا أصير..
إذا ما لمست قرارة قلبك!
فحتى إذا مات ستعيد أمه بعثه عبر التماهي معه من خلال أهدابها والعشب الذي سارت عليه، وشعرها أو خيط منفلت من ثوبها. ليس فقط أنها ستبعث فيه الحياة، بل سيتحول إلاهًا. بعد هذا الارتفاع إلى مصاف القديسين والقديسات يهبط درويش إلى الدنيوي والعادي: “ضعيني، إذا ما رجعت/ وقودًا بتنُّور نارك.. / وحبل غسيل على سطح دارك/ لأني فقدت الوقوف/ بدون صلاة نهارك”. يأمل الشاعر أن يتحول إلى جزء من الروتين اليومي للأم بما يحقق له التماهي المنشود. بمعنى آخر، أدى غيابه عنها إلى فقدان القدرة على الصمود. ومن المعروف أن درويش كتب هذه القصيدة أثناء وجوده في سجن الرملة بتهمة إلقائه قصيدة بدون تصريح. وقد كان على قناعة أن أمه تفضل أخته وأخاه عليه:
وعندما جاءت والدته لزيارته حملت معها القهوة والخبز، ومنعوها من إدخالهما وترجّتهم بما أوتيت من قوة ونجحت في الوصول لابنها؛ فاحتضنته كطفل صغير وهي تبكي، فقبّل يديها كما لم يفعل من قبل، وانهار الجدار بينهما، واكتشف أنه ظلم أمه، فكتب مساء اليوم نفسه قصيدة “اعتذار” التي اشتهرت كأغنية بعنوان “أحن إلى خبز أمي” أدّاها الموسيقي القدير مارسيل خليفة.
كأن الشعراء مهمومون دائمًا بالاعتذار لأمهاتهم. فعندما كتب جوزيف راديارد كيبلنج (1865- 1936) -البريطاني الذي وُلد في الهند- رواية الضوء الذي خبا عام 1890 أصرت أمه أن يجعل الخاتمة سعيدة لكنه لم يرضخ لها. وقد ندم بعد ذلك كثيرًا؛ فأرفق قصيدة في بداية الرواية -كإهداء لوالدته ليعتذر عن عدم تحقيق طلبها- وهي قصيدة يتسم بناؤها الإيقاعي بسمات أغاني الأطفال. بشكل ما، يكتب الشاعر عن أمه فتسيطر عليه روح الطفولة ويتمنى العودة لتلك المرحلة، إنها مرحلة الأمان والحب غير المشروط والبراءة. يختم درويش قصيدة “أحن إلى خبز أمي” بقوله:
هرمت، فردّي نجوم الطفولة
حتى أشارك
صغار العصافير
درب الرجوع..
لعشّ انتظارك!
** المصدر: “مجلة الجسرة الثقافية”. العدد: 63