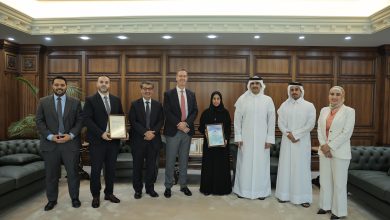الصراع الثقافي في الجزائر إرث استعماري

حسونة المصباحي
كان للشاعر الجزائري ميلود حكيم حضور لافت في مهرجان الشعر العالمي الذي انتظم في سيدي بوسعيد التونسية أواخر سنة 2016 التي ودعناها هذه الأيام. وقد وجد أحبار الشعر الذين استمعوا إليه وهو يقرأ قصائده في الساحات، وفي المقاهي ما أقنعهم بأن الشعر المكتوب بالعربية في بلد تعود شعارؤه على الكتابة باللغة الفرنسية، يشهد تطورات إيجابية على جميع المستويات.
الانغلاق انتحار
يقول حكيم، خلال لقائنا به في سيدي بوسعيد في صباح مشرق “جئت إلى الشعر من الدهشة التي كانت دليلي، وما زالت، ومن الأسئلة المعلقة للحيرة وهي تمتحن مجاهلها، ومن وعي شفاف بضرورة اكتناه حضورنا في العالم، واختبار الشعور بالتناهي والانتصار لأرضيتنا، والانفتاح بكل الحواس على الوجود المتجدد والحيوي، في تحولاته المنتصرة على العدم والتلاشي والزوال. كل هذا حفزني على البحث عن طرق ترشدني إلى المناطق العميقة في داخلي، وهي تستجيب لنداءات رافقتني بأشكال مختلفة، بعضها نابع من صداقات مع من اختبروا العبور السريع في الحياة من مبدعين وفنانين وشعراء وصعاليك ومغامرين وناس بسطاء، وكائنات، أي من الحياة في بساطتها الآسرة والمحيرة”.
متحدثا عن التأثيرات الأولى التي فعلت فيه يقول ضيفنا “أنا خلاصة كل ما رأيته وعشته وقرأته، لكن بالتأكيد هناك أسماء إبداعية قادمة من جغرافيات أدبية مختلفة، وشعريات عريقة كان لها حضورها المتميز في مساري، بعضها يمتد قديما حتى الشعر الجاهلي، والنصوص المؤسسة للذاكرة البشرية، وبعضها قادم من تجارب
متميزة في الشعر والفكر والأدب عموما، ومجالات أخرى، لأنني أتصور أن المبدع مطالب بأن ينفتح على كل شيء، وعلى المعارف والتجارب الإبداعية سواء كانت رواية، أم مسرحا، أم سينما، أم فنونا تشكيلية، أم غيرها. وأنا أعتقد بأن الذي يحبس نفسه في مجال واحد لا يمكنه أن يأتي بما يفيد وينفع، ويعمق تجربته. لذا سرعان ما يذوب وينتهي منتحرا بانغلاقه”.
وبمرارة يتحدث ميلود حكيم عن “سنوات الجمر” التي عاشتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي مشيرا إلى أن الجزائر كانت البلد الأول الذي عانى من الإرهاب الدموي في بداية التسعينات من القرن الماضي، وواجهته بمفردها، عندما كانت الكثير من البلدان تدعمه وتطبل له”.
يقول “لقد عشنا هذه المحنة بألم كبير وجراح لم تندمل بعد، فيها فقدنا خيرة مثقفينا ومبدعينا الذين اغتالتهم يد الإجرام. وقد بصمتنا هذه الفجيعة بميسمها، وتجلى ذلك في النصوص التي أبدعناها، سواء من حيث الموضوعات أو البنية والعوالم، التي أصبحت كابوسية وسوداء، محاولين أن ننتصر للحياة والأمل في الخراب الرهيب الذي أتى على كل شيء. أما بالنسبة إلي شخصيا فقد تمظهر حضور هذه الفجيعة منذ ديواني الأول ‘جسد يكتب أنقاضه‘، ثم أخذ أبعادا أكبر في ديوان ‘أكثر من قبر.. أقل من أبدية‘ وهي نصوص مسكونة بالموت والتراجيديا”.
أمراض الهوية
متطرقا إلى مشكلة الصراع بين الفرنكفونيين والمناصرين للعربية القائم في الجزائر، يقول الشاعر “أعتقد بأن المشكلة الثقافية في الجزائر، وفي البلدان المغاربية عموما، على علاقة بالإرث الاستعماري، وبالجراح والتمزقات التي عاشتها شعوبنا بسبب هذه الحالة. لكن حدتها في الجزائر كانت أقوى وأشرس، لأن فرنسا بقيت طويلا في بلادنا لمدة قرن وثلاثين عاما، وعملت كل شيء لتستبدل السكان الأصليين بشعب من الوافدين، فسعت إلى تحطيم كل ما يشكل كيان هذه الأمة ومقوماتها، ابتداء من اللغة والثقافة والمعتقدات والعادات، أي ما يكون النسيج الحي لهذا الشعب، والهويات المتعددة والثراء الواسع لهذا البلد الذي يمتد من سواحل المتوسط إلى أعماق أفريقيا”.
يتابع “بعد الاستقلال عاشت الجزائر تبعات هذا الاقتلاع، وكانت للاختيارات المخطئة نتائجها الوخيمة، خاصة التعريب الإجباري لأجيال من النخبة التي تكونت باللغة الفرنسية، دون الذهاب في ذلك بطريقة منهجية متدرجة، مما أحدث شرخا عميقا، حيث اختار البعض الصمت والتوقف عن الكتابة، مثل مالك حداد، الذي اعتبر اللغة الفرنسية منفى، والبعض اعتبر الفرنسية غنيمة حرب مثل كاتب ياسين الذي تحول إلى المسرح المكتوب بالدارجة، والبعض اختار الرحيل والمنفى كآسيا جبار ومحد ديب وجمال الدين بن الشيخ. كما برز جيل تعامل مع اللغة الفرنسية بمقاربة أخرى حاولت التخلص من آثار الجراح الرمزية والعنف التاريخي. مع ذلك تبدو الأمور مختلفة الآن بعد أجيال عديدة، وبعد التسييس المدمر لمسألة اللغة، والثقافات، والصراعات المجانية التي أضعفت التواصل بين من يكتبون باللغات الجزائرية”.
ويشير حكيم إلى أن هناك الآن انفتاحا على كل ما يكتب باللغة الأمازيغية، أو الدارجة، أوالعربية، أو الفرنسية، أو غيرها. ولم تعد المسألة اللغوية تطرح بنفس الحدة. كما أن قضايا الهوية والانتماء والمعتقد لم تعد لها نفس الحساسية بعد الضريبة الغالية التي دفعها الجزائريون من أرواحهم، ومن أحلامهم، ليكتشفوا أن الاختلاف والانفتاح والتسامح وقبول الآخر هي الحلول لوضع متأزم بسبب سموم وأمراض الهوية المنغلقة والقاتلة.
الشعر والترجمة
يعتبر ميلود حكيم، المولود في مدينة تلمسان ذات الملامح الأندلسية عام 1970، واحدا من أهم شعراء جيله. وقد أصدر إلى غاية الآن العديد من الدواوين منها نذكر “جسد يكتب أنقاضه”(1996 -منشورات الجاحظية- جائزة مفدي زكريا)، “امرأة كلها للريح”(منشورات الاختلاف- 2000)، “أكثر من قبر..أقل من أبدية” (منشورات البرزخ- 2003)، “مدارج العتمة”(منشورات البرزخ- 2007).
إلى جانب الشعر، ينشغل حكيم بالترجمة، وقد نقل إلى العربية قصائد للكاتب محمد ديب حملت عنوان “فجر إسماعيل”، إضافة إلى كتاب “الطقوس والطقوسيّات المعاصرة” للفرنسي مارتين سيغالان، و”المجتزاءات الأخرى للصحراء” لرشيد بوجدرة.
وقد ترجمت مختارات من شعره إلى الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنكليزية.
كما حظيت كتاباته بدراسات ومقاربات وضعتها ضمن تجربة جيل مختلف أسّس لحساسية جمالية شكلت قطيعة مع الميراث الأدبي الجزائري في مراحله المؤسسة والموالية حتى التسعينات، إذ تتميز النصوص هنا بـ”النبرة الخافتة والانتصار للهشاشة ولما هو حميمي” عند الإنسان، بعيدا عن الخطابات الظافرة، العالية النبرة. وتجسد تجربة ميلود حكيم شعريا ما عاشته الجزائر خلال سنوات الإرهاب وانكسار مشروع الدولة الوطنية، والأحلام الكبرى لما بعد الاستقلال.
(العرب)