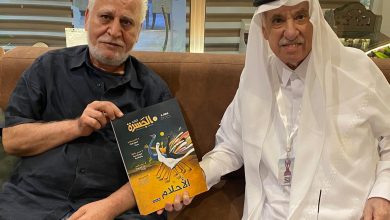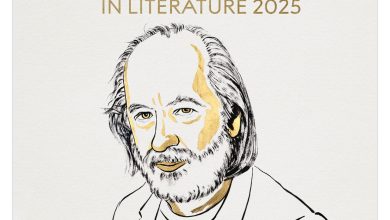الغناء الشعبي: انتفاضة قبل الثورة المضادة

الجسرة الثقافية الالكترونية-العربي الجديد-
*رائد وحش
حملت الانتفاضات العربيّة في بدايتها بشارة إحياء تراث الغناء المحليّ في البلدان التي اندلعت فيها، وذلك في الاعتصامات والمظاهرات. فعلى امتداد خريطة الثورات والانتفاضات، رأينا تعبيراتٍ غنائية وموسيقيّة تؤكّد على علاقة الناس المشيميّة بواقعهم وثقافتهم، بعد زمنٍ كثرت فيه نواقيس الخطر بخصوص اندثار الموروثات المحلية. بل رأينا، في أحيانٍ كثيرة، أن في هذا التراث أبعاداً ثورية، لم نكن لننتبه إليها في السابق.
من اللافت أنّ الأدبيات الشعبيّة تصدّرت المشهد بالآلية ذاتها في مختلف أنحاء المنطقة العربية، ويمكن لنا أن نراجع الأحداث لنرى ما هو إسكندراني وبورسعيدي يعلن عن نفسه، كما يمكن أن نرى ما هو جنوبي في تونس، وما هو حوراني وحموي وجزراوي في سوريا.
كانت تلك اللحظة توحي بالعودة إلى الذات، خلال عملية بناء ذاتي جارية في سياق طبيعي، وكان الغناء، إلى جوار اللافتات والملصقات وسواها، يقوم بأدوار تجسّد الأفكار المتفق عليها، قبل أن ينكسر الحلم، ويتحوّل، باحتلال الأصوليين المشهد، من أناشيد ترفض الجور والقهر إلى صرخات ثأر قادمة من عصر الكهوف.
قبل هذا، كانت فلكلورات العرب تعيش مشهداً سياحياً، اتفقت الدول والمؤسسات على تحويلها إلى استعراضٍ رخيصٍ، كما لو أننا أجانب أنفسنا. تنجو من هذا الحكم محاولات كثيرة لفنانين وفرق شبابية حاولوا العودة إلى التراث، كما فعلت فرقة “ثنائي سيدارة” المتخصصة بفن المقام العراقي، أو الفنانة الفلسطينية سناء موسى، أو المصرية دنيا مسعود التي تقدّم تراث النوبة.
لكنّ بعضهم مزج المحليّ بموسيقى لا تخصه، وبات حُسن النيّة الرامي تسويق الذات في الغرب نوعاً من التغريب، إذ لماذا لا نستهدف أبناء الثقافة نفسها؟ ولماذا لا نشتغل على قديمنا بأدواتنا الجديدة؟ الفلسطينيون أكثر من اشتغل على التراث في سبيل إظهار ثقافة شعبٍ كان ولا يزال موجوداً قبل الاحتلال، ولتأكيد هويته وتجربته في الزمان والمكان. فنانون كأبي عرب، وفِرَقٌ كـ”العاشقين” و”الأرض”، ساهموا بقوة في ذلك.
في سوريا انطلقت الصرخة من حوران، وهي منطقة غنائية بامتيازٍ، تتلاقى فيها تقاليد الفنون البدوية والريفية، وغنائيات السهل والجبل، على ما بينهما من اختلافاتٍ. وقد استطاع الحوارنة أن يحوّلوا أهازيج الأفراح والفراقيات والحروبيات التي تعود إلى مئات السنين، إلى صرخات غضبٍ في وجه النظام. ولا ننسى جملتهم التي دوّت في أرجاء سوريا كلها: “سوريا لينا وما هيّا لبيت الأسد”؛ ففي تلك الأهزوجة، المنتمية لما يعرف بفن “الجوفية”، اختُصرت الحكاية كلها.
حين ظهرت “يا حيف” لسميح شقير، وهي أغنية عادية وُلدت في لحظة غير عادية، أتت في سياق الدور الذي أخذه الفن الشعبي على عاتقه. ولأجل هذا الدور قتل النظام المنشِد الشعبي إبراهيم قاشوش، ويحاول ما استطاع ضرب هذه الجبهة التي أرهقته، لا سيما ما قدّمه عبد الباسط الساروت، قبل أن يتحوّل إلى أحد نجوم الطائفية.
في هذا السياق، قدّم الفنان السوري وائل القاق عملاً موسيقياً فريداً، هو “نشامى” (2013). والكلمة التي تشير إلى الصفات الأصيلة في أبناء البلد من شجاعة ونخوة، لا تحيد عن دلالاتها في الألبوم. في اشتغاله على أبرز أغاني الثورة، استلهم القاق الروح السورية في هويتها المبنية على علاقة عميقة بالأرض، كما استلهم الأسلوب السوري في تعبيره عن الأفراح والأحزان، وطقوس الخصب والحب والانبعاث.
اعتمد الألبوم على تسجيلات المظاهرات، فمن حمص أخذ أغنية عبد الباسط الساروت “جنة جنة”، ومن حماة اختار “يا محلاها الحرية” بصوت إبراهيم القاشوش، ومن ريف دمشق “ع الهودالك” كما غنّاها أهالي بلدة “الضمير”، إضافة إلى “عيني عليها” التي يغنيها أحمد القسيم على ربابة شادي أبازيد، وهي أغنية من لحن تراثي حوراني. كما تضمن الألبوم “جوفية” و”تقاسيم الربابة” وأغنية “يما”.
بعد الثورات المضادة، وصعود “داعش”، تغيّر كل شيء. لم يعد هناك وقت للغناء. ولعل الدلالة الكامنة في هذا التحوّل كافية كي نعرف لماذا تحوّل الصوت إلى صمت، أو حتى خرس.