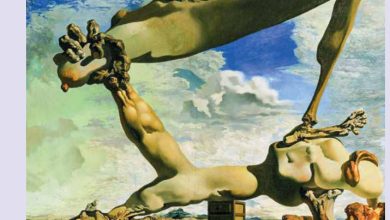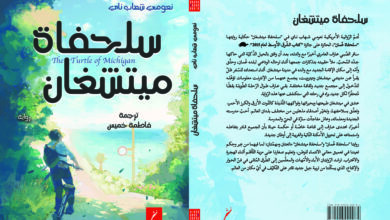اليهود في الأدب المصري … حنيـن أم رفض؟

عمار علي حسن
لم ينقطع وجود اليهود بشراً وديناً وطقوساً عن الأدب المصري الذي طرح هذه المسألة بنسبٍ متفاوتة وطرائق مختلفة. عند نجيب محفوظ، ارتبطت صورة يهود مصر بالمسرّة واللذة الجسدية، فيما احتل اليهود في أدب إحسان عبدالقدوس موقعاً عريضاً نسبياً، دفع الباحث رشاد عبدالله الشامي (مختص بالدراسات الإسرائيلية) إلى أن يقدم، قبل ربع قرن، كتاباً في عنوان «صورة المرأة اليهودية في أدب إحسان عبدالقدوس». وثمة أعمال نثرية مبكرة حول القضية ذاتها لتوفيق الحكيم وإبراهيم عبدالقادر المازني، إضافة إلى أبيات شعرية لأحمد شوقي وحافظ إبراهيم. لكنّ الوجود اليهودي عاد في الآونة الأخيرة ليشكّل ظاهرة في الأدب المصري لا ينبغي أن تمضي من دون رصد وتحليل. واللافت أن السرد الجديد تخلص من تأثير قيام إسرائيل وحروبها ضد العرب، على أدب المصريين في الفترة المترواحة بين 1948 و1979، خصوصاً في أعمال يوسف القعيد وجمال الغيطاني وفؤاد حجازي وغيرهم.
ذهب الراحل فتحي غانم إلى ما هو أبعد، حين اتخذ من إحدى القرى التي تقع على مقربة من القدس مكاناً لروايته «أحمد وداود»، فيما دارت روايتا صنع الله إبراهيم «أمريكانللي»، وعلاء الأسواني «شيكاغو» في الولايات المتحدة الأميركية، حيث نقع على شخصيات يهود، تقودنا إلى التمييز بين اليهودية والصهيونية. أما إبراهيم عبدالمجيد فكتب في روايته «طيور العنبر»، عن راشيل اليهودية التي غادرت الإسكندرية عام 1956، بعد قصة حب فاشلة. وربما لأنها كانت تنأى بنفسها عن السياسة، فلم يقع عليها، عبر النص الروائي، أي من حمولات الشك والتخوين والنبذ التي ظهرت في روايات أخرى. بل إن الرواية لم تكن تحبذ خروج اليهود من مصر أصلاً، لا سيما من الإسكندرية كمدينة كوزموبوليتية حضت كلّ مركبات المجتمع التعددي.
وإذا رصدنا المنتج الأدبي الحالي، نلاحظ أن روايات كثيرة صدرت في السنوات الأخيرة تعالج قضية الوجود اليهودي في مصر، هي: «أيام الشتات» لكمال رحيم و «سانتا تريزا» لبهاء عبدالمجيد، و «آخر يهود الإسكندرية» لمعتز فتيحة، و «حد الغواية» لعمرو عافية و «يهود الإسكندرية» لمصطفى نصر.
ركّز فتيحة مثلاً في روايته «آخر يهود الإسكندرية» على التعايش والتعددية الدينية التي كانت قائمة بين المسلمين والمسيحيين واليهود خلال أربعينات القرن العشرين، عبر قصة حب بين مسلمة ويهودي. على النقيض، دارت رواية «حدّ الغواية» حول قصة حب بين يهودية ومسلم، وهي في مضمونها تنأى عن المقولات الجاهزة والشخصيات المكرورة في الأدب المصري.
وقد أظهر كمال رحيم تعاطفاً نسبياً مع الشخصية اليهودية في روايته، متمرداً أيضاً على صورة «اليهودي» النمطية في الأدب والسينما. وتناولت «سانت تريزا» جانباً من حياة اليهود في مصر، مع المسلمين والأقباط، عبر شخصية لوكا، صاحب «أتيلييه» للملابس الذي جاء من اليونان إلى القاهرة ولم يرحل مع الذين ذهبوا إلى إسرائيل، غير أنّ العمل يصوّر حالة الضغينة بين المسيحيين واليهود، اتكاءً على الخلاف التاريخي بينهم.
أما رواية «يهود الإسكندرية» (مكتبة الدار العربية للكتاب) فتمزج التخييل بالتاريخ. ويعدّ كاتبها مصطفى نصر هو الأكثر تناولاً للموضوع في اتساعه وعمقه عبر التاريخ. تعرض الرواية شخصيات يهودية عاشت في الإسكندرية، راصدةً علاقاتها وتصوراتها وأحلامها، عبر مساحة زمنية طويلة.
تبدأ الرواية عام 1862 مع الخديوي سعيد، حاكم مصر وقتذاك، وعلاقته بحلاق الصحة اليهودي (جون)، الذي تمكن من مداواته، فقرَّبه منه، ومنحه أراضي كثيرة، فيبدأ أقرباؤه بالتآمر عليه، بل إن بعضهم راودَه حلم بأن يجعلها منطقة استثمارية، وبعضهم الآخر زادَ في حلمه، فأراد أن يجعلها وطناً بديلاً لليهود. وبالفعل أقاموا مجتمعاً خاصاً عليها، وتناسلت الأحلام منداحة في حارات يهود الإسكندرية، بل انتقلت إلى سائر مدن مصر، لتختمر فكرة قتل جون وإقامة ضريح له يصبح مزاراً لليهود من شتى أنحاء العالم. ومن ثمّ تمضي الرواية في الزمن عبر أجيال متلاحقة، نصل معها إلى الزمن المعاصر، لتظهر شخصية أنور السادات – في الجزء الثاني – الذي يتصل بأحد التجار اليهود بغية الحصول على قنابل يدوية للثوار المناهضين للإنكليز. وحين يغدو رئيساً للجمهورية في ما بعد، يلتقي بابنة ذاك التاجر (جوهرة)، التي ربطته بها علاقة طيبة، فيدعمها لتصير من أهم سيدات الأعمال، قبل أن تنزلق إلى تجارة العقارات والمخدرات… ثم تحاول استعادة قبر جون لتحويله إلى مزار سياحي يقصده كل اليهود الذين صاروا «يخرجون بالشموع ليلاً للاحتفاء به»…
تنبش الرواية في سلوكات اليهود عبر الزمن، من خلال التقاط نماذج بشرية يغلب عليها الجشع والطمع. بهذا، يعيد الكاتب مرة أخرى تكريس الأدب لصورة اليهود النمطية التي حاول بعض الأدباء التمرد عليها، وإعادة صوغها في حالة حنين، ليس إلى زمن اليهود في مصر، بل إلى مجتمع مصري منفتح، يعانق التعددية ويرفض التعصب الأعمى. لكنّ رؤية نصر التقليدية لا تحمل نزعة انتقامية من اليهود، بل تعبر عن حالة انشغال عام بالتاريخ الاجتماعي الحديث والمعاصر لمصر، الذي كان اليهود يشكلون جزءاً مهماً منه لا يمكن تجاهله.
(الحياة)