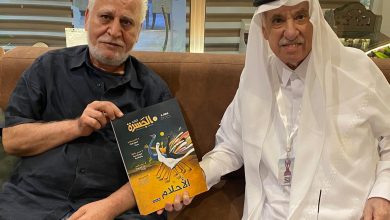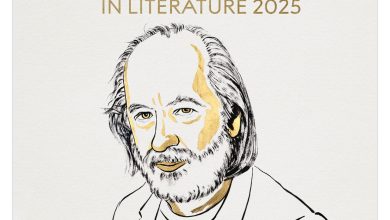راتب شعبو يهدم «جدران» سورية أحمد زين الدين

الجسرة الثقافية الالكترونية
*أحمد زين الدين
المصدر: الحياة
أتاحت خلخلة النظام السوري الفرصة لأن يتحرر العديد من الأدباء والشعراء من عيون الرقباء، ومن بطش الأجهزة الأمنية التي حالت دون كشف المستور أو سقوط التابوات السياسية. وأفرجت تطورات الأحداث الدامية عن حياة كانت محجوزة ومكبوتة داخل النفوس، وخلف جدران السجون والمعتقلات. صحيح أنّ بعض ما كان يدور هناك، كان يتسرّب إلى ذوي المعتقلين والمفقودين، لكنه لم يستوِ على قاعدة بناء فني وجمالي. وظلّ حديث السجن الأكثر تداولاً وتمظهراً، فكأن السجن مَعلم أساسي في حياة السوري وذاكرته. لذا شهدنا غزارة في الإنتاج الروائي السوري الذي تناول السجن وأوضاعه المزرية، فقرأنا لياسين الحاج صالح ولؤي حسين وفرج بيرقدار ومصطفى خليفة، وطبعات الكترونية لآخرين. كما حبّر اللبنانيون الذين ساقتهم الأقدار إلى السجون السورية مذكرات، منها مذكرات علي أبو دهن «عائد من جهنم».
في الرواية/ السيرة للطبيب والكاتب السوري راتب شعبو «ماذا وراء هذه الجدران» (دار الآداب) نطالع شهادة حية عن كيفية اعتقال المؤلف في مطلع شبابه بتهمة أنه يساري ما بين عامي 1983 و 1999. وعن تنقله بين السجون خلال الثمانينات والتسعينيات، تحت حكم الرئيس حافظ الأسد.
في الرواية، يسبر الكاتب أغوار حياته وحياة المساجين من حوله، باختلاف عقلياتهم وسلوكياتهم وأمزجتهم وأطوارهم، متجاوزاً بذلك السيرة الذاتية، لتغدو سيرة شعب مسحوق. على أن الراوي هنا لا يقصّ على القارئ وقائع السجون فحسب، بل هو يمعن في تحليل كل كلمة أو ظاهرة أو حادثة، من خلال «إعادة تدويرها» – إذا جازت العبارة – بعد مرور سنوات عليها. أي إعادة التأمل فيها وتقليبها على كافة وجوهها، واستخلاص العبر منها. يتحدث هنا بعد هذه الأعوام الطويلة مزوداً بكامل مخزونه الثقافي والفكري الذي اكتسبه سابقاً ولاحقاً، ليضيء أمام القارئ الطريق إلى فهم معاناة السجن عامة، وانعكاسها على النفس البشرية.
ومع أن السيرة الذاتية تكون عادة أبرز أشكال كتابة «الأنا» وأمتنها صلة بفن السرد، فإن الراوي – المؤلف الذي يرسم ملامحها ويروي قصتها، يحيلنا إلى ذاتين متباعدتين في الزمن، متراوحتين بين لحظتين: لحظة الحياة في السجن، ولحظة الكتابة خارج السجن. وينجم عن هذا التباعد بين الذات الراوية والذات المروية، أن الذات الراوية الحاضرة الآن، تغتني بالذات الماضية التي عانت من حياة السجن والاعتقال، كمرآة تتأمل فيها نفسها، بعدما نضجت أفكارها وأحكامها ومشاعرها ورؤاها. واضعة هذه الحياة المقيدة تحت مجهر التحليل والتفكيك والتعليل.
صوت المثقف
هنا نسمع صوت الطبيب بعدما قضى محكوميته واستأنف تعليمه الجامعي، وصوت المثقف الذي زاد مخزونه من معلومات سيكولوجية وطبية واجتماعية، وبات أكثر قدرة على المقارنة بين الماضي والحاضر. بينما تتّسع ذاكرة السجين الذي كانه، لتضم ذاكرة الطفولة والعائلة والوطن، مستعيداً فنون السوريين الغنائية وتقاليدهم وذاكرتهم التاريخية القديمة والحديثة، دون أن ينسى الوصف الدقيق لمسارات التحقيق والتوقيف والمحاكمات وظروف السجن، وجبروت المحققين والشرطة والحرّاس.
ويقف الكاتب عند جسد المعتقل المعذّب، ونقاط قوته وضعفه، واختلاط الأحاسيس، وعلاقة الألم بالنفس. والصراع الخفيّ بين إرادتين: إرادة المحقق لإجبار المتهم على الامتثال لأمره، وتشبث المتهم بالمقاومة والمعاندة وعدم الانصياع. إنه ضرب من المبارزة بين الجلاد والضحية التي تخضع لسلسلة من التجارب والاختبارات المتدرجة في قسوتها، فتنتصر عليها حين تقف في وجه الجلاد، وتنهار حين تضعف أمامه.
لغة السجن
تستغرق عملية التعذيب الفصول الأولى من الرواية، ثم تُستعاد في سجن تدمر الذي ذاع صيت قسوته. والتعذيب على ما يقول ميشيل فوكو في «المراقبة والمعاقبة» هو إنتاج منظّم، وجزء من مراسم وطقوس، وعنصر من عناصر الشعائرية العقابية. إنه يرسم حول أو فوق جسد المحكوم بالذات إشارات ينبغي ألا تُمحى، بل يجب أن يتأكد منها الجميع، كما لو كانت انتصاراً للعدالة المزعومة. أما أنين المتهم وصراخه على وقع الضربات فليس بالأمر المخجل. إنه تكريم للعدالة بالذات حين تتجلى قوتها. هذا ما كان عليه القضاء الأوروبي منذ قرون بحسب فوكو. لكنّ وصف راتب شعبو الدقيق لعمليات التعذيب التي تعرض لها، هو وسائر المعتقلين في السجون السورية، لا يخرج عن هذا التصور القروسطي لمعنى العقوبة في ذهن المحقق السوري.
يرى الكاتب أنّ الأمن يعمل في السجن، وكذلك في البيوت، على إنتـاج- وإعادة إنتاج- الولاء والطاعة لدى الناس. أما فروع الأمن فهي ليــست إلا ماكينة تنتج في الوقت عينه، وبالآليـــة ذاتها، العناصر والكـــوادر الأكـــثر مناسبة لإنتاج الـــولاء. وما دور السجن إلا الحرمان من الحرية وزيادة في التقويم والتطويع والعزلة والانضباط والطاعة.
يفصل راتب شعبو بين تخيّل الألم والشعور به «فمهما حاولت أن تتصور الألم وتعيشه في خيالك وتحيط بأبعاده، فإنك لا يمكن أن تتمكن بشيء من حقيقته» (ص 31). طبعاً ثمة فرق أيضاً بين من هو داخل السجن ومن هو خارجه، إذ إن الوافد الجديد إلى السجن يحمل رائحة العالم الخارجي، ومع الوقت تتلاشى هذه الرائحة وتحل محلها رائحة السجن الراكدة. وللسجن أيضاً طقوسه ومصطلحاته ولغته، ولا بد من التآلف مع ذلك والاعتياد عليه. وقد دفعت هذه اللغة محمود حمادي إلى إعداد كتاب باسم «مفاتيح السجن السوري» يفسر فيه المصطلحات الواردة على لسان السجانين والسجناء، أو ما يسميه الكتاب «اللغة السجنية». ولكل سجن في الحقيقة مفردات عامة ومتداولة ومفردات خاصة به، مثلما هي الحال في سجن تدمر. بل إن اللغة الخاصة في تدمر تعبّر وفق الكاتب عن موقع السجين الدوني وعن انسحاقه. وينحت شعبو كلمة «استدمار» ليدل على تجربة العيش في سجن تدمر المتميز بقسوته وخشونته، مستغلاً القرابة اللغوية بين دمّر ودمار النفس والاستسلام للخوف. مقابل كلمة الاستحباس أي التأقلم مع الحياة في السجن، وإذابة الفارق بين عالم الخارج وعالم الداخل.
ولعل تجربة السجن في مجملها ليست إلا هذا التأرجح بين التعلق بما وراء جدران السجن، والاعتياد على العيش في داخله. هذا التأرجح ظل يلاحق الكاتب حتى بعد انتهاء محكوميته متسائلاً في الصفحة الأخيرة من سيرته، إن كان خروجه من السجن كافياً لخروج السجن منه. وتعبرّ هذه السيرة الرائعة التي بين أيدينا عن التأرجح أو الجدلية النفسية بين هذين القطبين.
وفي المقابل، ثمة علاقة أساسية بين السجين والزمن وكيفية التعامل معه، لذا يسمي شعبو نفسه وهو في السجن «حارس الزمن». في البداية يبدأ زمن المعتقل ثقيلاً وبطيئاً، لأنه لم يتحرر بعد من صلته بالزمن الخارجي. ثم لا يلبث أن يستسلم لدورة الزمن في السجن، على رغم أن الخارج يحمل له أخباراً جديدة ورائحة جديدة.
لكل سجن عند راتب شعبو مزاياه وتاريخه وشخصيته المستوحاة من مكانه ومن نزلائه والمولجين به. والأمر يختلف باختلاف السجون ووظائفها، فبينما ينتصب «سجن تدمر» ككتلة من الجحيم لتدمير الإنسان، وكمظهر من مظاهر عدوانية النظام السوري ورعونة مخابراته ولا إنسانيته، فإن «سجن عدرا» يبدو أكثر طيبة، ويتخذ ملمحاً إنسانياً أكثر منه ملمحاً عدوانياً. كذلك نلمس صورة الشرطي أو الحارس المتباينة. فهي ليست في كل الظروف على سوية واحدة. بل تنقلب من وضع إلى وضع، ومن دور إلى آخر، فيأخد أحدهم صفة الجلاد عند وجود الضابط، ويتخلى عنها عند غيابه، ليغدو أكثر تعاطفاً وإنسانية مع المساجين لأسباب عديدة من بينها: أسباب طائفية أو مذهبية، أو أسباب مناطقية أو عائلية أو سياسية. «رأينا فرحة الشرطة بهذا الإفراج الكبير. فرحة لا يبررها سوى غلبة قوة الخير في نفوسهم على القسوة التي تفرضها عليهم وظيفتهم» (ص 174).
في حين يفتقد حراس سجن تدمر المشاعر الإنسانية، وترمي لغتهم البذيئة والسافلة إلى إذلال السجناء وتحطيمهم النفسي والجسدي، وتجريدهم من آدميتهم. وكأنهم فعلاً «حرّاس الجحيم».