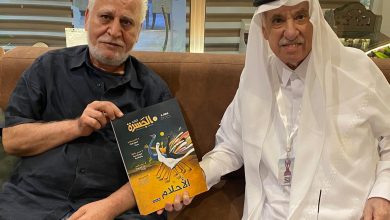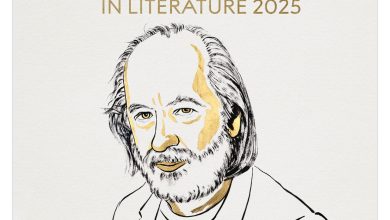ربيع مروة يبحث عن صورة الذات مسرحياً

الجسرة الثقافية الالكترونية
*سامية عيسى
المصدر: الحياة
في مسرحية «يمتطون غيمة»، يحاول المخرج المسرحي اللبناني ربيع مروة تأريخ ذاكرة الحرب الأهلية كثيمة تلازم أعماله المسرحية منذ أن بدأ عمله في المسرح في أواخر التسعينات. وهي حركة ثقافية تلت انتهاء الحرب «رسمياً» باتفاق الطائف. لكنها فعلياً لم تنته ولا تزال تزداد شراسة ووحشية، وإن تبدلت الأسماء واختلفت السياسات والأطراف والوسائل وأساليب خوضها. لقد كان من أكبر رواد هذه الحركة مدير مسرح بيروت آنذاك والروائي المعروف الياس خوري. وقد اشتغل ربيع مروة معه منفرداً كمثقف يناضل بعناد لتغيير واقع مأزوم امتدت عدواه لأكثر من بلد عربي، وما زالت تفوح منه روائح الجرائم.
بين العام والخاص
اختار ربيع مروة – المخرج الشاب «آنذاك» – خشبة المسرح مختبراً يستعيد من خلاله ذاكرة الحرب الأهلية وتأريخها. إنما هذه المرة من مدخل جديد مبني على قصة حقيقية بطلها أخيه «ياسر مروة» الذي يفقد ذاكرة الصور بسبب عطل ألمّ في تكوين دماغه إثر إصابته بطلق ناري في الرأس أصابه به قناص مجهول أثناء عبوره الشارع في زمن الحرب الأهلية عام 1987.
تزامن الحدث مع اغتيال جدّه المفكر والمناضل الشيوعي المعروف حسين مروة في اليوم ذاته لأسباب سياسية ممتدة في عمق الحرب اللبنانية. لكنّ تعرض ياسر للقنص لم يكن له علاقة باغتيال الجد، بل حادثة من يوميات الحرب تعرض لها وهو يعبر الشارع، ثمّ مضى في غيبوبة ألقي إثرها في براد المستشفى لاعتقادهم بوفاته لو لم ينتبه أحد الأطباء إلى أن ثمة رمقاً من الحياة ما زال ينبض في عروقه.
أجريت لياسر جراحة أنقذت حياته لكنه فقد قدرته على النطق، ثم ما لبث أن اكتشف هو ووالدته أنه فقد القدرة على التعرف إلى نفسه في الصور. وبرّر طبيبه الأمر بأنّ التلف الذي سبّبه الطلق الناري في نسيجه الدماغي نتج منه مرض الـ «أفيزيا»، أي فقدان القدرة على التعرف إلى نفسه في الصور أو ربط الصورة بالجسد المادي لها. بمعنى آخر، هو يدرك من هو ويتذكر نفسه، لكنه لا يعرف أنه هو ذاك الذي في المرآة أو في الصورة. أو أن الصورة تمثل شخصه.
يبدأ ياسر بعد حين محاولة تأهيل جسدية وكلامية وذهنية في عناد متواصل لاستعادة مهاراته الطبيعية، ما أمكن. يحقق ياسر النجاح النسبي لكنه يطلب المزيد. يطلب أن يحكي قصته في المسرح. فيصبح هو الحكواتي والممثل وصاحب القصة من خلال تدعيمها بأشرطة مدمجة يختلط فيها تاريخه الشخصي بالتاريخ العام، وتاريخ عائلته وأصدقاء العائلة في محاولة حثيثة للتذكر تصل به لزيارة الموقع الذي كان يتمركز فيه القناص المجهول الذي أطلق عليه النار، هو «العابر المجهول» ياسر. وما بين هذين «المجهولين» تلقي هذه الجريمة – بكل عبثيتها – الضوء على ذاكرة تمعن عمداً بالنسيان. ذاكرة مجتمع بأكمله يعتقد واعتقد أو أريد له أن يعتقد أن النسيان والقفز عن المحاسبة ونقد ذاكرة الحرب يمكن أن يدفع لبنان بالمضي قدماً، وهو ما لم يحصل. لكنّ ياسر يريد أن يتذكر، أما حياته وقدرته على العيش فتعتمدان على التذكّر لا على النسيان. ولا شيء كالصور التي تأتي وتغيب كالوميض يمكن أن تعيد له ذاكرته إذ يتمسك بها، علماً أنّ ياسر يعاني من عدم قدرته على تذكر الصورة نفسها وما تمثل.
وعلى مدى أكثر من ساعة ونصف تقريباً، يواصل العرض المسرحي تمدده الدرامي البطيء كأن الخشبة مصابة بدوار الذاكرة بحيث يحدث التذكر عبر شرائط مدمجة يعرضها ياسر، وهي تمثل جزءاً من ذاكرته أو بعضاً منها. «عشرون شريطاً» لم يخترها هو، بل المخرج (ربيع شقيقه)، فما كان من ياسر إلا القبول لأنّ ربيع هو المخرج في النهاية.
دلالات ورموز
تتخلل العرض المسرحي فيديوات سينمائية اعتدنا أن نراها في خلفية خشبة مروة كجزء من العرض المسرحي لا تقل براعة وإبداعاً عن مسرحه، مقرونة بالموسيقى الزاحفة على امتداد صور ياسر وهو يتنقل بين الأزقة والظلال وأطلال خطوط التماس، تتداخل معها صور الرموز الشيوعية مثل لينين وماياكوفسكي والجدّ والعائلة، يعلو فيها صوت الصمت حيناً ويخفت مع وجه ياسر وحكايا افتراضية مع لينين بصفته صديقاً للعائلة.
وما بين مشهد وآخر يتغير شكل ياسر ووجهه ويتبدل حتى يصيبه الدوار فيهيم في المشهد ونهيم معه حتى نشعر بأننا نضمحل ونرغب بأن نستعيد ذواتنا ونتذكر، كي نتخلص من ثقل الخفة التي تعشش في النسيان.
يحدث هذا على الخشبة فيما يتحرك جسد ياسر المتهالك نتيجة الإصابة وبقايا شلل في الأطراف وبطء في حركة جسد ما زال يعاند الشلل توقاً للحياة. كل ذلك عبر رواية حكايته التي تمتد رجوعاً إلى ما وراء زمن الحادثة. إلى بداية طفولته عبر شهادات علاماته أو استمارات تقويمه في فترة الحضانة. فتحول الحكاية نفسها إلى نهج للتذكر توحي بما لا يقبل الشك بمحاكاة أصيلة للجسد اللبناني والهشاشة التي كان عليها ما قبل الإصابة (الحرب) في حكاية تماه عميقة – أو هكذا – أحببت أن أراها – في محاولة حثيثة لالتقاط إشارات التصدع الأولى.
بداية، تمّ عرض العمل في رعاية «أشكال ألوان» في بيروت لأيام قليلة كعرض خاص، وهو تكتيك يتبعه ربيع مروة لتجنب مقص الرقيب أو المنع من العرض وليحافظ على حريته المطلقة في التعبير على الخشبة في بلد يحكمه أمراء الطوائف والحرب ممّن تنمو تحت إبط كل واحد منهم «مسلة تنعره». هكذا، انتقل ربيع مروة بعروض المسرحية خارج لبنان وفي مدن أوروبية كعادته، للتخلص من عبء الرقيب ولممارسة فنّ هو بمثابة الرئة التي يتنفس منها، وهي طريقة لا تقل عبقرية عن أعماله نفسها. فالتحرر من الرقيب ومن نظام ديكتاتورية الطوائف يعدّ عملاً بطولياً بذاته، لا سيما في هذه الأيام السوداء التي يمر فيها، ليس لبنان فقط بل عالم بأسره يبحث عن مخرج من هذه العتمة المغرقة في
ذاكرة الحرب
شاهدت المسرحية في مدينة أوسلو على خشبة مسرح «بلاك بوكس». كنت دخلت المسرح ولدي معلومة بسيطة عن هذا المرض الدماغي. وظننت أن ربيع كان يستلهم من قصة مرض أخيه شيئاً ما يسقطه على الأحداث الجارية في عالمنا العربي التي تخطت مآسي الحرب الأهلية اللبنانية، والتي ترزح تحت فوضى هائلة من الحروب والجرائم وأمراء حروب جدد، ووصلت حدوداً غير مسبوقة لجرائم الحرب شوهت – وتشوه – صورتنا عن أنفسنا ومن نكون حتى بتنا لا نعرف أي منها يمكن أن يمثل صورتنا التي ربما لا نتذكرها، أو تجعلنا نتساءل: هل بتنا مصابين بـ «أفيزيا» جماعية حتى بات كل واحد منا لا يمكنه التعرف إلى نفسه.
لقد ضعنا ما بين نموذج صور «داعش بفرعيه السنّي والشيعي»، وما بين ضحايا بشار في سورية ونتانياهو في غزة وكل من هب ودب، وكأننا بتنا ندمن صورة الضحية لا حول لها ولا قوة. صور تداهمنا في عقر أعيننا كل يوم حتى بتنا غير قادرين أمام زحف الصور أن نحدد أياً منها هي صورتنا أو نربط بينها وبيننا أو ربما نعجز عن أن «نتذكرنا»؟
وهنا نتساءل إلى أي مدى يمكن مسرحية «يمتطون غيمة» أن تحاكي الجمهور النروجي، وأن تعكس له صوراً أخرى عن «نفسه»، لا سيما بعد مجزرة وحشية تعرّض لها أطفال النروج على يد أحد المتطرفين العنصريين قبل سنوات قليلة؟ فالواقع حين يتحول بنفسه إلى «رمز» يربط «الفردي» الخاص بالمشترك الإنساني «العام»، حتى على مستوى المجتمع البشري برمته.
ربما مسرحية ربيع مروة هذه المرة استخدمت الواقع «قصة أخيه» كرمز «مطلق» لما يحدث على مستوى العالم العربي، إذ ربما أصـبنا بطلقة قناص ما، أو بخلل دماغي جعل ذاكرتنا تفقد علاقتها بالصور التي تمثلنا أو لا تمثلنا حقـيقة. بل ربما هنالك شيء أكيد أن هذه الأفيزيا الجماعية التي ندور فيها تحتاج منا إلى إعادة التــذكر عبر أعمال فنية كبرى، في محاولة للوصول إلى بداية الحكاية التي ربما بدأت في لبنان كتجربة مصغرة أو ربما ما قبل لبنان بعقود هي «عمر النكبة»، أو ربما بقرون تمتد إلى «حرب داحس والغبراء» مروراً بحروب وحروب دموية لم نكف عن ارتكـابها، ثم نسيانها، ثم ارتكابها من جديد في تكرار عبثي لا يتوقف لذاكرة مثقوبة وصور منسية في ظلمة الخفة التي لا تحتمل.
ياسر الذي لا يحتاج لأن يتقن التمثيل، لكونه هو صاحب الحكاية وبطل المسرحية الأوحد والوحيد، كان يدرك بقوة الرمزية المطلقة لقصته، والتي تدفقت منها غابة من الرموز، وحاولت أن تحيي فينا ذاكرة الحرب، لأن الذاكرة «حياة» حتى لو كانت مثقلة بالآلام، بينما النسيان «موت». ونحن نريد، مثل ياسر ومثل ربيع، أن نحيا ونحلق عالياً في سماء حياتنا. نريد أن نتذكر مهما كلفنا ذلك من ألم.
«يمتطون غيمة» (سبق عرضها في 26 أيار – مايو ضمن دورة «أشغال داخلية» 2013 للجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية أشكال ألوان) مسرحية ملهمة بواقعية تخطت الرمز. وما أكثر ما يتحول الواقع المعيش الذي يتأرجح هذه الأيام بين الوطأة والخفة، إلى رموز وإشارات تدلنا على الطريق، وما علينا سوى أن نحدق بالصور ونتذكر أيها هي صورنا حقاً لكي نجري وراء الإشارات التي تدلنا «إلينا».