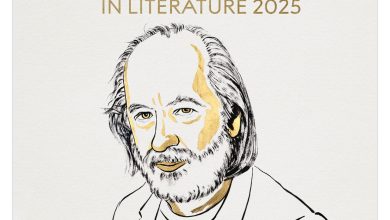سعيد عقل.. بين العظمة وجنونها

الجسرة الثقافية الالكترونية
*جهاد فاضل
المصدر: الراية
في هذا الكتاب عن الشاعر الكبير الراحل سعيد عقل: “سعيد عقل، العظمة وجنونها” ما يؤكّد عظمة هذا الشاعر وما يؤكّد جنونها في الوقت نفسه.
كان سعيد عقل شاعرًا كبيرًا لا ريب في ذلك والحداثة التي يلصقها بعض الباحثين عادة بهذا الشاعر أو ذاك، يلصقها آخرون بسعيد عقل الذي كان بنظرهم أوّل وأعظم شاعر حداثي في القرن العشرين. طبعًا وُجد قبله، ومعه، مجدّدون كثيرون، ولكنّ سعيد عقل كان أول من ترجم مفهوم الحداثة بين هؤلاء الشعراء في شعره. وبعد موته انصرف باحثون إلى قراءة الشعر الذي تركه، وتفحصوا هذا الشعر، فاعتبروه من أصفى الجواهر الشعريّة العربيّة في القرن العشرين. وقد ذكر بعض هؤلاء أن سعيد عقل كان “فلتة” الشعر العربي الكبرى في هذا العصر. ولهذا أسبابه التي سنعود إليها في هذا البحث. أما “جنون العظمة” الذي ترى الباحثة كاتيا شهاب أن الشاعر كان يحمله، فلا يجادل أحد في أن الشاعر كان يحمل فيروسه. ولعل الكثيرين من زملائه الشعراء لا يخلون منه. وسواء كان الشاعر، أي شاعر، مُصابًا به، فإنه لا يعيبه، فالأدب ينفخ، كما يقولون في بعض الكتب القديمة. ثم إن ما يُعتد به ليس ملفّ الشاعر لدى طبيب الأمراض العصبية أو العقلية، إن وجد وإنما النصوص الشعرية التي تركها. أما الشعور بالعظمة فإننا لا نستطيع إنكاره أو الاحتجاج عليه من أناس يشعرون بالتفوق والفرادة ويقابسون القيم العليا ويأتون بالجميل وبالخالد.
ولا ريب أن حكاية سعيد عقل كشاعر يمكن أن تفيد فائدة كبيرة شعراء زماننا الراهن. وأول ما يُستفاد منها أن الشعر ليس فقط موهبة، وإنما هو علم وصناعة وكدّ وجهد. فالشاعرية وحدها لا تصنع شاعرًا، وإنما تصنع هي هذا الشاعر بالاشتراك مع الثقافة الإنسانية، العربية والأجنبية. ومن يقرأ سيرة سعيد عقل كما رواها عدد من الباحثين، يجد أنه عكف على القراءة منذ بداية وعيه، أو منذ العاشرة من عمره على الأكثر، لأنه استوى شاعرًا كبيرًا وهو دون العشرين من عمره. وقد بدأ ينشر في الجرائد وهو في الثامنة عشرة من عمره، ولكنه كان يقول إنه لا يعترف بالشعر الذي نظمه قبل العشرين من عمره. وفي عام 1935، وهو في بداية العشرينيات من العمر ينشر أبحاثًا عدة في مجلة المشرق تتناول الشعر والفن عامة، وقد قال فيه المستشرق لامنس: “لأول مرة نرى مثل هذه الأبحاث في تاريخ الأدب العربي”، وكان لامنس من كبار المستشرقين في زمانه.
يحتوي كتاب كاتيا شهاب على أبحاث ودراسات شتى عن الشاعر، كما يحتوي على حوارات جرت معه، ولكنه يحتوي على دراسة شديدة الأهمية للباحثة الفلسطينية الكبيرة سلمى الخضراء الجيوسي تتحدث فيها عن تجربة هذا الشاعر وإثره في الشعر العربي المعاصر والحديث. فهي ترى أن سعيد عقل يبقى أفضل من يمثل في الشعر العربي نظرية الرمزية كما عرفها الأوروبيون منذ القرن التاسع عشر.
نشأ سعيد عقل في زحلة، وهي مدينة لبنانية صغيرة قرب بعلبك، ودرس في مدرستها الشهيرة: الكلية الشرقية. وقد عُرفت هذه المدرسة بتراث لغوي قوي، ودرس فيها من المشاهير من أمثال خليل مطران وعيسى إسكندر المعلوف. درس سعيد عقل الشعر القديم، واطلع على شعر القرن العشرين كما يمثله أحمد شوقي والأخطل الصغير، كما كان شأنه كغيره من الشعراء في زمانه. ثم شرع وهو المسيحي، من تلقاء نفسه، في قراءة القرآن الكريم، كما راح ينقّب في بطون المعاجم عن الكلمات النادرة المرنة القابلة للاستعمال المجازي الممتع وذات القيمة الموسيقية العالية، كلمات استعملها فيما بعد في شعره بشكل كثيرًا ما ترك أثرًا فعالًا لدى القارئ. هذا المنحى في التنقيب والبحث، وهو منحى أساسي في توجهه، يعكس وعيًا مبكرًا لملاحقة هدفه الشعري، ورغبة حقيقية في بلوغ هذا الهدف المعين. ولا شك في أنه لم يكن شاعرًا يترك الأمور للحدس وحده، أو للوحي الشعري، بل كان يتعمد متابعة ثقافته الفنية التقنية والسيطرة على أدواته الشعرية. وهذا التثقيف المقصود يفسر لنا غنى قاموسه الشعري، وبراعته اللاحقة في استعمال الألفاظ. وقد ساهم الكتاب المقدس (التوراة والأناجيل) والروايات الأسطورية الفينيقية كذلك في تكوينه الشعري.
وتتضح المؤثرات التوراتية في استخدامه المباشر لموضوعات عن الكتاب المقدس في كتابَيه الأولين: “بنت يفتاح” (1935)، وهو عمل درامي يقوم على مأساة بنت يفتاح في “سفر القضاة”، و”المجدلية” (1937) وهي قصيدة طيلة تتميز بجمال نادر، وتقوم على قصة مريم المجدلية ولقائها بالسيد المسيح. وتظهر المؤثرات الفينيقية في استخدام موضوع بطولي مستمد من الأساطير الفينيقية: وهي قصة “قدموس” أمير صور. ظهرت قدموس سنة 1944.
برز سعيد عقل في الثلاثينيات واستطاع الحفاظ على أهميته في الوطن العربي في عقد الأربعينيات كذلك، لكن أهميته الفعلية تضاءلت في الخمسينيات والستينيات، ولا سيما عند جيل الروّاد الصاعد، على رغم بقائه محط كثير من الاهتمام والنقاش. وقد غشّت عليه إلى حد كبير حركة الشعر الجديدة التي تنكرت لأسلوبه وللكثير من تطبيقاته ونظرياته. فلم يحدث فقط أن إبداعه القوي المبكر قد انزلق نحو التكرار والرتابة. بل إن المبدأ الذي اتبعه نفسه قُدر له أن ينهار. إن فكرة الفن للفن، والشعر الخالص، قد تعرضت لأشرس الهجمات من نقاد الخمسينيات، فلم تستطع الصمود في الوطن العربي الحديث، لا في المجال الأدبي ولا في المجالات الاجتماعية والنفسية والسياسية العامة السائدة آنذاك.
بدأ سعيد عقل يكتب الشعر ويحاضر فيه في عقد الثلاثينيات.
وأغلب تلك المحاضرات الأولى لم تنشر . لكننا نجد آراءه حول الشعر في المقدمات التي كتبها لأعماله الشعرية أو لأعمال آخرين. وربما كانت أهم أعماله حول النظرية الشعرية هي ما أثبته في مقدمة “المجدلية” ثاني كتبه التي نشرها . وثمة كذلك تلخيص مهم في “المكشوف” لسلسلة محاضرات ألقاها سنة ١٩٣٧ بعنوان “محاولات في جماليات الشعر” ويتضح في جميع هذه الكتابات التصاقه بمبدأ رمزي من فلسفة الجمال، وأنه رجع صدى قوي لمحاضرة الأب هنري بريمون بعنوان”الشعر الخالص” التي ألقاها عام ١٩٢٥ في الأكاديمية الفرنسية ، وفي كتابه الشهير الآخر عن الموضوع بعنوان “الصلاة والشعر” الذي صدر عام ١٩٢٦ وثمة كذلك انعكاس لبعض أفكار بول فاليري ولكثير من مفاهيم مالارميه عن الشعر في كتابات سعيد عقل.
الشعر عند سعيد عقل، خلاف النثر، نتيجة حالة إبداعية غير واعية وفي حالة اللاوعي هذه يسود نوع من الغموض يولد الإيقاع والهيمنات الأولى في القصيدة.
وإذا كانت الرمزيّة الغربية في أساسها “ديانة الجمال” فإن شعر سعيد عقل قد اجتهد عبر السنين ليبلغ هذا الهدف، وعلى رغم أنه لم يتمثل فعلً جميع التراث الفلسفي الذي نشأت منه الرمزية في الغرب إلا أن ثمة جهدًا دؤوبًا لجعل الجمال دينًا. وثمة نشوة جمالية تجري في تضاعيف شعره لكن التركيز الخاص المكثف الذي كان الرمزيون الفرنسيون يسعون إلى بلوغه لا يوجد إلا نادرًا في شعر سعيد عقل ومن أجل بلوغ الهدف الجمالي المنشود اضطر الشاعر مثل الرمزيين الفرنسيين، إلى مجانبة الكثير من خصائص الشعر المتعارفة. وكانت قوته مثل قوتهم، تكمن في الإخلاص لمثال من الجمال والحب فباستثناء”قدموس” لا يوجد في شعره أي توجه نحو الجمهور أو الاهتمام بموضوعات سياسية وباستثناء “قدموس” و”بنت يفتاح” ليس في شعره أي محاولة لخدمة أغراض غير ما يتعلق بجماليات الشعر.
ولا شك أن “المجدلية” هي أشهر أعماله وقد صدرت عام ١٩٣٧ وقد تعدّ هذه القصيدة الطويلة أفضل مثال في العربية على قصيدة رمزية تقوم على الرمزية الفرنسية كما عرفها القرن التاسع عشر.
وقبلها كان نشر مسرحيته الرمزية “بنت يفتاح” عام ١٩٣٥، وفيها يكشف شعره عن مزيج من الرومانسية والكلاسيكية وتنتثر فيه مقاطع غنائية تنم عن ميل الشاعر الطبيعيّ إلى الغنائيّ لكن رمزيته تظهر على أفضلها في “المجدلية” وهي وإن لم تكن قصيدة عظيمة، إلا أنها من أجمل القصائد في العربية الحديثة.
ويضم كتاب كاتيا شهاب حوارات أجراها مع الشاعر عدد من الصحفيين وفي هذه الحوارات نجد”أنا” الشاعر متضخمة ونجد الشعور بالعظمة بارزًا.
من ذلك قوله : “اللافت في شعري أنه فيه غرابة” وجمالاً غير موجود في الشعر الأوروبي كله، أي في شعر أثينا وروما وفرنسا. أنا أعرف شعرهم جيدًا ليس لديهم شعر بهذه اللعبة. هذا الأمر يبقى في بالي، وأنا أفتخر بأنني كتبت شعرًا غير مكتوب في ثلاث لغات تمتلك أجمل شعر في العالم وأعظمه (أثينا وروما وفرنسا) أنتجوا شعرًا هو الأجمل في العالم لكنهم لا يعادلون شعرًا قياسًا بشعري هذا الكلام فيه شيء من الكبر والافتخار بالنفس لكنه صحيح.
ويضيف :”إنني أريد أن يؤثر شعري على الشعر في العالم، وأريد أن ينتج شعر مثل شعري وأفضل وإذا كان سعيد عقل شاعرًا جيدًا، فعليه أن يؤثر ويترك شعرًا عظيمًا.
وحول تأثير الرمزية في شعره يقول:”كلمة رمزية وشعر رمزي لا تستوقفني. في شعري شيء من الرمزية لكن شعري أكبر من ذلك.
يضم شعري كل أنواع الشعر في العالم هؤلاء الذين يصدقون أنهم رواد مدرسة من المدارس ليسوا شعراء كبارًا. الشعراء الكبار هم الذين يجعلون كل أنواع الشعر تصفق لهم وليس فقط الشعر الرمزي. يجب أن يكون شعرك مشتملاً على كل أنواع الشعر وكأنه نوع شعري جديد لم يخلق مثله في كل شعر العالم”.
ويضيف حول تأثره بالرمزية: “هناك مدرسة رمزية والرمزية تمثل شيئًا صغيرًا في شعري. شعر سعيد عقل أكبر. هناك لعبات شعرية تخرج على أي نطاق معروف. الشعر بشكل عام يحتاج إلى جمال، وإلى غرابة ، وإلى شيء غير موجود وليس كل الشعر في العالم تتوافر فيه هذه الشروط.
وإذا كان الشعر ينتمي إلى مدرسة من المدارس، فهو ليس بشعر. عليك أن تكون من مدرسة لم يعرفها الشعر أصلاً.
وهو كما يقول لا يريد أن يضعّف المتنبي. المتبني برأيه شاعر كبير، لكن “يفترض أن يحكي المتنبي أكثر مما حكى، ويتعمق أكثر مما تعمق. شعري أنا أعمق من شعر المتنبي”.
ويستشهد بالشاعر سليمان العيسى الذي قال، كما روى “إذا العرب أعطوا سعيد عقل كل مئة سنة لعاشوا مليار سنة”.
لماذا لم تقل هذه الكلمة في شعر المتنبي، أو في أي شاعر عربي آخر؟
وعندما يقول له الصحفي إن معجمه الشعري محدود يجيبه إن معجم الشعراء والفلاسفة الكبار محدود كثيرًا. مثلاً “كانط” كتب كل فلسفته في ٥٠٠ كلمة!
وعندما يقال له إن عالمه الشعري محدود، يرد :”ابن الأثير وهو أعظم ناقد عند العرب يقول: الذي يقول إن لفظة الخنشليل مثل السيف، والعسلوج مثل الغصن ، والعدكوس مثل الأسد، لا ينبغي له أن يكلم بلسان” هناك ألفاظ شعرية وهناك ألفاظ غير شعرية وهناك ألفاظ ليست كثيرة الشعرية، إلا أنها تأخذ شعريتها حسب وضعها في الكلام، يقول إن الأثير “وإنما الألفاظ تحسن في مواضعها”، ويمكن أنا في ٦٠٠ كلمة أعطيت أفكارًا وصورًا أكثر من الذين يثرثون بالآف الكلمات”.
ويبدي رأيه بعدد من الشعراء على الصورة التالية:
# إيليا أبي ماضي؟
– لديه قصائد جميلة : كل الشعراء لديهم ما هو جميل.
# الأخطل الصغير؟
– لديه شعر حلو، ولهذا السبب أوحى لي بقصيدة عظيمة فيه
# أديب مظهر؟
– أثر على عدد من الشعراء منهم صلاح لبكي . له قيمة.
# عمر أبوريشة؟
– كنت أحبه. لديه شعر حلو.
# أحمد شوقي؟
-يكفي أن يكون قد تغنى بزحله!
# نزار قباني؟
– شاعر شاعر!، هذا الشاعر يكفي أن يكون قد قال:”سعيد عقل أكبر شاعر عند العرب إذا كان يرضى”! فقلت له : لا يا نزار أنا أفاخر بذلك ولكن إذا كان يرضى.. هذه الكلمة فيها كبرياء، ولذلك بشعة. أنا أكون سعيدًا عندما يقول العرب عني إني أفضل شاعر!
# خليل مطران؟
– لديّ قصيدة شهيرة فيه، وله تمثال في بعلبك كتبت من خلاله قصيدتي.
# محمود درويش؟
– لم أعرفه. لم أعرف شعره ولهذا لا أستطيع مدحه أو ذمه. لم أقرأه.
– ويعود ليتحدث في الشعر: العاطفة شيء ضروري في الشعر، ولكن الشاعر يجب أن يكون لديه ما هو أكبر من العاطفة يجب أن يكون لديه جمال وسحر وشيء جديد لم يخطر ببال أحد سابقًا لا صناعة في الشعر، الشعر كله جمال في جمال”إذا كنت ابن الجمالية وتستغل كل الوقت بالجمال وتتعمد بالجمال، إذن أنت شاعر”.
ويتلافى التعرض للحداثة خيرًا وشرًا:”الحداثة لا أريد أن أهاجمها، ولا أريد أن أحكي عنها لا بالإيجاب ولا بالسلب كل ما أريد قوله هو :إذا أردت أن تكتب شعرًا، فهذا يعني أن الناس يفترض أن تصرخ بأن ما تقوله شيء غريب وجميل وجديد ولم يكتب مثله قبل اليوم. إذا لم يقل في شعرك هذا الكلام، فأنت لست بشاعر”.
هذه صور من سيرة شاعر كبير رحل قبل عدة أشهر وترك الكثير من القصائد الجميلة التي تغنّي بعضها المطربة الكبيرة فيروز.
ومع صور من سيرة الشاعر نقلنا نماذج من آرائه حول الشعر والشعراء. قد يكون في آراء سعيد عقل هذه ما يرضي البعض وما لا يرضي البعض الآخر، لم يكن يعنيه رأي الآخرين كثيرًا على أن الأكيد أن الشاعر ترك وراءه دويًا وسجالاً لا ينتهي حتى يتجدّد وتلك شيمة من شيم العظماء والتاريخيين الذين لا يخلون في العادة من أمراض العظمة!.