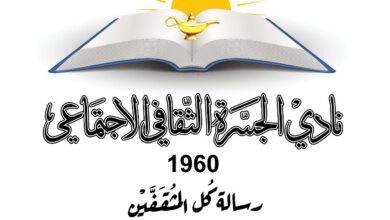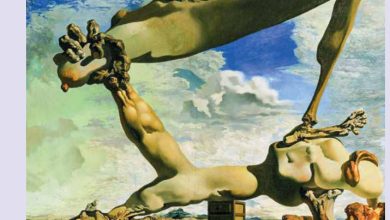قصيدةُ النَّثر… خروجٌ من عالمٍ مُغلق – مروان ياسين الدليمي

رغم مرور أكثر من خمسين عاما على ظهور البواكير الأولى لقصيدة النثر في المشهد الشعري العربي، إلا أنها لم تزل تمثل إشكالية لدى النقاد، ربما وإلى فترة غير معلومة، سيطول الجدل حول شرعيتها ومحاولات تأصيلها ولو بشكل قسري، بالعودة بها إلى التراث العربي والإسلامي (الصوفي على سبيل المثال) حتى يأتي وقت لنجد أنفسنا فيه أمام أشكال جديدة من الكتابة الشعرية ستضع قصيدة النثر في إطار زمني ماضوي مع بقية الأنماط التي سبقتها.
ما الذي يجعل قصيدة النثر تأخذ هذا الحيز من الحضور والاهتمام، سواء على مستوى النص أو على مستوى النقد؟
يبدو لي أن مرجع ذلك يعود إلى أنها لا تسكن في إطار شكلي ثابت ومقنن، بقدر ما تتحرك وتتمدد في اتجاهات مختلفة ومتنوعة من غير أن تستقر على شكل محدد، وهذا ما يجعلها حرة، وغير قابلة للإمساك، كتابة وقراءة ونقدا. لعل حركتها المستمرة وهي تتشكل وتتعالق مع فنون أخرى مثل القصة القصيرة، منحها طاقة جوهرية في أن تتوغل عميقا في مساحة جديدة من الأفكار والتأويلات لم تتجرأ عليها قصيدة الوزن، وكذلك قصيدة التفعيلة.
في الوقت نفسه هذا التداخل الإجناسي الذي أسبغ عليها ميزتها هذه، فرض سؤالا جوهريا دائما ما يتم طرحه ما أن يتم الحديث عنها، والسؤال يتمحور حول ما يفصلها من حدود مع جنس القصة القصيرة، إذ غالبا ما يصعب تمييز هذه الحدود والفصل بينها. ربما هذا الغموض التجنيسي الذي تخلفه قصيدة النثر عموما، يفرض على النقاد وبشكل دائم إعادة النظر في بعض المفاهيم التي طالما نتداولها، ونحن نتحدث عن التجربة الشعرية في سياق النقد، من غير أن نعيد تفكيكها وإعادة صياغتها من جديد، فالمفاهيم الأدبية لا تكتسب صفة مطلقة في التداول، بل تخضع إلى التغيير والتعديل حالها حال بقية الكائنات الحية، ومفهوم الشعر بناء على ذلك ليس ثابتا في زمن مطلق ومحدد، إنما يتحرك هو الآخر في وعاء الزمن، ويكتسب دلالته منه. فما يُعدُّ شعراً اليوم ربما لا يكتسب هذه الصفة بعد غد، بذلك يتوجب دائما إعادة النظر في المصطلحات والمفاهيم، تبعا لما يحدث من متغيرات في شكل وبنية النص الإبداعي.
ليس من الوارد في إطار الأدب والشعر أن نبقى نردد بشكل آلي مصطلحات سبق أن رددها آخرون قبل عشرات السنين، متجاهلين ما حصل ويحصل من متغير في بنية الأشكال الإبداعية، فكل الفنون خضعت لعملية تغيير طالت بنيتها ولغتها وأسلوب بنائها وشكلها، بالتالي انعكس ذلك على مسألة التلقي.
من هنا فإن مسألة إعادة النظر في قضية المفاهيم والمصطلحات الأدبية تصبح أمرا موجبا تستدعيه حركية الإبداع، وكلما ذهب النص باتجاه مناطق جديدة ومجهولة، متوغلا في إطار المغامرة والتجريب، فإن ذلك يستدعي من القراءة النقدية ألا تتكئ على مفاهيم ومصطلحات منجزة لقراءة ما هو خارج عن مقاييسها. ومثلما أعمارنا تمر في أزمنة مختلفة تشهد على توهجها وحيويتها، ومن ثم انحدارها إلى وادي الكهولة والشيخوخة والذبول، فإن الأشكال الفنية الشعرية كذلك تمر في هذا المسار، وهكذا تتجدد علاقة المبدع مع ذاته ومع الزمن.
وما يستحق التوقف عنده في المشهد الشعري العربي أن عملية التحول والتغيير في أشكال الكتابة واجهت صعوبة كبيرة في أن تفرض حضورها وبقيت قصيدة الوزن (العمود الشعري ) تعبُرُ الأزمنة وتختزلها في بنائها الفني وكأنها تقيم في فراغ، ولا شيء يحدث ولا شيء يأتي.
الذائقة العربية الشعرية كانت ومازالت تواجه صعوبة في أن تغادر منطقة التلقي التي وجدت نفسها فيها منذ ما قبل الإسلام (الأوزان، القافية، الإيقاع، الجزالة، المبالغة، الوضوح، القصدية، الخ). وعلى الرغم مما أحدثته قصيدة التفعيلة، أو ما اصطلح عليها خطأ (الشعر الحر) من تحول كبير في بنية النص الشعري العربي المعاصر، منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، إلا أن ذلك لم يوقف تمدد قصيدة الوزن إلى القرن الواحـــــد والعشــــرين، ولو تأملنا المسألة بعمق سنجد أنفسنا وكأننا نواجه منظومة ثقافية تعـــاني من حالة انفصام حــــاد، فما الذي يمنح هذا النمط من الكتابة الشـــعرية البقاء في زمن التقنيات الرقمية، مع أنه ينتمي إلى زمن اجتماعي وثقافي آخر، مفــرادته الصحراء والخيول والخيام والسيوف والغزوات والثارات والقبائل.
لا أظن أن الإجابة التي تتعكز على ما تحمله قصيدة الوزن الشعري من إعجاز فني هو الذي منحها هذه القدرة على أن تصمد في مواجهة الزمن. هذه الإشكالية في ما لو تأملناها في إطار أشمل وأعمق، ولامسنا من خلال ذلك جملة معطيات أفرزتها سلطات اجتماعية وثقافية ودينية وسياسية، عندها سنصل إلى أن الإنسان العربي قد تم ترويضه بفعل هذه السلطات، على أن يكون متلقيا سلبيا اتكاليا، وألا يطرح الأسئلة التي تحمل توقا إلى تفكيك المعلوم والثابت والمقدس. حتى باتت الأشياء المحيطة به مألوفة، وتبعث في داخله شعورا بالاطمئنان على أن الحياة تسير وفق مسارها المقدر لها، ولن يخطر في باله التفكير بالخروج عن هذه النواميس التي تملك صفة القداسة.
ربما هيمنة سلطة الخطاب الديني تحتل أولوية الأسباب التي أدت إلى هذا الارتكاس في العقل العربي الجمعي، والسؤال الذي يلح بهذا السياق: إلى متى ستبقى سلطة الخطاب الديني على هذا الاستئثار والاستيلاء، بدون أن تتزحزح ولو قليلا لتمنح العقل مساحة من الحرية، رغم ما يشهد الواقع من قمع وتمرد وهيجان ومتغيرات؟ ظاهر الصورة يشير إلى أنها ماضية في هيمنتها واتساع سلطتها حتى مع اقتراب اجتيازنا للعقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وهذا ما يتجسد بشكل واضح في تمدد الحركات الجهادية المتطرفة التي ينخرط فيها عشرات الشباب، بينهم أعداد كبيرة من المتعلمين والجامعيين وأصحاب شهادات عليا.
قصيدة النثر يمكن النظر إليها من هذا المنظور باعتبارها تمردا على سلطة المقدس الأدبي، ويحمل هذا التمرد في داخله تمردا على السلطة في مفهومها المطلق، فالشاعر الذي يكتب قصيدة النثر يحمل في نصه تطلعا إلى الخروج من عالم مغلق تمسك السلطة بمفاتيحه. قصيدة النثر تكتب حلم الكائن الإنساني في الوصول إلى يوم آخر لا يحمل ملامح الأمس. إنه نص مُغادر لكل ما هو معلوم وثابت ومكرر، ولأنه نص يتحرك بإيقاعات مختلفة ومتداخلة، ومن الصعب الإمساك بها فإن ذلك سيمنحه مساحة لا حدود لها في فضاء التأويل.
* المصدر: القدس العربي