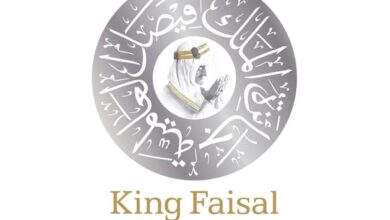كتابات الماغوط النقدية كانت بموافقة السلطة

الجسرة الثقافية الالكترونية-الراية-
*جهاد فاضل
ثم إن حافظ الأسد كان مطمئنًا غاية الطمأنينة إليه لأن الماغوط، وهو إسماعيلي المذهب، لا يمكن أن يذهب في نقده له، أي للأسد، وكذلك لنظامه، إلى الحدّ الذي يعرّضه للمساءلة. فلا يمكن أن يحلم الماغوط برئيس لسوريا أفضل من الأسد ولا بنظام أفضل من نظامه.. ذلك أن بديل هذا الرئيس هو من سنّة سوريا، أي من أعداء الماغوط وأعداء الأسد.. ولأن الماغوط الإسماعيلي هو شقيق بالروح، أي بالمذهب الديني للأسد العلوي، فالاثنان إذن في حلف مقدس ضد عدو هو «الآخر» السنّي السوري، ومن هنا كان هذا الودّ بين الكاتب المسرحي الناقد أو الساخر. وربما كان وراء هذا الودّ كون الماغوط يؤدي خدمة غير مباشرة للنظام العلوي في بلده، لأن نقده للظواهر السلبية في هذا النظام، من شأنها أن تنفّس عما يعتمل في نفوس السوريين، و«تفش خلقهم» كما يقال بالعامية. فظاهرة الماغوط المسرحي الناقد لم تكن ظاهرة من ظواهر «حرية الرأي والنقد» وخالية من أي ضابط من الضوابط، وإنما كانت «ظاهرة مدروسة» و«موافق عليها».ومن هنا جاء احتفاء الأسد به في تلك المناسبة التي أشار إليها وزير الثقافة السوري.
ومع ذلك فقد كان الماغوط، سواء كان هناك صفقة سرية غير مباشرة بينه وبين نظام الأسد أم لم يكن، أحد الوجوه الجيدة في الحركة الشعرية والمسرحية في بلده في النصف الثاني من القرن العشرين. الماغوط له جوانب أخرى إيجابية بالطبع. لا ينكر أحد لا شعره ولا مسرحه.
يصف القاص السوري زكريا تامر حزن الماغوط بأنه لم يكن حزن الرومانسيين المتثائبين على جسر التنهدات. «لقد كان يضع أحداثه في الدم الفائر فيطفر على أحداقه، وهذا ما جعل كتابته تفتح أرضًا غير التي فتحتها مجلة «الآداب» أو التي ذهبت إليها مجلة «شعر»، كان الماغوط كائنًا وحشيًا طافرًا من غابة تغرس جذورها على أجسادنا وأرواحنا دون أن يعبأ أو يكترث بالكلام عن البدائل، بمعنى أنه لا يطرح خطابات أحلام كما كان يفعل شعر الآخرين، الأمر الذي لفت نظر الشعراء العرب محاولين أن يجدوا في عالمه نافذة على أفق مغاير. وعندما كنت أجلس إلى كتاب «غرفة بملايين الجدران» أشعر برهبة غامضة لفرط المسافة التي كان يجب علي أن أقطعها بعد «أنشودة المطر» أو «أوراق في الريح» أو «أباريق مهشمة» أو «أحلام الفارس القديم» كي أصل إلى الأرض التي يحرثها نص الماغوط بعظام أطراف الكائن البشري. فإذن كانت المسألة التي تتصل بالشكل ليست تجربته وحده بل تجربة جيل بأسره، جيل مسكين خدع منذ الصغر بالشعارات السياسية الفكرية البراقة ولم يكتشف أنه مخدوع إلا وهو يدق أبواب الشيخوخة بقبضات واهنة فعلم آنذاك أنه قد أضاع أجمل سنّي عمره هباءً”.
واعتبر الشاعر البحريني أن الماغوط نجح في الجمع على أرض واحدة بين الليل والنهار، بين الأمل واليأس، بين مرارة الهزائم وغضب العاجز، ليقدم صورة لما يعانيه الإنسان العربي من بلاء من سياسييه ومثقفيه وجنده وشرطته وأجهزة إعلامه مكثفا ذلك البلاء الكثير الوجوه في بلاء واحد هو فقدان الحرية.
وذكر خليل صويلح أن الماغوط دخل غاضبًا ومتمردًا على كل أنواع القيود، ليس القوافي والأوزان وحسب، بل قيود الحياة نفسها، هذه الحياة التي لفظته باكرًا خارج جدرانها ليجد نفسه صديق الأرصفة الأزلي وأمير التسكع.
ويضيف صويلح: “وإذا كانت جماعة “شعر” عدته مجرد بدوي سوف ينشد بضعة مواويل ويمضي، فقد أخطأت الحساب. ذلك أن الماغوط لم يكف عن الحداء والسخط أبدًا، متجاهلاً كل الأطر التي كانت تتحكم بمشروع الحداثة إذ لم يكن لديه مانيفست سوى أبجدية الجوع والصراخ والحزن، وحين أحس بأن باب مجلة “شعر” ضيق على منكبيه، هجر رفاق الدرب دون عودة أو ندم عائدًا إلى أرصفته ومقاهيه وعتباته الأولى ليحلق مثل نسر في الفضاء ثم يلتقط طرائده من حطام الحياة اليومية ومن دماره الروحي ومن حزنه التاريخي الذي لم ينضب أبدًا. لقد ظل متمرسًا بأدواته نفسها وبمعجمه الهجائي وبنبرته نفسها ولم تغيره الشهرة ولا الاستقرار، بل ازداد ضراوة وضجرًا وكأنه لم يغادر غرفته القديمة التي شهدت آلامه وأوجاعه الأولى، تلك الغرفة الصماء “غرفة بملايين الجدران” وكأنه لم يغادر أيام التسكع والتشرد والخواء، وما زال يردد “اختصاصي الوحيد الحرية” و”الفرح ليس مهنتي”.
ويرسم محمد مظلوم صورة واقعية للماغوط في سنواته الأخيرة عرفها كل من زاره في منزله: الخمرة واللفافة وما إليهما: في السنوات الأخيرة زرت الماغوط بشقته وسط دمشق أكثر من مرة، وفي كل مرة كان المشهد واحدًا تقريبًا يرسم صورة ذلك النسر شبه العاري وهو طريح الدنّ والزمن.
“وفي إحداها كانت زيارة على مائدة الماغوط الأثيرة التي تلتصق بكنبته: خمور متنوعة وصحون طعام متعددة و”كروز” سجائر يضيف منه زواره بالعلبة وليس بالسيجارة”!
كان حديث الماغوط في تلك الزيارة عن الكوابيس التي تأتيه في هبّات نومه المتقطع، ممزوجًا بأحاديث عن أحلام الشاعر في يقظته لا تستطيع أن تفرق بينهما بسهولة. هكذا كانت حياته رغم الدعة أو ما حسده عليه البعض من كنوز جاءته بعد فوات الأوان، بيد أن الشاعر يموت دائمًا دون الحاجة إلى كنوز إضافية.
لقد أراد الماغوط أن يعقد مصالحة مع الجميع بعد أن أفسد حياته مع نفسه ومع العالم برمته. ومع أن موته كان منتظرًا من قبل جميع من عرفوا كيف كان يفني ساعاتهً، إلا أنه جاء مفاجئا لهم أيضًا. لم يكن في أيامه الأخيرة منسيًا كما يحدث للشعراء مثله عادة، ولكنه كان محاطًا بالرعاية والشبهات، ربما سيزيد من تأويلاتها اليوم أن الشاعر لم يمت على الأرصفة التي عاش فيها وتغنى بها كميدان بطولة، ولا في المنافي الباردة بل على سرير في مستشفى دمشقي بعد أن عاش سنواته الأخيرة على كنبة في شقته بوسط دمشق وبرعاية من ابن شقيقته الطبيب.
الواقع أن الماغوط هجا الأوطان والعواصم، المدن والغرف والسجون، التاريخ والبشر جميعًا. ركض عمره بوحشة الأنهار وطيش العصافير. كانت النار مشتعلة في ثيابه وأجنحته ومحركات الروح.
كان يرمي الأيام مثقلة بأعقاب السجائر وأعقاب الأحلام المهمشة ككؤوس تطاردها لعنة الزلازل. هرب إلى التراب نجمة تعبت من السهر على حبال المخيلة الراعدة. كان حارس منجم الحزن وبائع السموم الباهرة.
من “حزن في ضوء القمر” (1959) وكان في بواكير أيامه وهو المولود في العام 1934، إلى “غرفه بملايين الجدران” (1964) إلى “العصفور الأحدب” (1976) والذي سيظل أحدب طوال عمره الذي لم يعرف الفرح ولم يمتهنه قائلاً في سره وفي العلن: “الفرح ليس مهنتي” (1970) إلى أنشودته “المهرج” (1974) “إلى أرجوحة العمر” (رواية سنة 1992) ومعها مجموعة أشعاره الصارخة بالانتماء للوطن عكس عنوانها الفاضح بالمرارة “سأخون وطني” إضافة إلى تغريده خارج السرب في مسرحيته المعروفة وسائر أعماله مع دريد لحام: ضيعة تشرين، غربة، شقائق النعمان وكاسك ياوطن وسواها..
من كل متاع العمر الزاهد بكل متاع، ومن كل جارف الشوق المترع بالأحلام، يتشكل نسيج الشاعر والمسرحي المشاكس والعنيد: الماغوط الذي غالب الأيام بكل ما فيها ولم يكسره مرض أو خوف من الموت. ولكنه يترجل باسطًا عينيه مفتوحتين على مشارف الأمل.. الأمل في أن يكون ما عاش يحلم به يظل حيًا ولو في الأحلام.
ومع أن سيرة الماغوط تؤكد ضلوعه الدائم في عالم يبدو مصرًا على لا مبالاته بكل الأحياء من حوله، إلا أن الماغوط الذي أضحك وأبكى وأشجى وأطرب وأغرى وأتعب، والذي لم ينم على وسادة مريحة أبدًا، استطاع أن يحوز الاهتمام الجماهيري والرسمي فعرف معنى التكريم وحلاوة الاحتفاء حيث نال في بلده أرفع وسام يُعطى لأديب.
تزوج الماغوط من الشاعرة الراحلة سنية صالح وأنجب منها ابنتين: سلافة وشام، وحين توفيت زوجته كتب على قبرها: “هنا ترقد سنية صالح آخر طفلة في العالم”. وعن قريته السلمية كتب في سيرته المنشورة جزئيًا في كتاب “اغتصاب كان وأخواتها”: “السلمية قرية نائية وباسلة ورجالها لا يتورعون عن ضرب أشجارهم بالسوط لأنها لم تثمر في الوقت المحدد”!.
تآخى الماغوط مع الفقر والشقاء، تقبل أحكام التشرد وحول غربته في بيروت إلى وطن معشوق ومنتقل. سامح نفسه على خطئها في حق نفسه. وسامح أصدقاءه وسامح الضعف البشري في كل مكان. ولكنه لم يغفر للفاتك الذي أهان كرامته. لم يغفر للسجان. لم يغفر للرجل الذي يرمي الشعراء في السجون، كما يرمي القطط الجائعة من النافذة.
تصالح كتاب كثيرون مع السجن، حيث رموا في الزنازين المرعبة أو القواويش المذلة مع اللصوص والقتلة والمحتالين، عاش هؤلاء بقية حياتهم ينسون ما حدث أو يروون ذكريات السجن في باب الطرائف والنكات. لم يغفر الماغوط لأمته ثقافة السجون. عاش حياته يتطلع وراءه خوفًا من تكرار المذلة، كانت ترعبه فكرة وقوع الشعر في يد الشرطة، وسقوط الفكر في أفخاخ العسس والجلادين وثعالب الحريات.
كان الماغوط بدويًا في أعماقه، والبدوي لا ينسى فقط يتعلم من عذاباته ما يريد، ومن ذكرياته ما ينتقي، ويرمي اليباس على جانبي الطريق.
كتب الماغوط قصائد جميلة وحول السجن إلى ملحمة، شعر أنه ابتز منه شيئًا لا يسترد ولا ينقل ولا يعاد صنعه. لذلك أمضى حياته ينتقم منه. كان شخصية إلياذية بطولية سيرتها هي الشعر وبؤس هو المسرح. وظل يلاحق سجانه حتى الموت. إنه ذلك الشرطي الذي حمله على القول:سأخون وطني!، ومن أطرف ما يروي الكتاب عنه أنه دعي قبل رحيله بـ 5 سنوات لزيارة كندا بمناسبة صدور ترجمة لأعماله الكاملة، فتجاهل الدعوة ولبى دعوة أخرى جاءته من النبطية وهي مدينة شيعية لبنانية، وحين سئل لماذا فعل ذلك وفضل النبطية على كندا، أجاب: قيل لي أن في النبطية الكثير من الشهداء، عندما دعوه قالوا له: تعال لترى مكانًا مرتفعًا، وكان الماغوط قد هتف مرة في إحدى قصائده: لا أرى في هذا الشرق مكانًا مرتفعًا لأنصب عليه راية استسلامي!.
والماغوط الناقم الساخر اللمّاح الذي قال مرة إنه لا يربكه شيء مثل المديح، لم يكن يعرف سوى الكتابة، كان يتحاشى مجالس الأدباء ومقاهيهم لأنه يكره التنظير: “أنا لا أحب أن أسمعه ولا أن أخوض فيه.
لا أذكر أني جلست مع أدباء وتحدثت في الأدب، عالمي هو الكتابة، خارج دفاتري أضيع. إذا كان عندي رأي أفضل أن أكتبه على أن أحكيه. كانت دفاتر الكتابة شاطئ الأمان بالنسبة إليه، وكانت الكتابة حصانته الأخيرة بوجه العسف واليأس والإحباط في عصر قلة الموهبة، عصر تفريغ المشاعر لا شحنها.
في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي طلب منه يوسف الخال قصيدة لينشرها في مجلته “شعر” لم يكن لدى الماغوط قصيدة جاهزة، لكنه قال للخال: غدًا تكون عندك. فعلى ماذا كان يراهن وهو يقطع هذا الوعد على نفسه أمام يوسف الخال، هل لأن القصيدة كانت ناضجة في نفسه ولم يبق سوى أن يكتبها؟ لا أحد يعلم، لكن المعروف أنه في ليلة واحدة كتب ديوانه “حزن في ضوء القمر”، كانت تلك مفاجأة أذهلت الخال.
أما القصيدة فغدت عنوان ديوانه الأول الذي صدر عام 1959 عن مجلة “شعر” نفسها.
بعد ذلك بسنوات في عام 1966 زار زميله في “شعر” الشاعر أنسي الحاج دمشق وراح يفتش عن الماغوط الذي غادر دمشق إلى بيروت.
كان فضوله كبيرًا ليرى ما إذا كان الماغوط في عنف وحدّة ما كان أيام بيروت.
قال الماغوط بعد ذلك أشعر بأنني بعكازي في بلدي أقوى من كل صواريخ الأرض!
وقد كتب مرة زمن السخط والغضب: أيها المخبرون، يا رجال الإنتربول في كل مكان عبثًا تبحثون عن الجريمة كاملة، فما من جريمة كاملة في هذا العصر، إلا أن يولد الإنسان في بلادنا.
وبلغ به النزق إلى حد التهديد: سأطلق الرصاص على حنجرتي.. ولكنه لم يفعل ما فعله الشاعر خليل حاوي الذي انتحر عام 1982، لقد ظل حيًا يراقب حقول النبوءة التي أطلقها في الخمسينيات وهي تتحقق أمام عينيه.
ويرى الشاعر المصري حسن طلب أن الماغوط شاعر كبير ورائد في مجال قصيدة النثر التي تدين له بالكثير، فرغم أن تلك القصيدة كتبت من قبله، حيث ظهرت في مجلة “شعر” على أيدي أنسي الحاج وأدونيس، لكن الماغوط أضفى عليها ملامحه الخاصة، لقد أقام عمود قصيدة النثر. فمثلما أقام صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي عمود قصيدة التفعيلة، كما قال لويس عوض مرة، للماغوط مدرسة خاصة في قصيدة النثر. فقصيدة النثر لديه أكثر حساسية تجاه قضايا الإنسان العربي المعاصر وأقرب إلى وجدانه من قصيدة النثر الأخرى التي ظهرت في مجلة “شعر” كانت الأخيرة تميل إلى شكل قصيدة النثر الغربية على عكس قصيدة الماغوط.
ويرى الشاعر المصري عبدالمنعم رمضان أن تاريخ الشعر العربي يؤكد دائمًا أن شعراءه الكبار هم الذين سكنوا الأجزاء المعهودة من أرض الشعر باعتبار أن هذه الأجزاء هي ذاتها أرض البشر. في تاريخ الشعر العربي كل شاعر كبير هو شاعر عام، منذ المتنبي وصولاً إلى أحمد عبدالمعطي حجازي ومحمود درويش، وكل شاعر كبير من هؤلاء ليس صاحب طريقة خاصة، إنه عضو بارز في طريقة قائمة، وقليلون هم الشعراء الذين سكنوا المناطق المهجورة وأصبحوا أصحاب طريقة وأصبحوا كبارًا، من هؤلاء أنسي الحاج وأدونيس وصلاح عبدالصبور والماغوط.
إن قوة الماغوط مقرونة بقوة طريقته التي أنشأها، فيما قوة شاعر مثل محمود درويش مقرونة بنبوغه داخل طريقة تسبقه وتستمر، لابد أننا سنحب دمشق أكثر وسنحب بردى والأرصفة والروح العذبة الهائجة أكثر ما دمنا نقرأ شعر الماغوط.
ويصف شاعر مصري آخر هو محمد إبراهيم أبوسنة الماغوط بشاعر الدراما الساخرة وشاعر الواقعية وملهم العديد من الأجيال الجديدة وقد خرج الماغوط من غرفته المليئة بالجدران إلى الأفق المليء بالنجوم!.