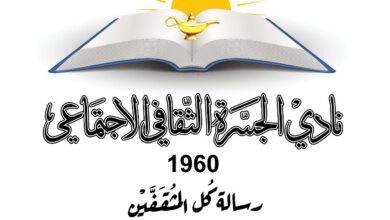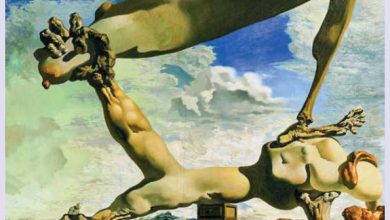كيف تستأنس خوفك؟
حد الخطر.. خط الأمان

- كيف تستأنس خوفك؟ - 2023-11-16
يبدأ الأطفال بالشعور بالخوف في عمر 6 أو 7 أشهر. عندما يبدأون في تطوير ذاكرة الوجوه المألوفة؛ فيصبح أي وجه غير مألوف غير الراعين له كالأب والأم، يرونه غريبًا على الخوف.
الخوف أمرٌ طبيعي يُنبهنا إلى وجود خطر، قد ينتج عن خطر حقيقي، أو عن تخيَّلات أو هلاوس، أو أنه خوفٌ غير مبرر، ويقودُ – أحيانًا – إلى الكرب والضيق والتوتر والقلق، وإذا وصلت ردود فعل الخوف إلى حدِّتها القُصوى؛ فإنها تعرض حياه الإنسان للخطر، إنه بشكله المرَضي عرضٌ من أعراض مجموعه العُصاب التي تحوي فيه اضطراب القلق المُعمَّم والرُهاب، أي الفوبيا أو المخاوف المرضية، والوسواس القهري ونوبات الهلع، والقلق الاجتماعي وكذلك اضطراب أو كرب ما بعد الصدمة.
أقصى أنواع الخوف وأكثرها حدَّة وقسوة هي نوبات الهلع، وتعتبر الذروة بالنسبة للخوف في كل مراحله، وترتبط إمّا بقلق شديد، أو التعرُّض لأزمة داخلية، أو فكرة
الخوف عاطفة طبيعية وميكانزيم للبقاء. الخوف يتكون من مشاعر ردود فعل بدائية أولية كيميائية حيوية وانفعالية؛ فعندما نواجه تهديدًا محسوسًا، تستجيب أجسامنا بطرق محددة، تشمل ردود الفعل الجسدية للخوف بالتعرّق وزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع مستوي الأدرينالين في الدم مما يجعلنا في حالة تأهب قصوى، تُعرف هذه الاستجابة الجسدية أيضًا بـــ “الكَرّ والفَرّ”، والتي من خلالها يجهِّز جسمك نفسه، إما للعراك أو للهروب، وهكذا فإنها استجابة تلقائية ضرورية لبقائنا.
الاستجابة الانفعالية
من ناحية أخرى، فإن الاستجابة الانفعالية للخوف تختلف باختلاف صاحبها، لأن الخوف ينطوي على بعض التفاعلات الكيميائية في أدمغتنا مثله مثل المشاعر الإيجابية كالسعادة والإثارة، ففي ظل ظروف معينة يمكن اعتباره شعورًا مُمتعًا، مثل بعض الناس حين يشاهدون ويستمتعون بأفلام الرُعب، فهم يبحثون عن الأدرينالين، وتُثيرهم الرياضات الخطرة، وقيادة السيارة بسرعة كبيرة مُعرّضين أنفسهم للخطر، وغيرها من مواقف الإثارة التي تثير الرعب، لكن لدى البعض الآخر ردّ فعل سلبي للمواقف المٌثيرة للهلع، ويتجنبون المواقف المُسببة له بأي ثمن، وهكذا تتباين ردود فعل البشر، على الرغم من أن ردّ الفعل الجسدي هو نفسه في كل الحالات تقريبًا، وربما يُنظر إلى تجربة الخوف على أنها إيجابية أو سلبية، اعتمادًا على الشخص نفسه.
نوبات الهلع
أقصى أنواع الخوف وأكثرها حدَّة وقسوة هي نوبات الهلع، وتعتبر الذروة بالنسبة للخوف في كل مراحله، وترتبط إمّا بقلق شديد، أو التعرُّض لأزمة داخلية، أو فكرة.. كفكرة الموت أو الإصابة بمرض عُضال، أو أنه يتقاطع مع اضطراب الوسواس القهري ذا الجناحين.. الخوف والاكتئاب؛ وبالتالي تصبح فكرة الخوف من الموت، هي الفكرة المُسيطرة والمُقتحمة التي تنقر رأس المريض، كما يفعلُ نقَّار الخشب.
يغمُر المريض بنوبة الهلع عرقٌ غزير وضرباتُ قلبٍ سريعة ودوخة وكأن الأرض تلّف به، وسرعة في التنفس وإحساس بالغثيان وكأنه على شفا الموت، ويهرع به الأهل أو الأصدقاء إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة، وهو مشهد متكرر تدرَّب عليه أطباء الطوارئ، ويلجؤون فيه إلى إعطاء المُصاب الحقن المهدئة، ولكن ليست لديهم في أغلب الأحوال الخبرة الكافية للطمأنة أو لتفسير نوبات الهلع للمريض وذويه.
تعاطي المخدرات.. خاصةً مُخدِّر الحشيش، من الممكن أن يُحفِّز لدى بعض الذين لديهم استعداد كيميائي حيوي في المخ لاستجابةٍ غير تقليدية، بإحداث نوبة هلع شديدة فجأة
تعاطي المخدرات.. خاصةً مُخدِّر الحشيش، من الممكن أن يُحفِّز لدى بعض الذين لديهم استعداد كيميائي حيوي في المخ لاستجابةٍ غير تقليدية، بإحداث نوبة هلع شديدة في التوّ واللحظة إثر التعاطي، مما يثير فزَعهم وارتيابهم وشكِّهم وإحساسهم بدنو الأجل، مما يجعلهم عرضةً للرُعب والإحساس بالاضطهاد والانزواء والاختفاء وكأن هناك من سيأتي لقتلهم.
في إحدى جلسات السيكودراما “المسرح العلاجي التمثيلي بدون نص”.. كان محور جلسة من الجلسات، التي شارك فيها ما يقرب من 20 عضو بإحدى المستشفيات النفسية بالقاهرة، أمسكت امرأة في أواخر الثلاثينيات بوسادةٍ ترمُز إلى الخوف ولم تدَعها تحيدُ عنها، بل احتضنتها وقالت إنها تحميها وتدرأ عنها شرور الزمان، لكنها تلك “الوسادة – الخوف” لا تتحكم فيها، بينما الآخرون تلقّفوا تلك الوسادة، وتعاملوا معها بخِفة أو بسرعة أو رموا بها إلى الآخرين أو إلى الأرض، تخلّصوا منها على أساس أنها نوعٌ من الخوف المرضي، الذي لا ضرورة للاحتفاظ به.
الخوف والخجل
يرتبط الخوف بالخجل وعدم الشجاعة والجسارة أحيانًا، وقد يكونوا فطريًا وقد يكون مُكتسبًا نتيجة معاملة قاسية من الوالدين أو أولي الأمر، أو تكرار التنمُّر في المدرسة أو الحي، أو الاعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي على الطفل، ممّا يخلق نوعًا من الصدمة التي تظلّ محفورة في عُمق تكوينه، كما تخلق حالة من العجز المكتسب، والإحساس بالخوف من كل شيء ومن أي شيء، ومنها عدم الإقدام على خطوة مُستقبلية، أو بدء عمل جديد، أو الخوف من الحميمية.. بمعنى الخوف من الاقتراب من الآخر، أي الخوف من “المواجدة” التي تعني الشعور بما يشعر به الآخر، ممّا يؤدي إلى حالة من التمحور حول الذات والإحساس بالتيه والضياع، على المستوى الواعي واللا واعي؛ فيظهر الخوف أيضًا في الأحلام في شكل كوابيس أو أضغاث أحلام مُكثفًا في صورٍ عِدَّة، قد تكون مُخيفة ذات رمزية خاصة بالماضي وآلامه، وقد يدفع ذلك بالمريض إلى النهوض من النوم في حالة من الذعر والعرق الغزير، بضربات قلبٍ مُتسارعة وقد يظلّ مؤرقًا طيلة الليل.
الخوف من الهجر والفقد
الخوف من هجر الحبيب بما يتضمنه ذلك من حنان ومشاعر فياضة، أو من فقدان الأعزاء المُقرَّبين أو رغد العيش عمومًا، وقد ينجُم من التغيير أو الخوف من النجاح أو الخوف من الفشل، أو الخوف من فقدان السيطرة على الأمور، مما يجعل الخائف مرتبكًا ويعاني من الإحساس بعدم الأمان.
أمّا الاستقرار والطمأنينة؛ فهي تلك الحياة التي نعيشها دون خوف من الخسارة، ويعني ذلك أنه عندما يحين الوقت لنتحرك في معترك الحياة بكل ما يكتنف ذلك من مخاطر، أو التفاعل مع الآخرين في اتجاهاتٍ مختلفة، لأن مساراتهم ربما تباعدت كضرورة حتمية لصيرورة الحياة وأحداثها تلك المُتوقعة و الأخرى غير المُنتظَرة، ثم نبدأ في مراجعة حساباتنا، وتقدير ما هو حقيقي عن أنفسنا وعن الآخرين، والتأثيرات التي قد ستحدث، ونبدأ في عقلنة الأمور حتى لا نقع أسرى للخوف من المجهول أو الفقد الحتمي للآباء والجدود، ونحن نعلم أن السفر والترحال والموت أمورٌ حتمية.
ما تعتقدُه وتؤمن به يُحدّده عقلك، وتسير على خُطاه غير عابئٍ بأي معوقات، ومن هنا فهما كانت الظروف الحياتية وأنت تؤمن بقدرات وشجاعتك فستمضي قُدُمًا، أما الذي يخاف من “العفريت” فسيطلع له أينما كان.
الخوف والخوف المرضي “الفوبيا“
يعتمد الخوف بشكل عام – إن لم يكن دائمًا – على تجربة سلبية في موقف مُزعج؛ فإذا هاجمك كلب وأنت طفل، وكانت التجربة قاسية ومرعبة؛ فستترك أثرها حتى بعد مرور السنوات، لكن ربما عدَّل من سلوكك كلب ابنتك حينما ذهبت لزيارتها، ووجدته كلبًا مسالمًا يُحيّيك ويدعوك للعب معه في وداعة، وقد نتعلم الخوف من شخص آخر، مثل طفل يخاف من العناكب بسبب ردود فعل والدته.
الاستقرار والطمأنينة هي تلك الحياة التي نعيشها دون خوف من الخسارة، ويعني ذلك أنه عندما يحين الوقت لنتحرك في معترك الحياة بكل ما يكتنف ذلك من مخاطر
مهما كان موضوع الخوف، فقد تشعر بالضيق أو عدم الارتياح عندما تواجه الأمر؛ فإذا كنت تخشى الطيران؛ فقد تصبح متوترًا عند ركوب الطائرة، لكنك تتمكن من التغلُّب على ذلك، بإلهاء نفسك بتصفح مجلة أو قراءة موضوع أو لعب لعبة على هاتفك، وقد تفضِّل السفر بالسيارة أو القطار، ولكنك ستطير عندما يكون ذلك ضروريًا أو عمليًا.
الاستجابة الرُهابية (الفوبيا)
إذا كان لديك خوفٌ شديد من شيء أو موقف معين، فستكون استجابتك بأعراضٍ فسيولوجية؛ فمن المحتمل أن تُحِس بالضيق والتعاسة بل والرُعب طوال الرحلة، أما إذا كان رُهابك أكثر شدة، وستتجنب ركوب الطائرة، وتضطر إلى إلغاء إجازاتك أو رحلات عملك، ولم تكن هناك وسيلة نقل بديلة، فلربما تمكنت من تناول مُهدئ يصفُه لك الطبيب قبل صعود الطائرة.
يخشى الناس ما يجعلهم يشعرون بالحذر والريبة أو عدم اليقين، مثل الذي يخشى المياه العميقة لأنه ليس سباحًا مُتمرسًا، ومثل هذا الخوف مفيد لأنه يحذِّر الشخص، ويخشى البعض من التحدث أمام الجمهور، سواء كان الأمر يتعلق بتقديم مشروع في اجتماع مُهم، أو القراءة بصوتٍ عالٍ في المدرسة مثلًا، وقد يتصوَّر البعض من مرضى “التوهم المرضي” أسوأ سيناريو”؛ فالصداع يعني لهم ورم في المخ، وإذا دخلوا مستشفى تمكنَّت منهم حالة من الرعب خوفًا من العدوى، وتُعد هذه حالة مرضية عبارة عن مزج بين الوسواس والخوف والاكتئاب، كما يكون الخوف من “أسوأ سيناريو” لما يُمكن أن يحدث للمُقرَّبين حال غيابهم، والخشية من أي حادث أو مُصيبة قد تحلّ بهم، اضطرابًا نفسيًا عُصابيًا.
فلسفة الخوف المُجتمعية
كاميرات المراقبة، وخطوط أمن المطار، والتقارير الإخبارية اليومية عن حوادث القتل العَمْد والعشوائي، والكوارث والسيول والفيضانات والأعاصير والتهديدات الإرهابية، كل ذلك يؤجج شعورنا بالهلاك الوشيك، والخوف من التجسس والتلصص علينا، وعلى صورنا وأسرارنا من خلال الشبكة العنكبوتية والتي أدّت في حوادث عدة إلى الخوف من الفضيحة، كلها قضايا وأفكار وراء تلك المشاعر الغامرة التي لا تلهينا عنها سوى انشغالاتنا في أمور الحياة اليومية.
إنها مظاهر المخاوف المجتمعية، والتقارير الإخبارية اليومية، تُرى كيف ولماذا يتسلل الخوف إلى أنفسنا في كل جانب من جوانب الحياة الحديثة.
يرتبط الخوف بالخجل وعدم الشجاعة والجسارة أحيانًا، وقد يكونوا فطريًا وقد يكون مُكتسبًا نتيجة معاملة قاسية من الوالدين أو أولي الأمر، أو تكرار التنمُّر في المدرسة أو الحي
نحن نعيش في “مجتمع المخاطرة” الحديث، ونتساءل تُرى هل أدّى الخوف إلى تآكل الثقة الاجتماعية، وهل يمكننا فصل أنفسنا عن حالة الإنذار المستمرة التي تحدد ملامح العصر الذي نعيش فيه، أم أننا نعيش “كيفما أُتفِّق” ولا ننتبه.
من الممكن – بالطبع – وجود مستقبل أكثر إشراقًا وأقل خوفًا، له سَمْت انتصار التفاؤل الإنساني، بالدعوة إلى تأمل مثير للتفكير، وتسحب فلسفة الخوف الستار المُغطِّي للأخطار المُتخيَّلة والحقيقية على حد سواء، مما يجبرنا على مواجهة مخاوفنا، ولنتذكر ما قاله الشاعر فؤاد حداد: “حدّ الخطَر هو خَطّ الأمان”.
مظاهر الخوف
أحيانًا ما يختلط الأمر بين تعبيرات الوجه عن الخوف وعن الدهشة؛ فكلا التعبيرين يظهران الحاجبين مرفوعين بشكل واضح، لكنهما في الخوف تكونان أكثر استقامة وأفقية، بينما في الدهشة يتم رفعهما وتقوسهما، كما يتم رفع الجفن العلوي أيضًا في حالة خوف، مما يُظهر بياض العين أكثر، والشفتين تكونان مشدودتين وممتدتين خوفًا ولكنها أكثر انفتاحًا وتراخيًا في حالات الدهشة، ويكون صوت الخائف أعلى وأكثر توتراً ويصل إلى حدّ الصراخ، كما يُحس بالبرودة وضيق التنفس، والارتجاف أو التشنج البسيط لعضلات الذراعين والساقين، وقد يَتخذ الخائف وضعية التجمُّد مكانه أو الهروب من المكان.
الحلّ والعلاج
عَرِّف خوفك وتعرّف عليه، حاول أن تُصاحبه لتفهمه، تُرى م الذي تخاف منه ولماذا؟ من أين نشأ، ومتى شعرت به؟ قد يساعدك اكتشاف مخاوفك على فهم جذورها، مثل تجربة سلبية مررت بها في الماضي، أو ارتباط شرطي بموقف أو شخص أو مكان وإذا كان خوفك يُعطِّلك، فضَع سيناريو عملي مُحدّد للتخلص منه، لأن ذلك سيسمح لك بالمشاركة الاجتماعية السلسة، والسفر لأمكنةٍ أكثر والتمتُع بها، وبناء علاقات جديدة، وهكذا فإن فهم فوائد التغلب على مخاوفك سيؤدي إلى زيادة حماسك للبحث عن علاج مُتخصص.
ليس عليك التغلب على مخاوفك وحدك إذا استعصى عليك الأمر، لأن هناك علاجات علمية وعملية مُتاحة لمساعدة الخائفين للتغلُب على مخاوفهم وذعرهم ونوبات الهلع إن وجدت، حاول تجنب الكافيين وممارسة الرياضة بانتظام، تعلَّم المرونة، وبدلًا من تجنب رُهابك، استمر في التدرُّب للتغلب عليه، وعند حدوث انتكاسات ستتعلم من تجاربك ومن ممارساتك الشُجاعة، وتجنب الوقوع مرةً أخرى في أنماطك القديمة لمواجهة الخوف بالهروب منه.
kmfadel@gmail.com
مجلة الجسرة الثقافية. العدد: 62