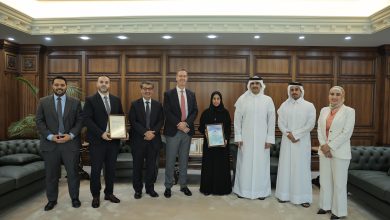«مقام ومقال» لإبراهيم بيضون.. عودة إلى أمزجة عامل

حسن نصّور
«مقامٌ ومقال» للأكاديميّ والمؤرخ اللبنانيّ إبراهيم بيضون، يعيدُ القارئ إلى ذاك المزاج من الكتابة التي تدين في العمق للجزالة والفصاحة. كتابة كأنّها تظل تقارع أنماطاً جديدة من التعبير لا تحتفي كثيراً بالتقريظ بل تقيم في عبارة نقدية مقنّنة تقترب إلى ما يشبه الفصحى بلغة اليوميّ. كتابة بيضون هي كتابة في المقلب الآخر، كأنها أيضاً إعادةٌ لأمزجة التركيب البلاغي العامليّ وأنماطه في بث ذاك الشعور الأوليّ، الذي لا يخرج عن شروط «الأصالة» و «الهوية».
الكتاب، ونعني مقامٌ مقال، هو تجميع لنصوص ومقالات يطول بعضها أو يقصر، في غير باب من أبواب الكتابة. منها رثاء، في الغالب، لأعلام من الثقافة أدباءَ وشعراءَ ورجال دين (هاني فحص، موسى السبيتي، جوزيف حرب…). رثاءات تقترب لماماً من النقد (ما يشبه النقد بحسب تسمية الكاتب) ومنها ما هو تحايا موجهة إلى الكاتب من الأصدقاء، قيلت في غير مناسبة. ومنها تنويعات ذاتية تخصّ اختصاص الكاتب وأشغاله في التأليف التاريخي في ما يشبه بيوغرافيا لأعماله.
خارطة أدبية
لا يسعنا بالطبع إيراد مجمل الأسماء الواردة في الفصول أمام المتلقيّ ولكن بوسعنا الإشارة إلى ما يبدو أنه يلزم القارئ للانتباه إلى ملامح في هذه الخريطة الأدبية إذا صحّ التعبير. فأسماء قديمة وحديثة أورد الكاتب شطراً من أيامها ومساراتها قد لا يمكن إغفالها في أي نظرة ولو مقننة على النصوص. نتحدث مثلاً، وهو مما يبدو من النادر الوقوف عنده، الحديث عن شطر قد لا يكون شائعاً من حياة المؤرخ العاملي الكبير حسن الأمين ابن المرجع الشيعي محسن الأمين سيما سفرته إلى الأرجنتين وصلته بنيلدا شرارة. والحديث أيضاً عن المنهج التاريخي في مقاربة الموضوعات الإشكالية وتحديداً آراء الأمين الإشكالية المعروفة في شخصية صلاح الدين وإدانته لصلح الرملة مع الملك ريتشارد وتنازله له عن مدن الساحل. «وكانت رحلة الأرجنتين لافتة في أسفاره، حيث التقى في عاصمتها الشاعرة العاملية الأصل نيلدا شرارة وبدأ علاقة خاصة ربما ارتقت إلى مستوى الحب شدّت أحدهما إلى الآخر، إذا توقفنا عند القصائد الدافئة المتبادلة بينهما والمندرجة في فصل الأدب من هذا الكتاب (…)، من مقدمة لكتاب الصديق إحسان شرارة: حسن الأمين أديباً ومؤرخاً ورحالة» (ص 137).
سياق وطني
لا تقتصر الأسماء الواردة في هذا الكتاب على تلك الأسماء التي واكبت مراحل مفصلية من تاريخ جبل عامل في لحظات مفصلية وتحولات تاريخية معروفة كالشيخ أحمد عارف الزين لاسيما دوريته الثقافية السياسية «العرفان» 1910 وأمداء انتشارها ومروحة الشعراء والمؤرخين عامليين وعرباً ممن ضمّتهم في صفحاتها (نازك الملائكة).. بل نقول إن الكاتب يورد من ضمن مروحته الواسعة أسماء لم تبلغ مستوى الشياع عند كثيرين وهي أسماء لعبت دوراً في السياق الثقافي الوطني والعاملي العام. أسماء ذات تأسيسات حوزيوية كانت سمتها الاساسية ذاك التوجّه المواكب للتحولات الفكرية في المجال الثقافي العربي اللبناني العام. «محمد شرارة مثالاً لا حصراً/ مقالة «كلٌّ في ذاته وموضوعه» (ص 152).
يقيم شطر وافر من الكتاب في استرجاع أسماء من الشعر الكلاسيكي العاملي. لكنه من ذلك النقد الذي يغلب عليه رثاء لأعلام القصيدة العاملية الكلاسيكية المعروفة (موسى الزين شرارة) لاسيما موقعية هذه القصيدة في البناء الثقافي العاملي. إنه، لو صحّ التعبير، نقد يشبه نوستالجيا العودة إلى تلك المناخات التي كان الشعر فيها وسيلة لتأسيس جماليات نقدية متجاوزة من الواضح أنها تخالف في مغزاها وأنماطها جماليات راهنة متوخاة في شعر بعض الأسماء الجنوبية اللامعة. جماليات مؤسسة على قصيدة النثر اليوميّ.
يختتم بيضون كتابه بالحديث عن أعماله في الكتابة التاريخية في ما يشبه سرداً مختصراً تقريبياً لإشكالات واجهت بعض إصداراته الأساسية في التاريخ سيما كتابه «التوابين» الشهير وكتابه في ما يتصل بثورة الإمام الحسين. بطبيعة الحال، يظلّ هذا نمطاً في الكتابة التاريخية واقعاً في التساؤل الجوهري عن مغزى فكرة الانحياز، وإن على أسس موضوعية لرأي في الحدث التاريخيّ على حساب رأي يخالفه. إنه التاريخ الذي يقع في الثنائيات والذي لا يدين غالباً لهوامش الحدث وبنياته المتعددة والمركبة وأنماط حداثية يطول شرحها في فهم التاريخ. بل هو يتّكئ على عقلانية نقدية في تقصّي الخبر وترجيحه وإقامة المقارنات الثاقبة.
(السفير)