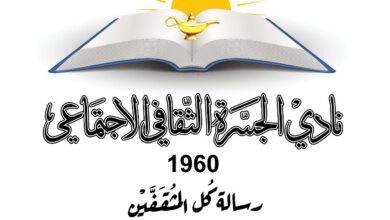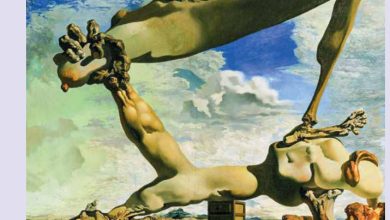من موت المؤلف إلى موت القارئ – منصف الوهايبي
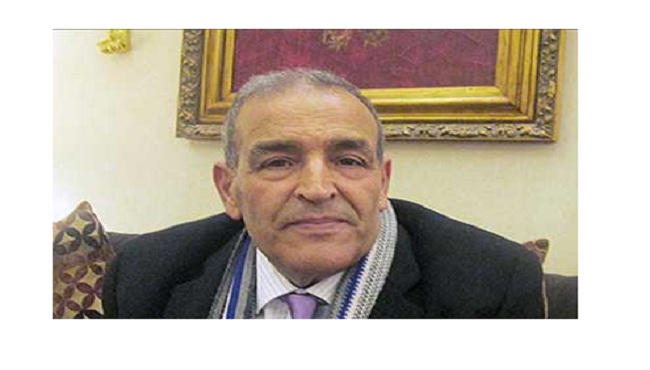
لتعترف بأن المفاهيم الوافدة على ثقافتنا، بما فيها الإنشائية أو الأدبية أو الشعرية و«التناص» وغيرها، غير مؤسسة في النقد العربي القديم، ناهيك عن الحديث؛ إذ لا يعدو الأمر أكثر من «نقل» عن المصادر والمراجع الغربية، عند من رزقوا حظا أو حصلوا نصيبا من اللغات الأجنبية. ولعل هذا ما يفسر كون الأخذ بمفهوم لم يتأسس بعد لا يخلو من بعض مجازفة ، ومن قدر غير يسير من المغامرة؛ بل هو يمكن أن يفضي إلى خلل منهجي بسبب الخلط بين التيارات والاتجاهات، بدون سند من اختبار النصوص والاستئناس بها. وهو ما لا يمكن تلافيه، إلا بشواهد دقيقة؛ تنم عن حس صاحبها النقدي، ومن غير أن يتخذها مسلمات، أو يغفل عن تحليلها، ويحذر أن يجعل منها حجابا عن أوجه الاختلاف بين النصوص، وهي التي تدور على أكثر من شكل من أشكال التداخل؛ مما يدرك في سياق التداخل النصي بين ثقافتين في مستوى أول: ثقافة الأذن أو ثقافة السلطة، وثقافة العين أو ثقافة العقل؛ ثم في مستوى المؤثرات الأجنبية.
ولعل حسا نقديا مدربا، أن ينبهنا إلى أن الزمنية الخطية لا تناسب الزمنية الروائية أو الزمنية الشعرية؛ فالأمر أشبه ما يكون بشريط سينمائي، حيث لا نرى الحدث في ذاته، وإنما إعادة إنتاجه. إن هذه الزمنية في ثقافة عربية لا تزال مرتبكة؛ لا تتوزع إلى ماض وحاضر ومستقبل، وإنما هي على ما نرجح ـ حاضر أبدي، ولا يحتاج الباحث أو الناقد أو القارئ شأنه شأن الكاتب، إلى أن يعيد إحياء «الموتى» (موتانا وموتى الآخر) فهم حاضرون في النصوص، ونحن نحاورهم باستمرار. وضمن الوعي بأن الأدبي قائم على التداخل، فإنه منشد إلى نفسه مثلما هو منشد إلى سابقه بل إلى لاحقه؛ إذ هو ينشأ «قرائيا».
إن القراءة ـ ولا نقول النقد، فهذا على ما يبدو اصطلاح ولى زمانه ـ استئناف لإنشائية الأثر، والأثر الأدبي، خاصة السردي والشعري؛ هو في صميمه ذو طبيعة «قرائية»؛ فهو لا ينشأ كتابةً أو تشكيلا أو تنغيما؛ ثم يُقرأ. إنما هو ينشأ منذ البداية قرائيا، ينشأ وهو يَقْرأ مواده وخاماتِه وكل ما يدور في فضائه؛ أي في سياق ما يصطلح عليه بمنظومة الاستقبال أو التلقي. ولكن هذا الأثر يَقرأ ما يقرأ أساسا حسب ما تمليه عليه طبيعة جنسه، وبحسب ما يستعيره من عناصر من الأجناس الأخرى، فلا يمكن أن ننفي لا في «الشفوي» ولا في «الكتابي» التراسل أو التجاوب أو التناص. ومادام النص يتسع لهذه الظواهر، فلا ضير أن نصل بعضها ببعض، وأن نتنبه إلى أن منبتها الأصلي هو الأدب نفسه. كما أنه لا ضير أن نستدعي إلى مفهوم جديد مثل «التناص»، ظاهرة قديمة كالـ»السرقات»؛ وإن لم تكن بالوضوح الكافي في النقد القديم. ومثلما لا حرج من تهجين الأجناس الفنية أو الأدبية، لا ضير أيضا من تهجين المفاهيم شريطة مراعاة قواعد التهجين، حتى لا يكون المُنتـَج مسخا. وحتى لا يحجزني النظري، أسوق مثالين أحدهما من الأدب السياسي، والثاني من الشعر؛ وفيهما نتبين كيف تنتقل الأفكار والنظريات شأنها شأن الناس، كما يقول أدوارد سعيد؛ عبر الأفراد والمواقف، وحجب الزمان والمكان، فتطعم الحياة الثقافية، وتغذيها بأسباب الحياة والبقاء؛ وتصنع القارئ الكاتب. وقد تخيرتهما هكذا صدفة، وبإمكان القارئ أن يجد ضالته في غيرهما؛ عسى أن يشاطرني الرأي في أن العلاقات بين النصوص حقائق عقلية موضوعها المعاني وهي تتنقل من سجل إلى سجل أو لعلها علاقة الفاعل بالمفعول، والسبب بالنتيجة.
هل كان لفلاديمير لينين؛ لولا حبه الشعر والأدب عامة، وخفة روحه، أن يسمَ كتابه الشهير «ما العمل» عام 1902 بالعنوان ذاته الذي وسم به نيكولاي تشيرنيشفسكي روايته الوحيدة والشهيرة «ما العمل؟» عام 1863؟ كان لينين يقول لرفاقه إن هذه الرواية تهز المشاعر؛ وتمنح الإنسان الطاقة طول العمر.
ولعلها فعلا كذلك، فقد تركت ميسمها في ذلك الجيل من الثوريين الروس في القرن التاسع عشر. جميل ما كان يدعو إليه هو أو ملهمه تشيرنيشفسكي من أن سعادتنا في سعادة الآخرين؛ كلما اقترنت مصلحتنا بمصالحهم. على إنني أتساءل هل يمكن أن يكون «رخماتوف» بطل روايته مثالا لنا اليوم كما كان لمنظمة «نارودنايا فوليا» وأعضاء الحزب الاشتراكي الثوري؟ أليس هو شخصية خيالية في مدينة حقيقية؟ ربما هو عود الكبريت الذي لا تطفئه الريح؟ لم يكن بإمكان البوليس القيصري أن يقبض عليه؟ أو أن يودعه السجن حيث وُلد، وهرب من المجتمع الذي نشأ به ودرج ليقوضه عام 1917؟
ولينين أقرب إلى ماركس، وأثره فيه لا يخفى؛ من ستالين المخيف.. ماركس «صرصار لافونتين» الحالم بالجنة الأرضية. ولينين كان أيضا صديقا حميما لمكسيم غوركي. وكان كما يقول عنه غوركي، صاحب نكتة مرحة، يمتلك ـ وهو الذي عاش أكثر من مأساة حتى في عائلته بعد شنق أخيه ألكسندر ـ قدرة على الإصغاء لمحاوريه وممازحتهم، بل قدرة على الضحك من أعماق قلبه، بسذاجة وطيبة؛ وهو يمسح دموعه؛ ويقول لمن حوله إنه لشيء حسن أن نرى الجانب المسلي من إخفاقاتنا وإحباطاتنا.
وما تذكرته، إلا تعجبت من هؤلاء السياسيين الروس الجدد ،وهم دائما مكشرون عابسون، وكأنهم يهرون للحراش.
أما المثال الثاني فهو استعارة المرآة في الشعر. وهذه كلمة أغرت السيرياليين ومريديهم مثل بول أيلوار وكوكتو خاصة؛ إذ وجد هؤلاء وغيرهم في صورتها تماثلا بينها وبين الحلم، وقدرة على التقاط تحولات الأشياء والكائنات. والقصيدة السيريالية كالمرآة ذات سلطان سحري. وكل سحر هو ضرب من الدهشة، وكل دهشة هي ضرب من السحر. وما بين هذين القطبين يسري ضوء القصيدة، ويجري في الاتجاهين من السحر ومن الدهشة إلى السحر؛ فيلتبس الواقع بظله، والشيء بصورته، والحقيقة بوهمها. والشاعر السيريالي هو شاعر المفارقات؛ والمفارقة احتجاب وسفور في آن. وهل شعرنا العربي في نماذجه الحداثية اللافتة سوى صورة من «مرابط الاختلاف» هذه أو «الأبدال» أو»محطات الترحيل»؟
ومن ثمة لا غرابة إن كان القناع والمرآة من أظهر الأدوات الشعرية التي توسل بها السيرياليون العرب ومن نحا منحاهم . وفي المرآة كما يقول بول أيلوار:
« ما أخذته اليد يأنف هو أيضا أن يتخذ هيئة اليد
العصفور التبس بالريح
والسماء بحقيقتها
والإنسان بواقعه».
على أن «المرآة» من حيث هي أداة، بإمكان الشاعر أن يرفعها في وجه الماضي مثلما يرفعها في وجه الحاضر، ليلتقط الكائنات والأشياء من الزاوية أو المنظور الذي يريد ليست أسلوبا في الشعر العربي الحديث ابتدعه أدونيس، ولا هو استفرد به كما كتب العلاّمة إحسان عباس؛ فقد سها عن أن المرآة أسلوب استحدثه السيرياليون في الشعر، بل كانت موضوعا متواترا في فن النهضة الأوروبي. وعلى الرغم من أن شعراءنا ينوعون مراياهم حتى لا يكاد شيء يفلت منها؛ فإن مرايا المجسدات قد لا تختلف عندهم عميقا عن مرايا السيرياليين؛ فهي عين الخيال التي ترى ما لا يرى، فتخرق قشرة الشيء حتى يصبح مرآة لنفسه، وتصلُ المتخيل بالبصيرة؛ فاذا العين «نافذة محفورة في لحمنا، تنفتح على قلبنا، فنرى فيه بحيرة شاسعة وشجرة كبيرة» كما يقول أندريه بروتون.
لنقل نحن في الأدب وغير الأدب، لا نرى بعيوننا بقدر ما يرى بعيون الآخرين، أو عين المجتمع الذي نعيش فيه، حتى الأعمى لا يُستثني، فصوت محدثه الحاد أو الأجش، يثير في نفسه إذ يدرك أنه موضوع نظر، ردودا واستجاباتٍ غرزها المجتمع فيه. وهي عادة ردود واستجابات خاصة بعالم المبصرين، حيث لا قيمة للألوان إلا من حيث هي حاملة لرسالة أو مشحونة بمعنى، وليس من حيث هي مجرد ظواهر بصرية. واللون كالصوت مرئي بقدر ما هو متخيل؛ فنحن نراه بالبصر مثلما نراه بالبصيرة، بل لعله عرفان صوفي أو سيماء، أو ضرب من السحر والطلسمات؛ قد يكون من غاياته إحداث أمثلة وخيالات لا لها وجود في حقيقة الحس. وأقدر أن أكثر شعرنا اليوم يجري في هذا المجرى، وهو من ثمة أحوج ما يكون إلى نظام قرائي مؤسسي خاص ينهض به قارئ جديد؛ عسى أن يكون ذاكرة لغتنا قبل أن يكون ذاكرة الآخر.
كان رولان بارت ينعى منذ عقود قريبة «المؤلف» ويبشر بميلاد «القارئ»، ولكننا اليوم نكاد لا نشهد سوى موت القارئ.
* المصدر: القدس العربي