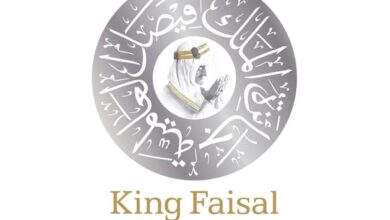«أحد عشر ظلاًّ» لفتحي عبد السميع: الشعر وسيلة لاكتشاف الذات والمكان

صفاء ذياب
سقط الجدار الطيني… فتناثرت من شقوقه المهشّمة …. خصلاتٌ من شعر أمي…. جمعناها في كيس… وألقيناها في النيل
…..
تجلس بين طيورها المنزلية
وتسرّح شعرها
قماشة بيضاء على حجرها
وشمسٌ حانية ترفرف حولها..
يبني الشاعر المصري فتحي عبد السميع نصوصه من حياته اليومية، يعيد إنتاجها وكأننا نعيش في الصعيد المصري وسط محافظة قنا التي يأتي منها عبد السميع، شعراً وفكراً وثقافة، لهذا تراه يعيد إنتاج هذه الثقافة في أكثر من كتاب، ابتدأها شعراً، وأكملها بحثاً في محاولات كثيرة لقراءة واقعه، والآن يعود مرّة أخرى ليغذيها بنصوص جديدة جمعها تحت عنوان «أحد عشر ظلاًّ لحجر» الذي صدر مؤخراً عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة، بواقع 108 صفحات من القطع المتوسط.
ست عشرة قصيدة ضمتها المجموعة، قسّمها عبد السميع إلى ثلاثة محاور، بوبّها بـ «ظلٌّ على الباب المفتوح، أحد عشر ظلاً لحجرٍ يقوم من النوم، ورجفة الوداع..» ومن عناوين هذه المجموعة: «قاطع الطريق الذي صار شاعراً، عظامي شفافة وهذا يكفي، وسام لأحفاد البلطة، شبيه الطرحة والمنديل، الضغائن في الشباك، صانــــع المطــر يظهر ليلة الوقفة» وغيرها الكثير.
وفي حديثه عن مجموعته هذه، يقول عبد السميع، إن هذه المجموعة تتكون من نص في البداية يحكي عن قاطع طريق تحول إلى شاعر، يليه أحد عشر نصاً، تمنح البطولة لأشياء تتسم بالضآلة، أو الهامشية، والبعد عن دور البطولة في النص الشعري، مثل الفلاية، الشبشب، البلطة، وتأتي تلك النصوص تحت عنوان «أحد عشر ظلا لحجر يقوم من النوم»، والحجر لا يمكن ترجمته إلا من خلال قراءة المجموعة ككل، ويمكن اعتباره حالة يصعب تحويلها إلى كلمات محددة، بل تحتاج إلى من يختبرها من خلال النصوص، وتلك الحالة أشعر بها في ذهني مرة، فيحطُّ النومُ، بمعنى العمى وافتقاد البصيرة. وأشعر بها في قلبي مرة، فتحط القسوة والبلادة، والقصائد محاولة لمقاومة تلك الحالة الحجرية، محاولة لتحريري، وتحرير القارئ بالضرورة، من الزنزانة الذهنية التي نعيش فيها، والنظر إلى العالم بشكل مختلف. وما يقال عن الحجر يقال عن الظل، وهو هنا قد يرادف القرين، أو الوجود وفق مقياس آخر، مقياس اليقظة أو القيمة الداخلية، والعدد لا يعبر عن الكل، بل عن مجموعة من الظلال التي يمكن أن تتضاعف وفق درجات التحول من النوم إلى اليقظة.
غير أن الملاحظ في هذه المجموعة اهتمام عبد السميع بالفولكلور الشعبي أكثر من الموضوعات الكبرى التي اهتم بها في أعماله السابقة.. وفي تساؤلنا عن هذه الالتفاته، يشير عبد إلى أنه يحسب نفسه شاعراً تجريبياً، يتمرد كثيراً على ما يكتبه، ويحاول أن يحقق إضافة لرصيده، وتسعدني كل ملاحظة ترصد وجود تغير ولو بقدر ضئيل، لكن «اهتمامي بالفلكلور لم يكن التفاتة، بقدر ما كان أمراً طبيعياً لقصيدة تحاول أن تلتصق جداً بحياة شاعرها، ولشاعر يحاول أن يلتصق كثيراً بقصيدته، والفلكلور ليس شيئاً عارضاً، بل يحضر في مناطق عميقة من الذات الجماعية والفردية، ومن الطبيعي أن يظهر إن لم يقمعه الشاعر. كما أن الموضوعات الكبرى لا يمكن أن تختفي، سنظل نفكر في الموت والحياة، لكن الموضوعات الكبرى تتأثر بطريقة النظر إليها، وقد تتجلى من خلال حدث كبير، أو من خلال أحداث صغرى، والحدث الكبير غالباً ما يكون قاسياً على الشعر، إذ يفرض حضوره على الجمال الفني، لكن الأحداث الصغيرة تحنو جداً على الشعر، فتسطع الموضوعات الكبرى من خلالها بشكل مراوغ ومتوهج شعرياً». ربما كان لاهتمام عبد السميع بالموضوعات الشعبية تأثير واضح على اشتغاله الشعري، لهذا يرى أنه في الشعر صدى لما يسكن الإنسان، وما يشغله، وما يتفاعل معه، ولا شك أن «اهتمامي البحثي ألقى بظلاله على نصوصي، فالشاعر والباحث ينبعان من ذات واحدة».
قدّم عبد السميع نصوصه هذه بتقنيات مختلفة عن نصوصه السابقة، خصوصاً أن نصوص هذه المجموعة اتسمت بالطول وبتقطيعها إلى مقاطع مترابطة لتصل إلى ذروة بنية سردية داخل القصيدة، لكنه يرجئ الحديث عن التقنيات والقيمة الفنية للنصوص إلى النقاد الذي سيتابعون مجموعته هذه.. وفي الوقت نفسه يؤكد على أنه يميل إلى كتابة النصوص القصيرة، غير أنه رأى أن موضوعات هذه المجموعة وبنيتها جعلته يبحر في طول هذه النصوص، «لكنني لا أعمل وحدي، فالنصوص تكتب نفسها أيضاً، وتأبى أحياناً تحديد حجمها بعدد من الأسطر، وكثيراً ما تفرض النَّفَس الطويل، وكثيراً ما أتمسك بها أيضاً آملا حلْبها حتى آخر قطرة، وهكذا كان الحل في المقاطع القصيرة، التي تبدو منفصلة ومستقلة، لكنها تشكل جمعاً واحداً». كان للمكان تأثير واضح على نصوص هذه المجموعة.. فعبد السميع ابن الصعيد والحياة الريفية التي يسعى لإعادة إنتاجها مكاناً شعراً يمكن أن يستوعبه القارئ البعيد عن تلك الأماكن.. وعلى حدِّ قوله، فإن في الحياة بشكل عام، وفي الشعر بشكل خاص، لا يوجد شيء بمعزل نهائي عن شيء آخر، الحياة متشابكة ومتداخلة جداً، وهناك أشياء تملك قدرة هائلة على تجاوز الحدود، فكل حياة تُعاش بصدق تكسر المسافات، وكذلك، كل قصيدة تُكتب بصدق. و»المسألة لا تتعلق بمكان بقدر ما تتعلق بروح، والروح تصطبغ بمكانها لكنها تتجاوزه، ولا يوجد في تقديري سلوك محلي يخلو من بعد إنساني، فكل سلوك فيه الفردي والجماعي والإنساني، وكلما عاش المرء بشكل متناغم، تجلت تلك الهويات الثلاث، الفردي، والجماعي والإنساني، وهكذا، يمكن لأي شخص، أن يعيد مكانه وحياته الخاصة شعراً، ويصل لكل إنسان، طالما كانت هناك أولوية للشعر، أمير الهويات الثلاث، وصاحب السلطة العليا. وطالما كان ذلك الشخص صادقاً، ومتناغما ومتصالحاً ومتسقا مع ذاته على أكبر نحو ممكن».
لم يكن الشعر عالم فتحي عبد السميع الوحيد، بل أخذ البحث حيزاً طويلاً منه، خصوصاً أنه منهمك في البحث البيئي عن التأثر والأوضاع القاسية التي يعيشها الصعيد المصري.. فإلى أي مدى أثر هذا البحث في نصوصه؟
كان جوابه عبد السميع عن تساؤلنا هذا، هو أن عمله البحثي وثيق الصلة بعمله الشعري، ووثيق الصلة بحياته اليومية أيضاً، «فأنا أبحث في ما أعيشه، أبحث انطلاقاً من ذاتي فقط، وفي أمور إنسانية في المقام الأول، ونصوصي الشعرية هي التي أثرت في عملي البحثي، لكنها عادت وتأثرت به أيضاً، فالشعر هو الذي قادني للبحث باعتباره جزءاً من عمل الشاعر، فالشاعر باحث، لأنه من حيث المبدأ كائن متسائل وراصد ومتأمل، يعرف الجوع المعرفي والجوع الجمالي معاً، يعتمد على الخيال والانفعالات والمجاز، لكنه لا يفرط في عقله أبداً، الشاعر يعبر ويكتشف أيضاً، ويظل الشاعر كائناً متفاعلاً، ونصوصه لا تتأثر بكل شيء يعيشه، بل تصطفي من حياته تلك الأشياء التي تفاعل معها بقوة».
أما كيف استفاد من لغته المناطقية في تغيير بنية القصيدة، فيكشف أن التصاقه بالمكان رصداً وتأملاً جعله يتفاعل مع مفرداته المختلفة، وقد انعكس ذلك على نصوصه، ومنحها- في ظنه- طعماً خاصاً، كما انعكس على «تكويني الشخصي أيضاً، ومن الطبيعي أن يتجلى ذلك التفاعل في نصوصي على مستوى المفردات والتراكيب والأساليب والعوالم المطروحة، وأحياناً المنظور، أو رؤية العالم، ولم يكن ذلك التفاعل في تقديري من طرف واحد، لم يكن مجرد عشق وغرام بالمكان، بل كان حواراً جاداً ودائماً بين ندين، ولم يكن ذلك الحوار يتعصب أو ينحاز إلى المكان، أو الذات، كان ينحاز دائما للشعر، باعتباره الهوية الأولى للشاعر، أو يتعصب لذات خيالية تسكنني، ولا أستوعب كل أسرارها، ذات أخرى تبني عالمها بالمواد التي أعرفها والتصميم الذي تعرفه أو تريده هي، فالشعر وسيلة لكشف واكتشاف الذات والمكان معاً، وهو جسر سحري يخرج دائماً من الفردي والجماعي، إلى البراح الإنساني الواسع».
(القدس العربي)