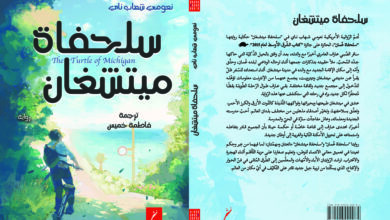الصورة التي تصادفنا في كل مكان… وصناعة الواقع

ليث عبد الأمير
يبدو مفهوم الصورة للوهلة الأولى بسيطاً وغير مستعص على الفهم، والصورة كلمة شائعة في قاموسنا العامّي، وربما الأكثر استخداماً في مفردات حياتنا اليومية، ما دفع بوصف عصرنا بـ»حضارة الصورة».
والصورة مبهجة وجذابة بطبيعتها، وهي شاملة في وجودها تلاحقنا في كل مكان سواء أكانت ملتقطة بعدسة تصوير فوتوغرافية أم مرسومة بريشة فنان، منحوتة من برونز أو من حجر، وسواء أكانت ثابتة أم متحركة، فيلما سينمائياً أم رسماً متحركاً من أفلام الكارتون، معلقة على واجهات المحلات أم على سطح شاشات هواتفنا الخلوية، في الكنائس التي تزهو بمنحوتات وصور مريم العذراء والسيد المسيح، أم معلقة في الشوارع تعلن عن صور المرشحين والمرشحات لانتخابات مجالس البلدية، أو ما شابهها في بلدان الديمقراطيات الغربية، أو صور الطغاة التي تطاردنا في الشوارع والساحات العامة بسحنهم الصارمة والمهيبة.
نعثر ونتعثّر بالصور على أغلفة البضائع التجارية أو بين صفحات الكتب ومجلات «الفاشن».. لكن تبقى الصورة غامضة لا تمنح نفسها بسهولة ويستحيل اعطاؤها وصفا دقيقا أو تحديدا واحدا.
الصورة تضايق وترعب الديكتاتوريات والدول الديمقراطية على حد سواء، وأنشئت (على شرفها) لجان المراقبة ورقباء للصور (كانت تملك بريطانيا في بداية القرن العشرين أقسى نظام رقابة في أوروبا الغربية ممثلا بالمجلس البريطاني للرقباء، الذي أصدر عام 1909 قانون السينماتوغراف) وفي الاتحاد السوفييتي كان يشاهد ستالين بنفسه الأفلام قبل عرضها في صالات السينما ووضع عليها رقيبا وهو شوميانسكي، ترك أمامه رأسه رهينة لأي خطأ أو زلة، وفعلا أعدمه ستالين عام 1938.
وقد تكون الصورة دراماتيكية فيصبح تأثيرها الشعبي أو السياسي في هذا الحال قويا وفعاّلا. نتذكر بهذا الخصوص ما أثارته الرسومات الكاريكاتيرية المسيئة للرسول لدى المسلمين من مشاعر وأحداث دموية، وكلنا يتذكر الصور الكاريكاتورية التي نشرتها صحيفة «تشارلي إيبدو» الفرنسية عام 2012 أو ردود الفعل العالمية التي أثارتها صور التعذيب في سجن أبو غريب في العراق بعد نشرها في أبريل/ نيسان عام 1944 إثر الغزو الأمريكي له عام 2003، وظهرت فيها صورة لرجل عار تقوده مجندة أمريكية من سلسلة بيده وهي ليندي أنغلاند.
أهمية الصورة تتأتى من قدرتها على استنساخ الواقع، ومن إمكاناتها القوية في تلبسه ومحاكاته أيضاً، وهي قادرة على إعادة إنتاجه من جديد وبأشكال مختلفة. واعتبرت السينما الحاضن الأكبر للصورة من بين باقي الفنون التشكيلية لأكثر من قرن. فقد حمل المصورون السينمائيون الأوائل كاميراتهم إلى أماكن مجهولة من كوكبنا بحثاً عن صور جديدة، وهكذا رفعت شركة باتييه الفرنسية شعار «نرى كل شيء ونعلم عن كل شيء». وعُرضت منذ 1908 وحتى 1926 حوادث وقصص حدثت فعلاً في مكان ما من كوكبنا بعد إعادة تصوير الواقعة الحقيقية داخل استديوهاتها.
توّلد الصورة فينا انفعالات حسية سريعة نحن بحاجة لها كي تهز دواخلنا والسكون الذي يلفنا كالغمامة. فالصورة إذن قادرة على الإثارة بسبب قدرتها الوصول إلى أماكن مظلمة في النفس، وستبقى الصورة إلى فترة طويلة مهما تنوع شكلها واقعية أم خيالية، تعبيرية أم سيريالية، فوتوغرافا أم رسوما متحركة.. تبقى الصورة الوسيط القوي الذي يربطنا كحبل السرة بالعالم والواقع الذي يحيطنا.
لا يوجد شيء يضاهي عشقنا للصورة وانجذابنا نحوها، منذ الأزل ونحن نستنطقها ونتعايش معها بكل أشكال تجسّدها وتجليّاتها، فالصورة ذاكرتنا وهي فعالة وقوية تعكس المخاوف والرغبات التي تعيش فينا أكثر من الكلمة المقروءة التي تراجعت في السنوات الأخيرة أمام هوس الانتصار المدوي للصورة، فلم تعد الكلمة مقروءة إلا في حدودها الضيقة. لقد ضاع صدى صرخة غودار تحت ضجيج الصورة، هذا المخرج الفرنسي الذي يعتبر واحدا من أكثر المخرجين غزارة في الإنتاج السينمائي الذي أعلى من ش%