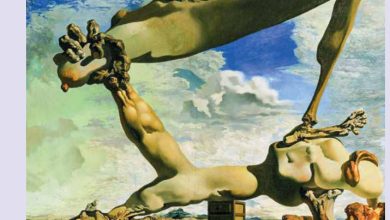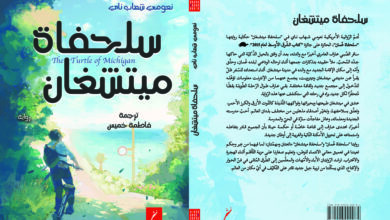المُـثـقَّف الجامِعِـيّ أو أَسْرَى كَهْف أفلاطون

(الجسرة)
صِفَةُ «الجامِعِيّ» التي أسْتَعْمِلُها، هُنا، لَيْسَتْ بمعنى «الأكادِيمِيّ»، رغم أنَّ الجامِعِيَّ هذا، هو نفسُه الأكادِيمِيّ. كنتُ سابِقاً، كَتَبْتُ عن الأكادِيمِيَّةِ. وعن المُثقَّف الأكادِيمِيّ، الذي اعْتَبَرْتُه خارِجاً من عباءَةِ أفلاطُون، الذي كان هو مُؤَسِّس الأكادِيمية، وهو مَنْ عَزَل الفَلْسَفَة عن الفَضَاء العامِّ، بالمعْنَى الذي كان بِه مُعَلِّمُه سقراط يُمارِسُ التَّفَلْسُف. فأفْلاطُون أحاطَ تعليم الفلسفة بالأسْوار، واعْتَبَر الفَلسفَة شأناً يَهُمُّ من يَدْرُسُونَها، وفق شُروط وقواعِدَ، الأكَادِيميَّة هي مَنْ تَضَعُها، لا ما يُمْكِنُه أن يَجْرِيَ خارِجَ أسْوارِ الأكاديميةِ من أفْكارٍ ونقاشاتٍ.
أفْلاطُونُ، بهذا العمل، انْقَلَبَ على سُقراطَ، وأدْخَل سُقْراطَ نفسَه إلى الأكادِيميَّةِ مُرْغَماً، لأنَّه هو مَنْ نَقَل إلينا أفْكارَ مُعَلِّمِه، وهو من كان النَّاطِقَ بِلِسانِه، في كُلِّ ما وَصَلَنا مِنْ أعمالِه. فهو حَرِصَ على تحويل هذا العَقْل الشَّارِدِ، المُتَسَكِّع في الطُّرُق والشَّوارِع، الذي كانتْ نتيجَة «طَيْشِهِ» الإدانَة بالموت، إلى عَقْلٍ لَيْسَ من حقِّ الجميع، بل، فقط، مَنْ يَدْخُلُون الجامِعَة، ويَخْضَعُون لنظام التعليم فيها.
أمَّا مَنْ هُم خارِجَها، فلَيْسُوا أهْلاً للحديث في الفلسَفَة، أو عَنْها، وحتَّى إذا ما تحدَّثُوا فيها أو عَنْها، فحديثُهُم ليس مُهِمّاً، ولن يكون مُفيداً، لأنَّه ليس حديثَ أهْل المعرفةِ، أي من دَرَسُوا في الأكادِيمِيَّة. فهو قَصَر المعرفة على ما يكُون داخِلَ الأسْوارِ، لا خارِجَها، وقَبْل أن يَأْسَر الفلسفةَ والفِكْرَ داخل الأسْوار، فهو عَمِل على إدْخال سُقْراط، أيضاً، إلى هذا السِّجْن المعرِفِيّ، كَيْ لا يبْقى مَرْجِعاً، أو نموذجاً للعقل الشَّارِد، الذي يُحاوِر بلا انْقطاع، ويُشِيعُ القَلَقَ في السَّاحاتِ، والفضاءات العامَّة، أو يَجُرُّ «العوَامَّ» إلى التَّفْكِير، وفق آلِياتِ العَقْل والمنطقِ، وهذا، ربما، فيه خطر على الفلسفة نفسِها.
الجامِعَة، من هُنا خَرَجَتْ، من هذا الانْغِلاقِ، من فِكْرَة الأسْرِ، والانْعِزال عن المُجتمع. ثمَّةَ ما ينبغِي ألا يَصِلَ إلى العامَّة. فالجامِعَةُ هي فَضَاءٌ لِتَرْوِيضِ العَقْل على الانْضِباط لشُرُوط وقواعِد الأكادِيميَّة، لهذا الإرْث الأفلاطُونِيّ، رغْمَ أنَّ الجامِعَةَ، في نهاية الأمْرِ، هي مُؤسَّسَة من مُؤَسَّساتِ المجتمع، وَمَنْ يَدْرُسُون فيها، هُم أبْناء هذا المُجْتَمَع، ممن سيتَوَلَّوْنَ تَسْييرَهُ، وتَدْبِيرَ شُؤُونِه، وهُم من سَيَعُودُون إلى الجامةِ نَفْسِها، لِنَقْلِ ما اكْتَسَبُوه، من علومٍ ومعارِف، إلى الأجيال القادِمَة. ما يعْنِي، أنَّ الجامِعَةَ، في معناها الأكادِيمِيّ الأفْلاطُونِيّ، هي احْتِكارٌ للمعرفَة، وللتَّكْوِين، وهي فَضَاءٌ لِتَرْوِيض الخُيُولِ الجامِحَةِ، ووضْعِها في مِساحاتٍ ضَيِّقَةٍ، مَخْنُوقَةٍ، لَمْ تَعُد تَسْمَحُ بالجُمُوحِ والانْطِلاقِ، أو بالتَّفْكِير الحُرّ، الذي يَعْمَل على توليدِ الأفْكار بالمعنى السُّقْراطِيّ الحُرّ والشَّارِد.
المُثقَّف الجامِعِيّ، اليوم، هو وَرِيثُ هذا الأسْرِ، وهذا الحَصْرِ والتَّسْييِجِ الذي تعرَّضَ له الفِكْر والفلسفة، أو أصابَ المعرِفَة عُموماً. فهو داخِل الجامِعَةِ وُلِدَ، وفيها نَشَأَ، وعَقْلُه أصْبَح أسِيرَ اخْتِصاصٍ ضَيِّقٍ ومُغْلَقٍ، ولَمْ يَعُد يَقْبَل التَّوَسُّعَ، أو الخُرُوجِ من الحَقْل الذي أَنْبَتَه، إلى غيره من الحُقُول التي يراها بَعِيدَةً عنه، أو تُشَوِّش اخْتِصاصَه، وتُبَلْبِله، أو رُبَّما تُزَعْزِع أسْوارَهُ التي أسَرَ نَفْسَه داخِلَها، والتي من ورائِها يَنْظُر إلى الكَوْنِ، بدُونَ أن يكونَ طلِيقاً، يُواجِه الرِّيحَ بما يَكْفِي من مجادِيف، مهما كانتْ طبيعَة اللُّجِّ، أو عُلُوّ المَوْج.
بهذا المعنى، الجامِعَة، أصْبَحَتْ مِثْل الجماعاتِ الدِّينيَّة أو العقائديةِ المُغْلَقَةِ، التي لا تَقْبَل غَيْر من يُسايِر فِكْرَها، يَتْبَعُها، ويكونُ طَيِّعاَ لِما يُمْلَى عليه، لا ما يرَغَبُ فيه هُوَ، أو ما يَشْغَلُه من أفْكار، وما يتَبَنَّاهُ من مناهج وأفْكار. وأُشيرُ، في هذا السِّياق إلى بعض المثقَّفِين الذي دَرَسُوا في الجامعة، وحَصَلُوا فيها على شهاداتهم ودَرَّسُوا فيها، لكنَّهُم، لَم يكونُوا صَدًى للفِكْرِ «العقائِدِيّ» المُغْلَق، أو للطَّاعَةِ العَمْياء، التي يتحوَّل فيها الطَّالبُ، إلى صَدًى، وإلى تكرار لأصْواتٍ، فيها كثير من حَشْرَجاتِ «العِلم» و «المعرفَة»، أو فيها من التَّخَشُّب ما يكفي، ليجعل من عَقْلِه خَشَبَةً تَطْفُو في ماءٍ مالِحٍ، أو أُجاجٍ، بالأحْرَى. أُذَكِّرُ هنا، بطه حسين، الذي أحْدَثَ ثورةً داخِلَ الجامعة، والذي ستَنْقَلِبُ عليه الجامِعَة، لأنَّهُ رَجَّ أسوارَها، وأحْدَثَ فيها شُرُوخاً، لَم تَقْبَلْها، أو رَأَتْ فيها إيذاناً بِكَسْر الطَّوْقِ. كما أذْكُرُ علي عبد الرازق، الذي جُرِّدَ من وظيفتِه، وطُرِدَ من «جامعة الأزهر» التي كان بين أهم علمائها، لأنَّ كتابَه «الإسلام وأصول الحكم»، كان حَجراً كبيراً، رَمَى به في بِرْكَة «الخِلافَة الإسلامية»! وغير هذيْنِ الرَّجُلَيْنِ، من أولئك الذين انْتَصَرُوا للمعرفة في صَيْرُورَتِها، وفي انشراحها، لا في انْضباطِها العسكريّ أو الدِّيني، أو حتَّى الأيديولوجي، الذي هو الأوامر والنَّواهِي.
عندنا في المغرب، أغلب المثقَّفِين الجامِعِييِّن، أو الذين تخرَّجُوا في الجامعة، ودرَّسُوا فيها، ممن لَهُم حضور في الواقع الثَّقافي، ومن لهم أفكار حقيقة، ولهُم مشاريع، في الشِّعر، وفي الفلسفة، وفي علم الاجتماع، والعلوم الحقَّة، وفي النقد، وغيرها من حقول المعرفة، أي مَنْ يُنْتِجُون، و«يَعْمَلُون»، بالمعنى الذي اسْتَعْمَلَه طه حسين في مقدمة كِتابِه «مع أبي العلاء في سجنه»، «إلى الذين لا يَعْمَلُون، ويُؤْذِي نُفُوسهم أنْ يَعْمَل النَّاس»، هؤلاء كَتَبُوا، وابْتُلُوا بالمعرفة والإبداع، قبل أن يدخُلُوا الجامعةَ، أو قبل أن يكُونوا مُدَرِّسِين فيها، بل إنَّ الجامعة هي من اسْتفادَتْ منهم، رغم أنَّ بعضَهُم، اسْتَعْمَل الجامِعَة لِنَفْسِه، وللبحث في أعماله وكتاباته هو، ومَنَعَها عن غيره، ممَّن اعْتَبَرَهُم غير «أكادِيمِيِّين»، وكأنَّ الشِّعْرَ، نتعلَّمُه في الجامِعَة، وهذه من مُفارَقاتٍ بعض هؤلاء، ممن أرادوا«الحق في الشِّعر» لنفوسِهِم، فقط، ليَصُدُّوه، ويَمْنَعُوه عن غيرهم.
فالجامِعَة عندنا، امْتَلأتْ بكثير ممَّن لا يَعْمَلُون، لا يبحثون، لا يكتُبون، لا بالمعنى السقراطي المُتَحرِّر من قيود «الأكاديمية» وأسوارها، ولا بالمعنى الأفلاطُوني، المنضبط لأسوار الجامعة وقيودها، وهؤلاء، هُم «من يؤْذِيهِم أن يعمل النَّاس». فمن هُم هؤلاء إذن، وما الذي يُلَقِّنُونه للطَّلَبَة، ومن أين تأتي أفكارُهُم، إذا كانت لهُم أفكار، وهل دَخَلُوا الجامِعَة بمشاريع وأطاريح وأفكار، ماذا يحملون في رؤُوسهم، وكيف يفهمون عمل الجامعة، ودورها، وعلاقة الجامعة بالمجتمع، والمهام التي ينبغي أن تلعبها في التغيير، والتثوير، وفي إعادة ابتكار المفاهيم، ومناهج الدراسة والبحث، رغم وُجود الأسوار؟
حتَّى لا أسْتَمِرَّ في عَدِّ شيَّاتِهِم، أكْتَفِي باعتبارِ بعض ما قرأتُه من دروس هؤلاء، عندما كنتُ طالِباً في الجامعة، أو ما أطَّلِع عليه من دُروس طلبة يلجأون إلَيَّ لأُساعدهم في بعض ما يجدونَه في طريقهم من مُشْكِلاتٍ في البحث وفي الكتابة، مُجرَّدَ تَراقِيع، وتلفيقاتٍ، بمعنَى القطع والإلْصاق.
أليس هذا المثقف، الصَّامِت، أو المُصابِ بالعَيّ، هو أحد أعْطاب المعرفة عندنا. فهو لا يُوجَدُ خارِجَ الجامعة، كما لا يُوجَد داخِلَها، لأنَّ لا لِباسَ لَهُ، ما يَلْبِسُه، هو لباس غيره، يلبسه بدون أن يُحِيل عليه، أو يلبِسُه مقلُوباً، مُشَوَّهاً، بنقله من مصادره، وفق فَهْم، بعيد عن السِّياق، وبعيد عن طبيعة الأسُس التي بُنِيَ عليها، أو بنوع من الترجمة المُحَرِّفَة للمعنى وللمفاهيم التي يتأسَّس عليها. مَنْ يعُد إلى «أطاريح» هؤلاء، وهُم لم ينشُروها، بل منهم من أخْفَاها حتَّى من أرشيف الجامعة، سيتأكَّد له ما أقولُه، وهذا لا ينطبق على المثقف الجامعِيّ هنا في المغرب، بل في العالم العربِيّ، عموماً، لأنَّ هذا العالَم الذي نحيا ونعيش فيه، هو عالَم بُؤْسٍ بامتياز، لا تسمح فيه المؤسَّسات بِتحرُّر الفِكْر، وبالتَّالي تحرُّر الإنسان وانطلاقه.
هؤلاء المثقفون، يلعَبُون على كُلِّ الحبال، لم تَعُد تشغلُهُم سوى الكراسي الصغيرة داخِلَ الجامعة، أو خارجَها، وهُم لا موقف لهُم، لا في ما يتعلَّق بما يتعرَّضُ له الأدب والشِّعر والفلسفة من احتقار، من قِبَل وزير التعليم العالي الإسلاموي، ولا من قِبَل رئيس وُزارئِه من الحزب نفسه، ولا موقف لهُم في ما يتعلَّق بالهُجُومِ الذي تتعرَّض له اللغة العربية، ناهيك عن الثَّقافة العربية، بدون أن أتحدَّث عن مواقفهم مما يجري في الواقع السِّياسي، الذي يُحاوِلُون فيه البقاء في الزاوية الرَّمادِيَّة، التي لا هي سواد، ولا هي بياض. فَهُم يعيشون في عالَم لا يَهُمُّهُم، رغم أنَّهُم لا يفتأُون، كُلَّما ظهَروا في برامج إعلامية، أو شاركُوا في مهاتراتٍ «علمية» كما يُسَمُّونَها، يَجْهَرُون بصفتهم الأكاديمية، التي هي مثل الأوسِمَة التي يحمِلها مُحاربُ مُسِنٌّ، لم يَعُد يقوى على الحركة، أو الكلام.
المُثقَّف العضوي، هو المثقف الحاضر، المُنْتِج، الفاعِل، الذي لا تأْسَرُه أسوار الجامِعَة، ولا يقبل أن يَعْتَقِلَه أفلاطُون في زُجاجَة، مثلما فَعَل رولان بارث وجاك دريدا، ومثلما فَعَل فوكو، وسارتر، وسيمون دوبوفوار، الذين تمرَّدُوا على ثقافة الانغلاق، وثقافة الاخْتصاص، أبْدَعُوا أفكاراً كبيرة، غيَّرت مَجْرَى الرِّيح، في الفكر الإنساني. ألم ترفض جامعات فرنسا، وفلاسفتها من الأكاديميين، جاك دريدا، الذي احْتَضَنَتْه الجامعات الأمريكية، واسْتَمَعَتْ إليه بإمْعانٍ، لأنَّها أدْرَكَتْ خَطَر ما يَحْمِلُه من أفْكارٍ؟
ستبقى الجامعةُ سجناً، أو ثَكَنَةً، ما دَامَتْ بهذا الوضع، فلا هِي خرجَتْ إلى المجتمع وأثَّرَتْ فيه، ولا هي غَيَّرَت فِكْرَها مُتَأَثِّرَة بما يجري في المجتمع نفسِه من انقلاب في الأفكار والمفاهيم والقِيَم، بل إنَّها أصبحت مثل سِجْن الألْكاتْراز، في الفيلم الأمريكي الشَّهِير، الفِرار منه مُعْجِزَة كبيرة، لأنَّ من يوجَدُون داخِلَه، يرغبُون في الانْطِلاق، وفي التَّحرُّر من هذا الظَّلام الذي ضَجُّوا منه، وأعْشَى أبْصارَهُم، أو هي بالمعنى الأفلاطُوني، مثل سُجناء الكَهْف، أعني كَهْف أفلاطُون نفسه.
٭ شاعر مغربي
صلاح بوسريف
عن : القدس العربي