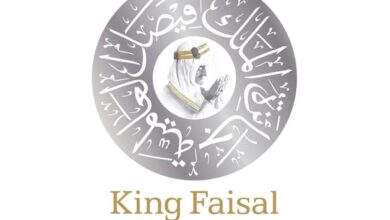خطابات ستوكهولم وأعراضها.. عن منطق الكتابة الجوائزيّة
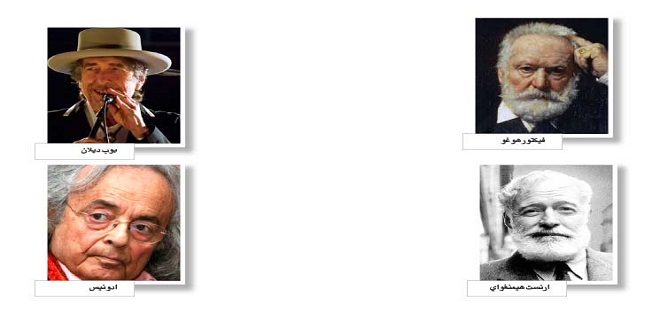
عبد القادر رابحي
ما هي العلاقة بين خطابات ستوكهولم وأعراض ستوكهولم؟ وهل ثمة دليل على أسبقية أحدهما على الآخر؟ وهل كل خطاب هو عرض عابر للمعرفة الملتحفة بأرديةِ ما يضاهيها من تكريس؟ أم أن كلّ عرَض هو خطاب متخفِّ في ارتدادات ما يتكرر في أذهان المبدعين الكبار المرضى بأهوائهم وبتطرّفهم وبهوَسِهم في إخفاء مدى تعلّق المخطوف بالخاطف، والمعشوق بالعاشق؟ وهل بإمكان الخطاب/العرض أن يتحول بتحوّل الجائزة إلى عزف منفرد على الآلة الرّاقنة؟ وهل لبوب دايلان أن يغني في الجمع الكريم إحدى أشهر أغانيه ليشنف آذان لجنة استُنصِحت، هذه المرّة، بإخراج الكتابة، ومعها أحلام الكتاب وانتظاراتهم الطويلة، من الحقول المحروثة بمحاريث التكرار والمفازات المدموغة بما يعود على حسابات المتربصين بالسبق لمعرفة الفائز الذي تعودت الدوائر الفاعلة ترشيحه للقائمة النهائية؟ وكيف سيكون حال (أدونيس)، الأكثر انتظارا لجائزة لا تريد المجيء، لو أنه فاز بها مناصفةً مع المغني المشهور قبل أن تخرج تصورات الكتابة الإبداعية، كما حاول أن يؤسس لها طيلة أكثر من نصف قرن من حسابات مؤسسة نوبل؟ ولماذا يقبل السّلم القسمةَ ولا يقبلها الأدب؟ أليس في الأدب ما يشعل الحروب هو الآخر؟
-2-
أوّل رواية، أوّل غونكور، هكذا.. تُدمغُ أقدارُ بعض الكتاب بالشّمع الأحمر في أول رحلة انقذاف نحو المجهول. تصل لحظة البدء بلحظة النهاية، تماما كما النجم الثاقب الهارب من مغارة الكون والمنطفئ في هوامشه الشّاسعة، دون أن يترك أثرا على سطوح كواكبه ومجرّاته. إنه التتويج الانتحاريّ الشبيه بالنيزك الذي يقطع المسافة بين البطن والقبر، دون المرور الاضطراري بسديم الحياة كما حاكاه فيكتور هوغو في «البؤساء»، ودون التشرّد الغارق في بحر المجازفة، كما رواه همنغواي في «الشيخ والبحر»، ودون التعلق الوجودي بتراب الأرض كما تصوره المعرّي في «رسالة الغفران»، ودون التعريج المستديم على وصفة المكابدة الحِبْرية كما رسّمه التوحيدي في «المقابسات».
من مرحلة البياض الصارخ إلى مرحلة السواد الطّاغي يتأسّس الاختصار بوصفه رؤية متمركزة تُقدِّم على طبق مباشر ما سيصبح عملا متفرّدا من أديب متفرّد استطاع أن يجمع لحظة الولادة الإبداعية بلحظة موتها في مفارقة لم يسبقه إليها أحد من قبل. ولعلها الطريقة الأنجع لاجتثاث فعل الكتابة من تربته الأصلية منذ أن عرَف غيرُ الكتّاب كيف ينتقمون من الكتاب المبدعين، وكيف يحطّمون الأصنام الرمزية التي ما فتئ هؤلاء يشيدونها في أذهان القلّة القليلة من القراء، وفي جيوب الكثرة الكثيرة من دور النشر ووسائل الإعلام الباحثة عن أيقونات قابلة للنقر لتلوين البياض النابت في حقول الإشهار كما تنبت الفكرة في رأس الروائيّ الطامع في أن تُخرِجَه الكتابة نهائيا من حالة الفقر المدقع إلى حالة الغنى الفاحش بضربة حظ يتيمة.
-3-
قد لا تحمل كلّ صكوكِ الجوائزِ المبالغَ نفسها التي يحملها صكّ نوبل في تحقيقها لمزيّة الغفران، ورغم ذلك، فإن ثمة من يرفض فكرة التعليب عن طريق التتويج للتدليل على إمكانية عدم خضوع الخطاب لأثر المتلازمة، أو توطين المتلازمة في بنية الخطاب. فلماذا رفضها سارتر وسارع إليها ألبير كامو؟ ولماذا ينفصل خطاب ستوكهولم عن أعراضه في ما يقدمه سارتر من مبررات عدم قبوله الجائزة؟ ولماذا تسقط المتلازمة من حساباته المحسوبة سلفا، نظرا لعدم قبوله الرضوخ لفكرة تحويل الكاتب إلى مؤسسة لا يستطيع بعدها أن يفعل أي شيء، نظرا لدخوله في جلباب الهالة النُّوبليّة، بما تضفيه على الكاتب من محدّدات ليس أبسطها تكريس تمثالية الصورة المنحوتة عنه تماما كما ملكات الجمال الخاضعات لأخلاقيات المهنة وتراتبية التوصيف وتأثير الزمن؟
ومن جهة أخرى، لماذا تتوالد الخطابات الواحد تلو الآخر في رأس كامو فيخرجها من كمّه كلّما تذكّر أمّه؟ القاسمٍ مشترك بينهما هو ستوكهولم نفسها، بوصفها عاصمةً لكل الأعراض التي لا تستطيع أن تتحملها عواصم الغرب غير المحايد بما فيه الكفاية في نظر المثقفين المابعدكولونياليين، الحالمين بغرب على مقاسٍ لا يتجاوز حدودَ حياءِ ما يعتمل في أفكارهم من حلمٍ ضائعٍ لثورات لم تختمر بعد في عقول مخطّطي الأحلام المستقبلية؟ أم لجامعٍ غير مشترك بينهما، لعلّه ما يختبئ خلف صورة ستوكهولم من محاكمات نقديّة متحكمة في رقاب المبدعين، ومن مماحكات القابعين في المقهى الخلفي لسوق الأفكار المروَّج لها بأحدث التقنيات بوصفها تلقيحا نهائيا ضد أي فكرة مضادّة أو «مُفَيْرَسَةَ» مقبلة من جنوب المخيال الجائع في كل شيء والمحتاج إلى كلّ شيء؟
وعلى الرغم من أن أعراض ستوكهولم أصبحت ظاهرة معروفة ومصنفة ومتحكما في دوافعها النفسية والإيديولوجية، فإن ستوكهولم ليست وحدها التي تستأثر بكل الخطابات. فلعواصم أخرى قابعة في خرم الوعي الباطن للكتّاب الآتين من عوالم أخرى أعراض وخطاباتٌ وصكوكٌ كذلك. وقد لا تتحقق وطنية الكاتب في بلده البائس بما لا يريد أن يغدق به على مبدعيه خوفا من أن تُثْمِر أشجارهم برتقالا مرّا، إلا بالفوز بما يعود على أوطانهم بشيء من الافتخار المتأخر، بما أنجبته أمهاتٌ منسياتٌ من مبدعين رفعوا رايته عاليا، وإنْ في غير اتجاه الرياح التي يراد أن تهب عليه. ولعله لهذا السبب كان الفوز بالجوائز محسوبا بدقة متناهية. ولعله لهذا السبب كذلك، أصبحت المتلازمة شرطا أساسيا للترشح بكثير ممّا يجود به فيض الخاطر من حماس إبداعيّ.
-4-
قد لا يعكس التسارع في الاحتفاء بالكتابة من داخل عالم الموضة والإغراء، كما انتبه إليه رولان بارت منذ أكثر من نصف قرن، غيرُ هذه الأعراض البادية على الخضوع المبرمج للمنطق الجوائزي المتحكّم في رقاب المبدعين والقراء، الذي يرضخ بموجب ذلك إلى سلطة المال وبهرج التسويق نظرا لتحكّم رؤيته العابرة للفضاءات الفكرية والإبداعية في مصائر الكتّاب، وتحكمه في آليات الكتابة، وتسطيره لأروقة الإبداع، وتحديده لشراهة ما يجب أن يقرأه المتلقي، ولطرائق هضمه لأفكار العصر، ولسبل تذوقه لجمالياتها.
نوعٌ من التعليب المدعوم بفتوحات التكنولوجيا، الذي يضع المبدع في مستوى آلة الإنتاج، ويفرض عليه تحيين ما تبقى من مروءة إبداعية في مخياله، وفق ما تفرضه برامج اللحظة. وهو التعليب الذي طالما ثار ضده المبدعون في كل مرّة وصلت فيها فكرة التعليب الجوائزي إلى مستوى التعليب الجنائزي، الذي يُزفّ فيه المبدع إلى مقبرة الخالدين بمن تضمّ من كتّاب كبار ملفوفين بجلد الماعز الأغبر ومُذَهّبين بطبعة «الأعمال الكاملة» ذات النسخ المحدودة المرقمة من واحد إلى عشرة، لعلها تكتسب قيمة تاريخية يوم أن تسقط بحكم التقادم في يد تاجرِ تُحَفٍ عارفٍ من أين تؤكل الكتب بعد موتٍ مفاجئ لهاوي نُسَخٍ أصلية ثريّ.
-5-
لكمْ أغدق من لا يكتب على من يكتب. ولكم توّج من يملك كل شيء عدا الموهبة أديبا لا يملك أي شيء عدا الموهبة. ولكم قتلت المبدعَ جائزةٌ مستعجلة خدمت في لحظتها الآنية أغراض آلة التسويق والربح السريع التي يصبح فيها ناشرو الأنساق وديكتاتوريو الجمال وسلاطين الورق وبائعو الخيال في سوق الأدب الكبيرة، منظرين عصاميين يغدقون على الفقراء من بني الأدباء بما شاط من فيوضات زكاة الفكر. فلا غرابة إذن، في أن يجفّف الفوز بالجائزة الأولى منابع الإبداع لدى الأدباء الوافدين إلى مملكة السَّعَةِ، وفي قلوبهم كثير من الضيق بحيث تتحول جدلية النقاش الأدبي والفكري والمعرفي المحكوم بالقضايا الكبرى التي تثري المسارات الإبداعية للكتاب وتوطد العلاقة بينهم وبين القراء، إلى آليةِ حسدٍ يدعو فيها أحدهم على الآخر بعدم الوصول إلى القائمة، أو يتمنى له الغياب المستديم كي يستأثر لوحده بخطابات ستوكهولم بعد أن تكون قد تحكمت فيه أعراضها. وعندما نرى ما يُحدِثُه مجردُ ظهور اسم أديب ضمن ما يسمى بالقائمة الطويلة في انتظار الوصول إلى القائمة القصيرة، وبعدها الفوز بالجائزة من تزمّت إبداعيّ، فإن ذلك يدعو فعلا إلى التساؤل عن مدى جديّة هذا المضمار المنهجي الذي يتسابق داخله المرشحون، وهم يحملون حجرة سيزيف العظيمة في انتظار لحظة إعلان النتائج، وما ينجر عنها من حالات خيبة مرافقة للخروج باكرا من المسابقة، كما يخرج مغنٍّ مبتدئ من تصفيات برنامج ترفيهي. ولعل هذا ما يدلّ على مدى الاصطفاف الذي يجعل الكتاب يرضخون بأمر من المتعاليات الإيديولوجية إلى منطق الخضوع، من خلال اعتبار الجائزة فرصة للخروج من نفق البؤس المادي الذي يعيشونه، مما يزيح عن رؤيتهم للكتابة وهمومها والتزاماتها كثيرا من المصداقية التي تفقد دعائمها عندما يرتبط الكاتب بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموعد الجائزة وبشروطها وبمواعيد تصفياتها وبتواريخ نشر قوائمها وبيوم الإعلان عن الفائز بها. وهذا ما يجعل الكتابة، في النهاية، ومهما كانت عظمتها، كتابة متوّجة، ولكنها تبقى مجرّد كتابة تحت الطلب.
(القدس العربي)