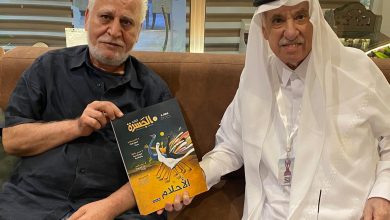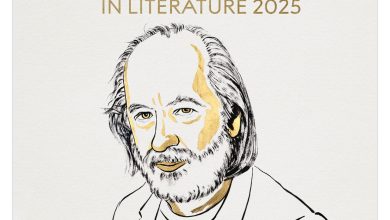رواية «المغاربة» لعبد الكريم جويطي ..تشريح الخراب

محمد الفحايم
تتخذ رواية «المغاربة» للكاتب والمترجم المغربي عبد الكريم جويطي من قضية الخراب موضوعا رئيسيا وبُؤرة دلالية لها. ومن توازي المحكي التخييلي مع الخطاب التاريخي تتبلور البنية السردية الكبرى للرواية. تصنع الأحداث والوظائف في «المغاربة» شخصيتان تربط بينهما علاقة الأخوّة لكلّ شخصية منهما حكايتها وشجونها ورؤيتها للعالم والوجود، شخصية السارد الأعمى وشخصية العسكري المُعاق..
محكي السارد الأعمى
يبدأ السارد الأعمى محكيه العائلي، بوصفه رواية تعلُّمٍ وتكوين، بواقعة الدّم والموت التي لنْ يُدرك القارئ معناها إلاّ بعد عبوره لأراضي الرواية الوعرة وبلوغه تخومها القصوى.. ثمّ يُركز على حدث محوري ستنشأ عنه كلّ مكابداته واحتمالاته الوجودية، عَنيتُ حدث إصابته بداء ضعف البصر الذي سينتهي به إلى الظلام الدامس.. تحصل مفردات الخراب في الرواية بموت الجدّ الذي ترك فراغا كبيرا في حياته وهو طفل، ثمّ يذكر السبب الثاوي وراء موته.. فعندما انتزعت الدولة أرضه بثمن بخس لِتقيم فيها تجزئة سكنية.. ورأى أشجاره وزروعه تُجتثّ وتُخرّب أمامه أعلن عن وفاته.. لم يكن يتخيّل حياته ووجوده بلا أرض يبذرها ويرعاها، ويطال الخراب روح السارد حين خبا النور في عينيه ووَلَج « نادي الظلام». فبعد أنْ سعى أخوه بكافة الوسائل إلى إشفائه من عاهة العمى التي تتهدّده أعطاه كتاب «الأيام» للعميد لأنه صار «على وشك الدخول إلى نادي الشقاء الذي يتزعمه طه حسين». ومنذ هذه اللحظة سيكون للعميد قاهرِ الظلام مكانةٌ جليلةٌ عند السارد الأعمى «محمد الغافقي».. لم يقْو في البداية على قراءة «الأيام»، وكانت قراءته له مُضنية، جعلته يتصوّر كيف سيعيش الأعمى حياته بين الناس، والآلام التي عليه مكابدتها والتحديات التي عليه مجابهتها.. أضحى طه حسين شيخه يلتهم كتبه ويستلهم نموذجه، ويِؤوّل دلالة العمى عنده ورسالة كتابه «الأيام»، وفي حوار شائق مع الباشا في قصره يكشف عن إحاطة كبيرة بفكر العميد وإشكالاته.. في فصل ممتع وحزين عنوانه «صُبح الأعمى» سيروي السارد لحظةً يصحو فيها وقد بلغ من العمر21 عاما.. يفيق في هذا الصباح الرمادي مشتتا وقد عَمّ الظلامُ عينيه كما تنبّأ له الطبيب بازوف بذلك. سيتصالح السارد مع عماه بعد فيض من التأملات الوجودية المأساوية التي يبعثها هذا الوضع.. وهنا يستذكر سببَ إهداء أخيه كتابَ «الأيام» له لِيُهيّئه لِدخول «نادي الظلام»، سيرقى السارد بهذه العاهة إلى مستوى عالٍ من التأمل العميق، فيُجْري تحليلا ذكيا للفرق بين الفكرة عن العمى أو تصوره وبين العمى بما هو واقع وحقيقة». ما أحكيه هو طعم فاكهة مرّة في الحلق، لا الفاكهة نفسها، هو أثرٌ ووقْعُ صدى فقط».. ثم يتذكر تلك الورقة التي تركتها له الفتاة الإسبانية إيزابيل خلال لقائه بها في مخيّم بالجبل.. الورقة مكتوب فيها: « حتى ولو…» والآن سيكتشف السارد تكملتها ودلالته: «حتى لو أُصبتُ بالعمى، فعليّ أنْ أبقى حرّا كطائر يُحلّق». لكن أنّى له ذلك؟ والخراب يزحف نحوه كما يزحف الرّمل، إن رؤية السارد الأعمى مفعمة بالشجن العميق.. يتأمّل حياته التي لم ينَلْ منها سوى الخيبة والضّياع! «إن الحياة لفظتني كما تلفظ المصفاة الحصى التافه، وتُبقي نثار الذهب».
يحتفي دائما، في هذه الرؤية، بالطبيعة وبالربيع وحركة الفراشات وصوت الماء يتدفق من الجبال، يسترسل في وصف هذه المراعي الجميلة وقلبه يهفو إلى وِصال امرأة – حبيبة تأخذ بيده كما أخذت سوزان بيد طه حسين.. إنها رؤية رعويّة للعالم..
وعندما يسمع الفتاة الأمازيغية التي عشقها وهي تُنشد أغنية «تماوايت « يستدعي في خياله الطبيعة الجبلية.. وهنا تكتسي لغة السرد طابعا رعويا بديعا وحزينا يُؤثثها الجبل والسماء وقطعان الماعز ويُضحي المحكيّ شعريا يتأمل السارد حياة الجبل فيرى أنها حياة منذورة للعزلة والنسيان! كما يتأمّل غناء « تماوايت»، «الصوت العالي، الأعزل، المُتذمّم، الطالع من جبل تُرك لحاله منذ قرون، والطّالع أيضا من مسغبات الروح». يستحضر مقطعا من رسالة لطه حسين إلى زوجته: « سوزان: لنتابع المسير، أعطني يدك»، يبحث الأعمى عن يدٍ حانية تُؤنس وحدته الرهيبة وتُطفِئ سعير أشواقه الحَرّى، وتُخمد تباريح عيشه.. وعندما خطب «صفيّة « من أهلها وعاد بها من الجبل وهو يصف جسدها وروحها الجبليّة وذاك الصوت المُمتدّ الحزين الذي كان ينبجس من صدرها الغضّ.. وبعد أنْ صارت له الآن يداً تأخذه في الظلام لتنير دربه، ولحظة جذل في حياته المليئة بالأسى والشجن، اختطفها منه صديقه الأعمى أيضا «حسن أوشن» ستتحطّم روحه بفعل الخيانة، وسيغمره الخراب والاِنهيار .
تُفتَتَح الرواية بمشهد الدم: شخصان في سيارة إسعاف، الأول هو الخصم «حسن أوشن»، والثاني هو السارد الأعمى «محمد الغافقي» في نزْعه الأخير: «وحّدتنا عزلة العمى وبؤسه العميق، وفرّقتنا الأهواءُ وحُبّ النفس..». وتنتهي بمشهد الدّم.. بسقوط جسد «حسن أوشن» من النافذة على جسد السارد الأعمى الذي ظلّ يُرابط أمام منزل خصمه احتجاجا على اختطاف زوجته.. يتضرّجان معا بدماء غزيرة تشي بنهايتهما المأساوية.. إنه زمن دائري يأتي على كل شيء: «ما قيمة نصْر استوى فوق كلّ هذا الخراب؟ ما قيمته؟ والخاسر ليس سوى حيّزٍ من إنسانيتنا..».
محكي العسكري:
إذا كان خطاب الذات وشجونها وتطورها يسِم محكي السارد الأعمى ويطغى فيه، فإن الخطاب التاريخي والاِجتماعي المتعلّق بتاريخ المغرب الوسيط والحديث والمعاصر يهيمن على محكي العسكري، بما هو سارد ثان وشخصية رئيسة ثانية تجسّد صوت النقد والرفض والاِحتجاج في الرواية.. أُصيب العسكري في حرب استرجاع الصحراء ودخل المشفى ليخرج منه يائسا من إنقاذ جسده من الشرخ الهائل الذي أصابه، فشل الأطباء في إنقاذه فاكتفوا بعكّاز يُسْنِد جسده العليل ويحمله..حاول الاِنتحار غير أنّ هاتفا انبعث من داخله فأنقذه..عاد العسكريّ من مهمّة حماية تخوم الوطن بخراب جسده، يقول السارد الأعمى: «مثلما عاد العسكريّ من حرب صحرائنا وجسده مُخرّب، عُدتُ من المستشفى بروح مُخرّبة..». بعد هذا الخراب والعجز الذي حاق به، أدمن العسكري على مطالعة الكُتب فشكّل رؤيةً للعالم يطبعها النقد المتواصل والشكّ العنيف والرفض الجَذري للحقائق والمواضعات في مجتمعه..
يبدأ العسكري بنقد الحرب الدائرة في الصحراء سواء بالنسبة للآخر(العدو) أو النحن (الوطن).. حرب يُديرها قادة يعيشون في رفاه العواصم بعيدا من بؤس مقاتليهم (العدو)، أمّا بالنسبة للمغرب فهي حرب بعيدة عن هموم المجتمع لا يعيشها بوصفها تجربة وواقعا.. فحتّى الجنديّ الذي يؤوب بعاهة وعجز بسببٍ من هذه الحرب التي يخوضها بالنيابة عن المجتمع.. فإنّ لا أحد يأبه له! وأقصى ما يلقاه هو نظرات تعاطف وشفقة بائسة « كأنّه أُصيب في حادثة سيْر بجمعة رياح أو زحيليكة..».
يُعرّي الجندي واقع رفاقه المرير، فهم حطب هذه الحرب ووقودها، هم مَن يرابضون في هذا الفضاء الموحش المُفعم بالذعر والموت.. أمّا جنرالات الحرب وقادتها فهم، كقادة العدو، يعيشون في أماكن آمنة مُرفّهة.. ومنها يُديرون الحرب! يتذكّر رفيقه الراحل البوكمازي الذي زرع حديقة صغيرة في الصحراء لم تقْو على الصمود أمام الرمل الذي زحف عليها.. «وامتصّ ماء الحياة فيها..».
يُشبّه العسكري هذه الحرب بالرجلين المتصارعين في لوحة الغلاف للرسام الإسباني غويا (القتال بالهراوات)، واحد يهمّ بقتل الآخر.. لكن ماذا سيجني بعد انتصاره؟ لا يعيان من هو العدو الحقيقي؟ إنه الرّمل الفارغ.
يشي نقد العسكري للحرب بخطاب إنساني يدين الحرب وقيم الشرّ والصراع التي تدفع البشر إلى أنْ يسحقوا بعضهم.. كما يذُمّها من خلال استعراضه للأعمال الروائية الكبرى التي اتخذها موضوعا رئيسا له.. ويقارن بين الحربين فيخلص إلى نتيجة طريفة وذكيّة: فتلك الحرب التي في الروايات تترك، مع ذلك، أُفقا للحلم والحبّ وإرادة الاِنتصار على الدّمار، أمّا حربُه التي يخوضها، فإنّه يصفها بـ «حرب متثائبة بلا أفكار ولا أحلام..». تسلّط الرواية الضوء، بواسطة خطابها التاريخي، على مرحلة من تاريخ المغرب الحديث تسلّط فيها الباشوات والقواد على القبائل والجهات، فتصوّر قهرهم للبشر وإذلالهم.. وبفضل هذا الخطاب الذي يستقصي مظان التاريخ وحولياته تعمل الرواية، بجرأة نادرة، على تفكيك بنية المخزن القائمة على الفساد والإفساد.. وفي فصل « هذيانات مغربية « يقوم العسكري بتشريح لتاريخ المغرب ولولادته الناقصة دائما «بلدٌ هرب فيه الناس من مُدّعٍ إلى مُدّعٍ آخر أخبث وأدهى..»، بلد تُعوزه روح الوطنيّة فـ «كلّ مَن في البلد يطلب من الوطن مقابلا.. المقاوم والمناضل السياسي والمثقف..». يمتدّ نقد العسكري ليشمل الذهنيّة المغربية الملأى بالعتيق البالي، والوضع اللغوي في البلد، وحالة المدن والبوادي، والمذهب المالكي، وبؤس الصحافة التي تنبش في أغراض الناس وأسرارهم، وتقديس الناس للماضي البائد والأسلاف. « لا يُريد هذا البلد أن ينفض يديه من شيء انتهى، ويدفنه وينصرف لِبناء شيء جديد كلّية..»، « نُوسّع دوما للماضي مكانا أكبر في حياتنا..».
الجماجم والحقيقة الضائعة:
تعرض الرواية، ههنا، واقعة اكتشاف مقبرة تحوي جماجم كثيرة.. ستُعيّن الدولة لجنة صورية لفكّ لُغز هذه الجماجم.. وهنا ستظهر شخصية جديدة لا تقلّ مأساوية وخرابا عن الشخصيتين الرئيستين.. إنها شخصية الخبير التي ستروي للعسكريّ حكايتها الشخصية المُعمّدة باليُتم الفادح.. ففي نوبة صَرْع انتابته هذى فيها بواقعة أبيه الذي اعتُقِل خلال أحداث مولاي بوعزّة 1973، وعُذِّب حتى الموت أمام عيني زوجته المريضة وابنيه الصغيرين.. تنْكأ الرواية عبر هذه الواقعة جُرحا آخر من جراحات المغاربة (سنوات الرصاص الرهيبة) يرتجل الخبير في الجماجم حوارا مع مساعده يرصد فيه واقع الصراع الذي يدفع المخزنُ إليه الأحزاب والأيديولوجيات.. إنه صراع دِيّكة يتفرّج عليها ليبقى دائما هو الأقوى.. وبحيلة سردية أريبة يُسند الخبيرُ إلى هاملت في حواره الذي يخترعه مع هوراشيو مهمّة النطق بحقيقة هذه الجماجم والكشف عن لُغزها: «بإمكاننا أنْ ندّعيَ أنّ هذه الجماجم تعود لرفاقنا الشهداء الذين اختُطِفوا وعُذّبوا وقُتِلوا..».
في رواية المغاربة ينصهر التاريخي والروائي في صورة تخييلية ليُقدّم لنا معرفة عميقة بالماضي والحاضر، حيث تعمل الرواية على تشريح هذا الخراب بالحفر في طبقاته وتعرية ترسباته ومساءلته والإيحاء بأفق جديد يخرج فيه البشر من المتاهة..
سؤال الكتابة في الرواية:
في فصل الكتابة يطرح السارد الأعمى على أخيه العسكري أسئلة سارترية تتعلق بماهية الكتابة وجدواها..يقول له: لماذا لا تكتب كتابا ؟ سيقدّم العسكري في جوابه مفهومه للكتابة وتصوره عنها..يُجيب بأنّ روحه القلق والمتقلّب ينزع إلى الكتابة الشذرية لأنها احتفاء بالمتقطّع والعابر..ويُقرّر رفضه للكتابة النسقيّة، ثمّ يستطرد في تحليل ماهية الكتابة الشذرية ووظائفها « إنها كتابة ما بعد الكارثة حيث ينهار كلّ شيء بداخلك ويتمزّق، ويفقد معناه، وحين تصير أنت نفسك شذرات لِكلّية كُنتَها، ولكتابٍ تناثرت أوراقه في الريح، هي كتابة الصّدوع والدّويّ الهائل للاِنهيار…» ص 144. يسأله أخوه عن موضوع كتابته، فيُجيب بأنه يكتب عن المغاربة، ويرى أن الكتابة فعل التزامٍ ومقاومة..» الكتابة هي فعل المقاومة الوحيد والمتبقي في بلدٍ صمتتْ طيورُه عن الغناء..» ص 145..اختار العسكريّ كتابة شذرية تقوم على التقطيع والتفتيت لأنها تلائم واقعه الجسدي الذي مزّقته الحرب اللعينة، وتطابق واقعه النفسي الذي شتّتتْه أهوال مجتمعه وتناقضاته..
لا يُمكن للعسكري أن يختار مفهوما للكتابة يقوم على النسق المتكامل، ويتأسّس على التسلسل والمنطقيّة.. فمن أين له بالتماسك وحياته مِزَقٌ وشظايا ؟ ومجتمعه يتفسّخ ويتحلّل ؟ فهذه النفس المُحطّمة التي تعيش اللاطمأنينة ستتوخّى شكلا يناسبها.. تُترجم كتابة العسكري الشذريةُ حالاته النفسية الصّاخبة وانفعالاته المشبوبة وتناقضاته المعذّبة التي يلخصها أخوه السارد الأعمى بقوله: « متديّن خاشع، وثائر ساخط على الدين كافر به… فيه صلابة جندي ورِقّة شاعر..» ص 161.
يكتب العسكري أفكاره التأملية التي تُفصح عن وساوسه وأوجاله وغضبه وصخبه في صورة مقاطع وشذرات تتحلّل من صرامة النّسق وضوابط المنطق..إنّ نصوصه المتناثرة تعبير عن هشاشة وخراب ذات ومجتمع، وإيحاء بتقويض عالم تسوده القيم المنحطّة..
إن رواية « المغاربة « هي كتاب للنفوس المحطّمة، وحطامها مُزدوَج: حطام الجسد وحطام الروح الملأى بالنّدوب التي لا تشفى..الروح « العالقة في مأزق الوجود ومتاهاته المؤلمة «.. ولعلّ القارئ لهذا العمل الفذ تنتابه مشاعر الرّعب الشديد من هول ما احتملته هذه الأرواح المُحطّمة التي ساقها تاريخها وقدرها إلى الخراب..وقد يكابد وهو يتابع حكايتها و بوحها الذي تبثّ فيه أشواقها وآلامها وضياعها وغربتها في هذا الفضاء- المتاه..
وهي أيضا رواية جريئة تبعث التاريخ المغربي القديم والحديث بوصفه جثة ارتكبت في حقها جريمة شنعاء تحت جنح الظلام..وقام المجرمون العُتاة بإخفائها ومحو المعالم التي تقود إليها..غير أنّ الرواية تأبى أن يبقى هذا التاريخ- الجثة منذورا للنسيان والإهمال..تبعث الجثة من مكان الجريمة وتنشأ في تشريحها جزءا بجزء حتّى تجلو الحقيقة كاملة، وتقول إن الذاكرة ليست للنّسيان ! هذا الرعب المرتبط بسرود العسكري لا تخفّف من أهواله سوى تلك الاِنزياحات التي يضطلع بها السارد الأعمى عبر رؤيته الرّعوية للعالم..فتنزاح اللغة عن معجم العنف والدم والجريمة والوحشية إلى معجم الرّقة والسكينة والاِنسياب الهادئ حيث تنقل مفاتن الطبيعة الجبلية بالرغم من بؤسها وعزلتها.. لقد استطاعت رواية «المغاربة» أن تقدّم لنا عناصر وتفاصيل تاريخية واجتماعية وأنثربولوجية قادرة على إنتاج وعي متقدّم بمشكلات شعب ووطن،والإيحاء بأفق التحرّر منها..كما أكّد الروائي عبد الكريم جويطي بأن الرواية أداة نقدٍ ووسيلةٌ لإنتاج معرفةٍ وصياغة تخييل..
إنّ رواية المغاربة بتعدّد أصواتها وحواريتها وتنوع مستوياتها اللغوية ومحكياتها ورؤيتها الإيديولوجية الجذرية وتجريبها لطرائق جديدة في الكتابة والسرد والبناء الذي يُفتّت تجانس النص الروائي، وتناصاتها العميقة، وغنى قضاياها وثيماتها، هي رواية كبيرة وعميقة في كل شيء..يقف قارئها على ما بذله المؤلِّف من جهود مضنية في صوغها ما جعل منها عملا يزخر بمعرفة واسعة، وجرأة نقدية هائلة..إنها علامة فارقة في المشهد الروائي المغربي والعربي الراهن..
(القدس العربي)