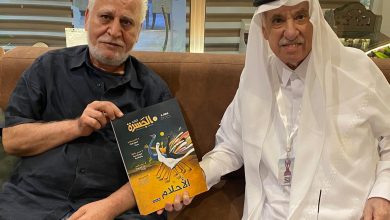لماذا غاب الإيقاع في تحليلات النقّاد؟ : شعراء وباحثون يؤكدون على فاعلية الإيقاع وضرورة تجديد نظريّته

عبد اللطيف الوراري
كان الدرس النقدي يولي المكوّن الإيقاعي أهمية خاصة ضمن تحليله لعناصر القصيدة العربية قديمها وحديثها، ولا يمكن للمتتبع أن ينسى الدور الرائد الذي اضطلعت به ثلّةٌ من الباحثين في هذا المجال، من أمثال: إبراهيم أنيس، وعبد الله الطيب، ومحمد شكري عياد، وكمال أبو ديب، ومحسن أطيمش، وكمال خير بك، ومحمد العلمي، وسيد البحراوي، إلخ. إلا أنه في وقتنا الحالي تراجع هذا الاهتمام، أسباب كثيرة لها علاقة بوضع النقد نفسه، وتحولات القصيدة وثقافة الشاعر المعاصر.
وقد أوعز الشاعر والناقد العراقي علي جعفر العلاق هذا التراجع إلى أسباب كثيرة؛ في مقدمتها: «انزياح الفاعلية الشعرية العربية في معظمها إلى التعبير بقصيدة النثر»، كما أن الكثير من نماذج قصيدة التفعيلة أصبح يتعامل فيها الشاعر مع الوزن «تعاملاً تقليديّاً يقوم على نشوة التطريب، أو الحماسة الصاخبة، بدلاً من أن يفجر فيه طاقته الإيقاعية». إلى جانب ما «يشتمل عليه الدرس العروضي ذاته من صعوبات ناتجة عن أصوله الكلاسيكية وتقسيماته وتسمياته المتشعبة من جهة، وما يتطلبه من تكييف وانتقاء وإقصاء ليتلاءم مع حاجات النص الشعري الجديد من جهة ثانية».
ولاستقصاء حيثيات هذا التراجع، طرحت «القدس العربي» مثل هذه الأسئلة على باحثين متخصّصين: أي قيمة وفاعلية للإيقاع في الشعر؟ هل يمكن أن نتحدث عن مستويات متنوعة للإيقاع بحسب النص وبنائه وشكله ومقصدية منشئه؟ لماذا قلّ الاهتمام بالإيقاع ودراسته ضمن بحوث النقد الشعري خاصة؟ ثم في أي اتجاه يمكن تطوير نظرية الإيقاع في الشعر العربي، ولاسيما في سياق ثورة التكنولوجيا وفورة الخطابات الأدبية؟
قيمة الإيقاع ومستوياته
تتجلّى قيمة الإيقاع العربي بحسب الباحث والشاعر اليمني عبد الغني المقرمي، «في ملمحين اثنين: ملمح تراثي يتمثّل في أن هذا الإيقاع كان ولا يزال الوعاء الأمين الذي حفظ لنا روائع الشعر منذ أن بدأ الشاعر العربي رحلة البوح الشعري (…) أما الملمح الثاني فهو إبداعي صرف، ويتمثّل في أن الإيقاع لا يزال، حتى اليوم، قادرا على العطاء، وأنه أمام السيل الجارف من الأشكال الشعرية المستجدة لا يزال يمثل مرجعية إبداعية مهمة».
في هذا السياق، يدعو أكثر من باحث إلى توسيع مفهوم إدراكنا للإيقاع لتحقيق مستويات متنوعة تساير الطبيعة المتجددة للنصّ، خاصة أن الإبداع بطبيعة الحال يستدعي آفاقاً أوسع من الحرية. ويؤكد المقرمي على «مسألة التوسيع الواعي الذي ينطلق من روح الإيقاع وطبيعته، ويقدم آفاقاً إضافية له، وليس أشكالاً مغايرة لا تمت للإيقاع بصلة». وتابع: «ينبغي في هذا المسألة تحديداً أن نقف بمسؤولية واعية بدون التحيّز لقداسة الموروث الإيقاعي، وبدون التفريط به أيضاً، وفي اعتقادي أن الأصلح للقيام بهذه المهمة الدقيقة هم الشعراء لا النقاد، لأنَّ الشاعر حين يعيش هاجس التجديد في المضمون أو في الشكل لا يتنازل قيد أنملة عن شعرية النص، فيأتي تجديده مسايرا للشعرية، منتميا إليها».
ويرى الشاعر والباحث السوري نديم الوزة أن العرب ميزوا بين «الإيقاع» و»النظم» منذ البداية، إلا أن ثمة من يرى أن الإيقاع ليس شيئاً آخر سوى نظم التفعيلات في البيت الواحد. وفي هذا الإطار، يمكن أن يأتي هذا الإيقاع من ثلاثة مستويات نوعية: نظام المقاطع (الإيقاع الكمِّي)، والنَّبْر (الإيقاع الكيفي)، ثم التنغيم الذي يعتمد على أصوات الجُمَل من صعود وانحدار وما شابه. ويفترض أن النوع الأول يتعلق بما يسمى «الإيقاع الخارجي» للقصيدة، وإن كان هذا لا يمنع أو لا يلغي حضورَ النوعين الآخرين كمستوى متضمَّن في تكوينه. غير أن المدى الزمني الذي يلتزم به نظام المقاطع هو من بنية الموسيقى الخارجية للشعر، ولا علاقة له بالإيقاع الداخلي الذي يقوم على الدلالة، ولا يدل على علاقات صوتية أو بلاغية أكثر منها على علاقات دلالية وأخرى مرئية، مثل: العقدة والحل، أو التقابلات والتضادَّات وما ينتج عنها من توازيات أو حلول جدلية، والرموز والعلامات الرياضية والهندسية، إلخ. فالإيقاع الداخلي، في نظره، هو بنية جوهرية للنص – أيِّ نص – وليس خاصاً بقصيدة النثر وحدها. وقد يكون لطبيعة الجنس الأدبي دورٌ رئيسي في تحديد ملامح إيقاعه الداخلي، وربما قد لا يكون الإيقاع الداخلي نفسه شيئاً آخر سوى هذه الطبيعة ذاتها.
ويذهب الشاعر والباحث العراقي علاوي كاظم كشيش إلى غير هذا الرأي، فقال: «لم ينفع تقسيمه إلى إيقاع خارجي محدود متداول متشابه، وإلى إيقاع داخلي مطلق وشخصي ومتغير بحسب ما أطلق عليه الناقد حاتم الصكر. وهذان التقسيمان وصلا في الدراسات الإيقاعية إلى طريق مغلق، في ما يخص الإيقاع الخارجي. وإلى طريق اجتهد الدارسون في وصفه وتفريعه في ما يخص الإيقاع الداخلي، ووصل الأمر إلى حد كتابة آراء إنشائية عليه وعلى القصيدة، مع رفده بتسميات لا علاقة لها بالقصيدة مثل إيقاع البياض والتسطير، مع أن هذه المؤثرات بصرية تذوب كلها في قراءة النص بصوت أو قراءة صامتة». فبالنظر إلى اختلاف طبيعة الكلام الشعري، يستخلص علاوي أن مصطلح (الإيقاع) القياسي المنضبط لا يصف حركة الكلام وتعرجه وتموجه التي تكسبه لذة المخالفة وتجعل لكل شاعر خصيصته الكلامية وتفرد له طعماً خاصّاً. وبدل مفهوم الإيقاع يقترح مفاهيم مثل: العبارة، والكلام الشعري، وجريان الكلام: لكل شيء جريانه. ولكنه ليس منتظما بالضرورة. والقصيدة العربية تكمن براعتها في جريان كلامها الشعري الذي تتسيده العبارة التي تتلوى ولا تجري بوتيرة واحدة. وإن العبارة هي التي تضم الوزن وليس الوزن هو الذي يهيمن عليها، إلا أن يكون النظم أقوى من الكلام. وانتهى إلى القول بأنّه: «لم يعد أمامنا إلا أن نغامر بشجاعة لنلغي هذا المصطلح الموهم (إيقاع)، ونختار مصطلح أكثر سعة وأداء منه وهو مصطلح يضم جميع العناصر المنفصلة ويحفظ للكلام الشعري براعته. وهذا المصطلح هو (الجريان)».
هل لهيمنة قصيدة النثر تأثير ما؟
يعتقد عبد الغني المقرمي «أنها مسألة نسبية، فما تزال كل أشكال الشعر متجاورة، بدون طغيان أيٍّ منها. ولا أعتقد أن قصيدة النثر لها علاقة بقلة التعاطي النقدي مع الإيقاع، فالمكتبة الإيقاعية من زمن ما قبل قصيدة النثر، بل منذ قرون طويلة تعاني عوزاً شديداً مقارنة مع الدراسات اللغوية الأخرى، كالنحو والبلاغة على سبيل المثال، وهذا يعود إلى أنَّ الإيقاع علم نخبوي ينحصر على الشعراء ومن ينتمون إلى عالم الشعر الجميل من النقاد، بينما العلوم الأخرى يمكن القول إنها أكثر شعبية وأوسع مدى، وهي النظرة التي تؤكد عليها مناهج التعليم سواء العام أو الجامعي».
إلا أن الشاعر والباحث المغربي عبد اللطيف معزوز يرجع الأمر إلى ما هو أعم، بحيث يتعلق الأمر بنسبة القراء المفترضة للشعر الذي لم يعد – في أحسن الأحوال- ديوان العرب الوحيد، كما النسبة التي يمثلها الباحثون وندرة المُسائِل منهم ظاهرة الإيقاع؛ هذا فضلا عن تصورات تجعل من ربط القصيدة العمودية أو قصيدة التفعيلة بالإيقاع مباشرة. يكتسي التهميش هنا لبوس الشرعية، لكون الإيقاع، بهذا التصور الملازم لعلم العروض، أحد الأغلال الملجمة لاتساع الرؤية والمفارقة للاستشراف الذي بشرت به قصيدة النثر حين دعت إلى تفجير اللغة وفتح أقاليم مفهومية جديدة بدل تقديم الأفكار. والحال أن الإيقاع المحارَب هنا – في نظره- هو استراتيجية صوتية شكلت كينونة الشعر العربي لأكثر من خمسة عشر قرناً، ولم يُترَك المجال للمعانقة الصرف بين اللغة والشعر، إلا بعد الانقلاب السوسيولوجي لما بعد الكولونيالية، سياق جعل من إجراء الكتابة/القراءة سبيلاً لتأسيس نمط وجودي بديل لفعل الإنشاد/الإنصات، ما يفسر فقدان الطقس الشعري الكثير من كرنفاليته وعلى رأسها الوزن والقافية. وربما تُفسَّر العودة القوية لمغازلة القصيدة العمودية والتفعيلية (والتي اعتبرها بعضهم ردة) بانقلاب سوسيولوجي آخر بوأ وسائل الاتصال السمعية البصرية صدارة المشهد التواصلي، ليستعيد الصوت ولواحقه التطريزية مجده الأثير.
نحو أيّ نظرية؟
بخصوص «نقد الإيقاع» من حيث طبيعة المنجز وآفاق المساءلة، لا يخفى اليوم قلة الدراسات الإيقاعية الناقدة مقابل السيل الطامي من الكتب الإيقاعية المكررة التي يستنسخ بعضها بعضاً من زمن الخليل وحتى زمن الناس هذا. وضمن هذه القلة، توجد – في نظر المقرمي- إسهامات متواضعة من حيث الكم، لكنّها تؤسس لأفق إيقاعي أجد، أتوقّع أن يعطي نتائج جيدة على المدى القريب. وعلى حد قول علّاوي، فإنه رغم الجهود المبذولة في النقد العربي من قبل ناقدين أجلاء ودارسين جادين، لا تزال قضية الإيقاع لم تحسم ولم تخضع لمتطلبات الدرس النقدي وأحكامه الجامعة، فقد ظل الإيقاع – في نظره- عصيّاً على التعريف وعلى وضع الحدود المانعة لكنهه.
ويقرّ عبد اللطيف معزوز بضآلة المنجز، إلا أنه ينبغي ألا نجحد الجهد العربي المبذول نقداً في إيقاع الشعر خلال القرن الماضي، ولكننا نسجل إفلاته للحظته التاريخية حين اكتفى بالحومان حول نظرية الخليل وإن جاهر بمسافته عنها، بدل استحضار أسئلة الاستكناه التي شغلت مرحلته. وقال: «صحيح أننا نوافق الباحث إبراهيم أنيس في كتابه «موسيقى الشعر»، على ما أبداه من عدم رضا عن حجم المادة الاصطلاحية للعروض، ولكن إعلانه أن الخليل اتبع في عروضه نهجا خاصا غير مؤسس علميا من الناحية الصوتية، أمر نخالفه فيه، ولنا في «نظرية الوقع» التي قدمتها الفونولوجيا التوليدية سنوات الثمانين ما يؤكد ذلك؛ كما ننظر بعين الإجلال للوعي النقدي لدى نازك الملائكة، المسفر عن تأسيس نواة نظرية تحدو شعر التفعيلة الوليد وترسم آفاقه، في تجربة رسمت الخطوط العامة للتجربة، لكنها لم تعلل أحكاما عديدة حفل بها كتابها «قضايا الشعر المعاصر»، من قبيل ذمها الإكثار من خبن الرجز، ما يعني أن قصيدة شهيرة كـ»أنشودة المطر» لن تستوفي شروط الجودة بمعايير الناقدة؛ ونكبر توجُّهاً آخر، مثلّه مشروع كمال أبوديب، باقتراح بديل جذري لعروض الخليل، ضمنه كتابه «في البنية الإيقاعية للشعر العربي»، إلا أن أفكاره الكبيرة لم تسايرها وسائل البحث التي اعتمدها، فلم تخلص المقدمات إلى النتائج الموعودة، وإن تخللت الكتاب إضاءات مهمة تناثرت بين دفتيه».
ووجد أن نقاد (الإيقاع) العرب يمكن تصنيفهم إلى منددين بثقل جهازه الاصطلاحي، وساعين إلى التخلي عن بعض معايير الشعر العمودية والتمسك بأخرى، ورافضين له بتقديم مبادئ بديلة (خصوصا الأساس النبري). وهي – في نظره- جهود متفرقة، لم تستفد من تجارب قريبة، ولم تتجاوز أخرى بعيدة، مثلها الدرس العروضي القديم الذي انقسم أصحابه إلى قسمين، متبنٍّ له وداع إلى الالتزام الأعمى بمادته، بدون إضافة أو نقصان، ويتزعم هذا التيار ابن جني؛ ومتصرف في مادته، مستغن عن بحور وتفاعيل يراها متفرعة عن غيرها، ويمثلهم الجوهري؛ وظل البحث على ما يمنحه الإيقاع من آفاق رحبة، يعيد بوعي أو بدونه، وصاية مارسها العروضيون على منجز الخليل للالتزام بالمعايير بدل تحليلها.
وفي ضوء مثل هذه المعطيات، يؤكد عبد الغني المقرمي، بقوله: «نحن بحاجة – في تطوير النظرية الإيقاعية- إلى أن ننطلق من موروثنا الإيقاعي الجميل، مع الاستفادة مما يوسّع من أفقه من كل معطيات العلم الحديث، مع مراعاة العودة بعلم الإيقاع إلى أسلوبه السهل البسيط الخالي من التعقيد. وفي هذا الصدد أنا مع الدعوات المتعالية في تجديد المصطلح العروضي، وقد كتبت مقالات عديدة في ذلك، وتساءلت مراراً: (لماذا لا يغادر العروض العربي خيمة الخليل بن أحمد الفراهيدي؟)؛ بمعنى أنه لماذا أستخدم مصطلحات غريبة على عالم اليوم كالقبض والصلم والخزل والتشعيث والوقص.. وغيرها من تلك المصطلحات الموغلة في البداوة؟ وهل بالإمكان أن نستبدل هذه المصطلحات بأخرى حديثة تنتمي إلى عالم الإيقاع والموسيقى، لا إلى خيمة الخليل المؤسس؟». وتابع: «كما أن ثمة تكرارا مثقلا في مجالات عروضية كثيرة، خاصة في مبحث الزحافات والعلل.. هذه قضايا ينبغي أن نقف أمامها بمسؤولية، وأن نُعمل فيها (معول البناء)، بتنقيتها من كل ما يحول دون فهمها واستيعابها. الفراهيدي وضع لبنة في هذا العلم بلغة عصره، وكان يقيّد المفاهيم بما يتراءى أمامه من أسماء الأشياء، وهو ليس بابا مغلقا البتة، ولكنه قابل للإضافة والإضافة المسؤولة الواعية على وجه التحديد، وعلينا أن نوجد صيغة احتمالية على الأقل تتسع للأشكال الجديدة، واعتبارها منتمية شكلاً ومضموناً للإيقاع بدلاً عن التقوقع داخل القديم المكرر أو الانزلاق بعيداً عن الانتماء المبدع».
وفي وقتنا الراهن، تتوزع الباحث العربي ـ في نظر معزوز- ثلاث مدارس كبرى: الماتحة من التقليد الأنكلوساكسوني أو الفرانكفوني أو التراثي. وقد تدرج في قسمين كبيرين يتقابل فيهما المشارقة بالمغاربة، أو أقسام عدة، تشكل فيها كل دولة وطنية تجربتها المتفردة، إن لم نعتبر كل باحث نسيج وحده. وكيفما كان التقسيم فأغلب الكتابات تدل على أننا إزاء عوالم متوازية، لم تتطلع إلا على تجاربها، ما جعلها تغيب ضمير الجمع بكل امتلاءاته ووشائجه، وتجعل من مهمة الباحث في تقديم مادة تصوغ أسئلة عصره وترسم الخطى لمن بعده، شبه مستحيلة.
من هنا، فإن الخوض في مسألة الإيقاع راهناً، ليس باليسر الذي يتوهمه المتحمس للكتابة، بل يتطلب الأمر قبل كل شيء، التخلص من هذا الحماس بنوع من التعالي الفينومينولوجي، والإنصات بعمق إلى الأصوات الشفيفة التي تشكل البنى المرجعية بما فيها التمثل الرصين للخلفية الفلسفية المؤطرة لمفهوم الإيقاع كونيّاً.
(القدس العربي)