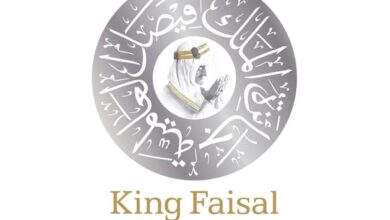«ظِلُّ اللَّيْل» للفلسطيني زهير أبو شايب: شِعْريةُ التَّخَلُّق بين الوُجود بالإسْم والوُجود بالجِسْم

الجسرة الثقافية الالكترونية
*صلاح بوسريف
المصدر / القدس العربي
«وقال لي: أنتَ مَعْنَى الكَوْن كُلّه». بهذه القولة للنِّفرِيِّ، يفتتح زهير أبو شايب ديوانه «ظِلّ اللَّيْل»، بل إنَّ هذه القولة، جاءت سابقةً على اسمِ الشَّاعر، وعلى عنوان الكتاب. في غلافِه الخارجي. لا يمكن الانتباه إلى قولة النِّفَرِيّ بيُسْرٍ، أو بسهولَة. فهي مكتوبةٌ بلون رماديِّ يميل إلى السَّواد، على غلافٍ خلفيتُه سوداء، في ما اسم الشَّاعر، وعنوان الديوان كُتِبا بالأبيض. لَوْن خطوط القولة نفسها المكتوبة بحروف دقيقةٍ، أخَذَتْه صورة الغلاف، أو رَسْمُه، وهي عبارة عن لَطْخَةٍ، تُوحِي بجسم بشريٍّ مائلٍ إلى الخلف. الغلاف من تصميم الشَّاعر، بكل جزئياته وتفاصيله. السؤال، أو الأسئلة التي فرضت نفسَها، هنا، هي: ما العلاقة بين قولة النِّفَرِيّ، وعنوان الديوان؟ ثمَّ لِماذا هذه القولة، في غلاف الديوان، بهذا الخَفاء المُتَجَلِّي؟ أو بهذه المُواراة؟ وبالتالي، ما علاقة كل هذا بنصوص الديوان، التي هي نصوص تتراوح من حيث تواريخُها بين السنوات 1997 ـ 2006.
قد تُوهِمُنا التواريخ، بنصوص لا جامِعَ بينها، أو هي تفاريق، وكتابات محكومة بسياقات وظُروف مختلفة. فبين 1997 و 2006. عشر سنواتٍ، إذا انتبهنا إلى غياب سنة من هذا الامتداد الزمني الكرونولوجي، وهي سنة 2005. لكن قراءة النصوص، في عناوينها الجامعة، وهي خمسة عناوين، «ليلٌ يَسَع الأرض»، «بكم حلماً يقطع اللَّيل؟»، «رجل ميت مثل كل الرجال»، «كلهم في الظلام سواسية»، «دفتر الأحوال والمقامات»، أو في عناوينها الفرعية، ستبدو لنا العلائق التي تجمع بين هذه النصوص، مَتينةً، أو ذات خَيْطٍ ناظِم يجمع بينها، خصوصاً بالعودة لحقلها المعجمي، الذي يظلُّ هو الحقل نفسه، بكل مُشْتَقاتِه ودلالاته التي تَصُبُّ في مجرى المعنى نفسه، أو طبيعة الرؤية في الديوان.
تبدأ المفارقات اللغوية في الديوان، من العنوان نفسه، فالظل هو انعكاس الشَّيْء بما يُوازِيه، أو يفيض عنه، وعادةً ما يكون الظل مرتبطاً بالضَّوْء، أو بالشمس، وليس بالليل. فالليل لا ظِلَّ له، فهو ظُلمَة، سوادٌ، وهو، بالتالي، لا انعكاس له، ولا شيء يمكن أن يفيض عنه، أو يخرج منه، إلاَّ السَّواد والحُلْكَة أو السَّديم بالأحرى، خصوصاً حين يكون الليل قاتماً، لا ضَوْءَ يُفْرِجُ عن شقوقه. لكن، يمكن بالعودة لتعريف ليوناردو دافنتشي، للِظِّلّ، أن نجد بعض ما يمكنه أن يفتح لنا كُوَّةَ ضوء في هذه العَتْمَة. فالظِّل عنده، هو سواد أبيض، وهذا يعني، أنَّ الليلَ، بهذا المعنى الذي يذهبُ إليه زهير ابوشايب، هو لَيْل كاشِفٌ، أو مكشوفٌ، عارٍ، ليس عَتْمَة كامِلَةً. ثمَّة ما يجعل الرؤية تكون واضحة، رغم ما قد يكون فيها من غَبَشٍ. فبأيّ معنًى، يكون لِلَّيلِ ظِلّ، أو بأي معنًى يجمع الشَّاعِر بين الظِّلّ الذي هو ظلامٌ، أو سواد أبيض، وبين الليل الذي هو ظلام مُظْلِم، أو أسود؟
في الديوان تكرار لافِتٌ لتيمة الظُّلْمَة، أو الليل، ولِما يَسْتَتْبِعُها من مُشتقَّات، أو معانِيَ ودلالاتٍ. فالاستشهادات التي يفتتح بها زهير ديوانَه، كُلُّها تَصُبُّ في المعنى نفسه، وهي تتراوح بين قديم الشِّعر العربي عند كُلّ من الشنفرى وعمرو بن الأهتم، والفن والفكر في الثقافة غير العربية، عند كُلٍّ من جان دولاكروا، ولاوزي ـ تاوتوكنج. ما يعني أنَّ الليل الذي يذهبُ إليه الشَّاعر، هو الليل في بُعْدِه، أو معناه الكوني، أو تلك «العتمة التي هي المدخل إلى كل معجزة» أو باعتباره تعويضاً عن «فقدان»، ما «نشتهيه من أشياء»، أو ما يظل هارباً، مُنْفَلِتاً، يَسْتَعْصي ويتأبَّى عن الحضور، أو الظهور والتَّجَلِّي. أي ما لا نقبض عليه، وليس ذلك الليل «الكافِر»، كما جاء في بعض الأحاديث، وفق ما يُثْبِتُه ابن سيرين في تفسيره للأحلام.
ليس غريباً أن يختار الشَّاعر، أيضاً، إهداء ديوانه هذا إلى الشَّاعر الراحل محمود درويش «في حضرة غيابه». بما يعنيه الغياب، من مُعادِل لهذا الانفراط، أو الفُقْدان الذي به أشْرَع ابو شايب كتابه هذا، بما جَلَّلَه به من سوادٍ؟ ثم ما الذي يمكن أن تُتِيحَه لنا نصوص الديوان من دلالاتٍ تكفي لتبرير العنوان، باعتباره عتبة الكتاب، أو أحد نصوصه المُوازِيَة؟
«وَحدي، في مكانٍ ما من الماضي، أُفَتِّشُ عن أبٍ لأنامْ»، «الآنَ، لا أنا ذكرياتُ أبي، ولا أنا ظِلُّهُ»، «سِيَّانِ إنْ كنتُ من الظلِّ، وإن كنتُ من الطِّين الفصيح. عندي من العَتمةِ ما يكفي لأنْ أهرُبَ من نفسي إلى أبْعَدِ ريحِ»، «ولَدَيَّ ما يَكفي من الماضي لأدفِنَ فيهِ رأسي عندَ كلِّ إشارةٍ، وأجُرَّ ظِلِّي مِثلَ نَسرٍ ميّتٍ، أنَّى ذَهَبْتُ. لَدَيَّ من الماضي، لأنسَى أن أكون»، «كأبٍ يَعودُ من الظهيرةِ ناقصاً، وأكادُ ألمسُه، وأغرق فيه من شوقي إليهِ، أكاد أُحْصِي موجَهُ الذهبيَّ، في جسَدي، وأصرُخُ: يا أبي ي ي ي ي ي» .
من هذا الصَّدَى يخرجُ الغياب. فُقْدان الأبِ، كان فجيعةً. ليس من الضروري أن تتجسَّد هذه الفجيعة في حُرَقِ اللَّظَى الذي تَسْتَشْعِرُه الذَّات، فاللُّغَة، وما تحتملُه من إيحاءاتٍ، تكفي لِفَضْح حجم الفجيعة في نَفْسٍ لم تتوقَّف عن البحث، أو الرغبة في اللِّقاء. فالماضي يأخذ الشَّاعر إليه، يمنع عنه النَّوْم، ويَحُضُّه على استرجاع رِمال الماضي التي فيها يدفن رأسَه، هارباً من «حقيقة»، لا تستسغيها هذه النفس الكَلِيلَة، لكنها لا ترغبُ في النَّظر إليها باعتبارها «حقيقة» لا يمكن الهروب منها. أليس الصُّراخ، تعبيراً عن يأْسٍ مُضْمَرٍ، وعن رغبة في اقتسام الألم مع هذه «الرِّيح التي تُشْبِه يأسي» ثم أليس اليأس فراغاً، ورغبة في مواجهة النفس لنفسها، ليس ثمَّة ما يخرج بالنفس من يأسها، سوى هذا الفراغَ الذي يدفع النفس لِتبقى قرب نفسها، بتعبير الشَّاعِر نفسه، أي بوجودها في العَراء؟
في الديوان، لا نصَّ يخلو من هذا المعنى. نَفْسٌ جريحَةٌ، تعيشُ قلقَ الفُقْدان والغياب. لا تتوانى عن البحث، رغم العتمة، ورغم كُلّ هذا الظَّلام الذي يملأ الفَمَ والكلامَ. ولعلَّ مشكلة الاسم تزداد غموضاً وسواداً، خصوصاً حين ينشأ هذا الاسم، أو يكبر في الغياب. وهُنا تكبر الفجيعة، وتصبح لصيقةً بمشكلة الهوية والانتماء. والمُفارقة، في هذا الديوان، أنَّ الشَّاعِرَ لا يرغب في قَتْل الأب، بل أنه يحرص على حياته، وحضوره، كما يحرص على وُجوده، فاكْتِمال الاسم، لن يَحْدُثَ إلاَّ بلقاء الأب، هذا الأب الذي هو حضور في الغياب، وهو أرَقُ نفْسٍ، لا تفتأُ تقلب التُّرَبَ بحثاً عن هذا الأب، النَّائي، البعيد، المُتلاشي في غيابه، فهو لم يَعُد في مُتَناول اليَد. إنه «هُناك»، في مكانٍ مَّا، لا يبدو أنَّ «الطِّفْلَ» يعرف شيئاً عنه، لأنَّ الطفلَ «هنا، في الطِّفْلِ وهو يُطِلّ مُرْتَبكاً على أحلامه، ويرى غياب أبيه فيه». الطِّفْل، بهذا المعنى، شَرِبَ غيابَ الأب، أو صار مرآةً لهذا الغياب، أي وفْق إهداء الشَّاعِر يعيش حضورَه «في حضرة غيابِه». وقد يكون هذا أحد تأويلاتِ استعمال أبوشايب لقولة النِّفَّرِيّ «أنت معنى الكون كله» في غلاف الديوان، أي بوجودِها خارج النصَّ، ومُجاوَرَتِها لاسم الشَّاعر، رغم صعوبة تَبَدِّي هذه القولة، أو ظهورها بما يكفي من الظهور، قياساً باسم الشَّاعر، الذي هو الأكثر بروزاً في الغلاف.
يمكن، بنوع من التأويل السيميائي، اعتبار الاسم، بهذه الصورة التي يبدو عليها في الغلاف، وهو من تصميم الشَّاعِر نفسه، تعويضاً عن غياب الأب، أو احتلال «الطفل» مكانة الأب، وتَشَرُّبه للاسمِ المُشْتَرَك، الذي من خلاله يصبح الطفل هو «معنى الكون كله»، أي أنَّه صار «يرى غيابَ أبيه فيه»، كما صار يرى فيه حُضورَه، وتَجَلِّيه، فالأب مَاثِلٌ في الاسم، موجود فيه باعتبار حضوره، أو أنَّ الطفل، من خلال الاسم نفسِه، أدْرَك أنه أصبح هو الوجود ذاتَه، وهو وُجود بالاسم، لا بالجِسْم.
المشكلة التي يطرحها علينا هذا الدِّيوان، والتي نحتاج لتأمُّلِها، في سياق هذه القراءة، هي كثافة الحقل المعجمي الذي له علاقة بالليل، وبالظِّل، في سياق العلاقة بهذا الفَقْد، أو الغياب، أو الحضور في الغياب. فثمَّة أسئلة مُؤجَّلَة لا تزال في حاجةٍ، ليس لأجوبة، بل لمقارباتٍ، تُتيح مُلامَسَةَ ما قد يُخْفِيه دَالاَّ الليل والظِّل في الدِّيوان.
ليس من السَّهْل وضع اليَدِ على كل ما تحتمله هذه الكثافة من أبْعادَ دلالية، وما يمكن أن يأخذه الليل من إيحاءاتٍ في الكتاب، علماً بأنَّ الليل، هو بين أهم الموضوعات التي خاض فيها الشِّعر، قديمه وحديثه، وهذا يعود بي شخصياً لديواني الأول الذي صدر في بداية التسعينيات من القرن الماض «فاكهة الليل»، الذي خاض في الموضوع نفسه، لكن من زواية مُغايِرَة تماماً، لِما خاض فيه الصديق زهير أبوشايب، كما خاض فيها الفَن، وخصوصاً في الثقافة الغربية، التي كرَّسَتْ دراسات، بالفرنسية، خاصَّةً حول السَّواد، وحول علاقته بالليل، وبالحالات النفسية التي يكون عليها هذا المعنى، في النص، كما في اللوحة، أو على القُماش. وكما أشرْتُ سابقاً، ففي كتاب «تفسير الأحلام لابن سيرين» ما يُشير لتفسيرات الليل، التي كنتُ ثَبَّتْتُ بعضها في ديوان «شرفة يتيمة»، وهو تفسير لا يخرج عن المعنى الديني، أو الغيبي لِلَّيْل والظُّلْمَةِ، أو النظر لِلَّيْل باعتباره كافراً، وهو ما لا يعني تجربة زهير هُنا، أبداً.
لغة زهير، في هذا الديوان، هي لغة، بقدر ما تُحافِظ على شعريتها، وعلى ما يُمَيِّزُها عن النثرية التي باتتْ تطبع الكثير من الكتابات «الشِّعرية»، بدعوى التَّخَفُّف من ثقل البلاغة القديمة، فهي تقف في مُفْتَرَق التَّعْبِيريْن، الشِّعريّ والنثري، أو ما يمكن اعتبارُه استعمالاً لِلُّغَةِ في السياق الشِّعري، حيث يميل الشِّعر إلى تَمَثُّل النثر، واستيعابه، أو امْتِصاصِه في سياقه التركيبي، الجمالي، الذي يسمح للصورة الشِّعرية أن تكون نواةَ «الفكرة»، أو هي إحدى الدَّوال البانية لشعرية النص. وقد يجد القارئ نفسَه، في كثير من الحالات، أمام صُوَر، أو تراكيب، فيها مُفارَقات، هي كَسْر لطبيعة التَّجاوُبات التي عادةً ما تَحْدُث، باستدعاء اللفظة، أو الكلمة، لِما يستجيب لسياقها اللغوي، أو استدعاء الكلمة، لِما يُكَمِّل معناها، ويُضيئُه، وهذا، فيه اختراق لِلُّغَة نفسها، أو لوضوح الفكرة، في علاقة الدَّالِّ بمدلولاته. وهذا رُبَّما، ما دفع علي جعفر العلاق، في كلمته على ظهر الديوان، لِيُسَمِّي لغة زهير باللغة الجسدية، أي تلك اللغة التي تشي بالصورة، لكن تلك الصورة التي تنبثق، وتخرج من النص ذاته، لا من قياسها بمُعادِلاتٍ تحدث خارِجَها، فهي تُولَدَ إبَّانَ النص، وفيه، أي أنَّها تتخلَّق في شِغافه.