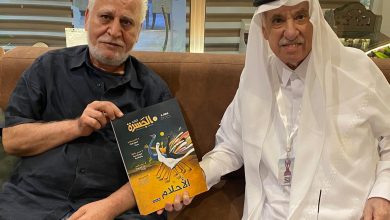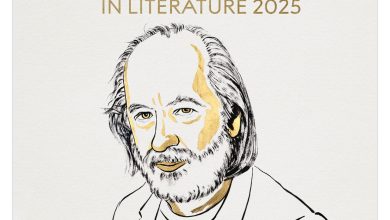«بولاق أبو العلا» رواية مولعة بالمكان

الجسرة الثقافية الالكترونة
*يسري عبد الله
المصدر: الحياة
يهدي الروائي فتحي سليمان روايته الجديدة «بولاق أبو العلا» (بيت الياسمين، القاهرة) إلى روح المثقف اليساري المصري فتحي عبد الفتاح الموصولة بخيط من النضال الوطني في لحظات فارقة من عمر الأمة المصرية. من فتحي عبد الفتاح، صاحب «شيوعيون وناصريون»، يبدأ سليمان، مروراً بتصدير الرواية بمقطع دال للكاتب اليوناني كازنتزاكيس، متخذاً من أحد أعرق أحياء القاهرة الشعبية، بولاق أبو العلا، عنواناً لروايته، في تماس لا تخطئه عين مع الوجدان الشعبي والروح المصرية في أشدّ تجلياتها خلقاً وابتكاراً، لا سيما أنه التقط من قبل مكاناً في ضاحية مصر الجديدة الراقية وجعله فضاءً لنصه الأول «على محطة فاتن حمامة».
يتخذ سليمان إذن من بولاق أبو العلا فضاءً جديداً لعالمه الروائي المسكون بروائح العاديين، وأنفاس الغلابة، ووهج حكايات النسوة المتغنجات، وونس أبناء البلد الأصليين في معيشهم اليومي الباحث عن سترٍ سابغ، ورزقٍ كافٍ. غير أن هذا ليس كل شيء في الرواية وهو كل شيء في آنٍ، هو مفتاح النص وجوهره معاً. وليست بولاق المكان/ البشر سوى مخزونٍ من الحكايات التي تصبح بمثابة مادة خام يلتقطها الكاتب هنا ويحيلها إلى شخوص من لحم ودم، موصولين بحبل سرّي مع روح وثّابة وشعبية ومتجددة،
تضم نوبيين، وجنوبيين من أسوان، وفلاحين من الدلتا، وأبناءً لمدن صغيرة يشكلون جملة البشر المتفاعلين داخل مكان/ فضاء جغرافي مختلف، فيه من سماحة النهر وعنفوانه، ومسكون بحكايات المبنى الرسمي الرابض على أطرافه «مبنى التلفزيون»، والذي تبدلت علاقة ناس المكان به اكثر من مرة، بمجرد عمل منير الريجيسير داخله، ليتقدم الفتية والفتيات عاملين كمجاميع داخل مسلسل تلفزيوني لم يفطن السارد الرئيس إلى مكانته سوى في ما بعد. فتتسرب علاقات الريبة وتتوارى إلى غير رجعة، غير أن المبنى الكلاسيكي ابن الصيغ الرسمية لم ينجُ من فخ الطبقية، فمازالت برامج الصباح داخله تأتي بأطفالٍ آخرين من خارج الحيّ ليشكلوا المادة الحية لبرامج تفوح من صبيانها وبناتها عطورٌ باريسية.
يسعى فتحي سليمان إلى توثيق المكان، لذلك لم يستطع أن يغالب شوقه في أن يقدمه بتنويعاته المختلفة، وعبر صيغ يتداخل فيها الشفهي الذي تعبر عنه عامية مفصحة، تعد مركزاً للحكي اللغوي داخل السرد، مع البصري عبر تقديم مشاهد سردية تجعلك تتخيل ما يدور وتتعاطى معه بوصفه نصاً بصرياً مستفيداً في ذلك من حسٍ سينمائي ووعي بكتابة السيناريو.
ثمة مستوى لغوي آخر في النص يبدو فصيحاً، ومستوى ثالث يبدو عامياً بامتياز، بما يطرح جملة من الأسئلة النقدية حول طبيعة اللغة في النص الأدبي، بخاصة أن الكاتب تعاطى معها بوصفها وسيلة لا غاية، وإن ظلت بعض الجمل المجانية التي يمكن حذفها من دون أن يتأثر النص خصوصاً في المستوى العامي المباشر، حيث طغت العامية اللغوية بفتنتها.
يتنوع أشخاص المكان ويبدون حاملين أشواقاً صوب أمانيهم البسيطة. نبوية التي تحلم بالزواج، فهمي المسكون بمصاحبة فتحي عبد الفتاح، جلال حسين الباحث عن دور سياسي، الشيخ عبد الشافي الحالم بمضاجعة فوقية المدرّسة، حنفي مزروع المنادي بالهتاف التاريخي (من ده بكرة بقرشين)، عم علي، خنّاق القطط، الذي يجترّ حكاياته كل مساء، حسين البكري الذي يزهو بانتسابه إلى الأشراف مع أن جده- خليل البكري- كان عميلاً للفرنسيين. نجوى السمراء، صارت مدرسة ولم تغادر أنفها قط رائحة الحمير، ولا آذانها أصواتهم حتى بعد الانتقال إلى سكنٍ جديد، يقع أسفله مبنى «مستشفى الشعب لعلاج الحيوانات». ويظل الراوي البطل ينقل ما يدور بعين كاميرا تدور في الزوايا المختلفة للمكان لتقدمه بتقاطعاته مع أمكنة أخرى.
يبدو الكاتب مسكوناً بالبشر، ويتبع في نصه ما يسمى «التوالد الحكائي» بحيث تتناسل الحكايات بعضها من بعض وتتفرع، فيصبح مثلاً الحكي عن الممثل المغمور أحمد عبية حكياً عن المسكوت عنه في جانب من السينما المصرية ذاتها، وعن عالم الكومبارس المغبون، بخاصة أن الراوي البطل ظل وفياً لأستاذه الذي كان موجهاً للغة الإنكليزية، فيجالسه في 6 شارع عماد الدين، ويرى ممثلين آخرين همَّشهم الواقع: محمود فرج، محمد صبيح، سُمعة وغيرهم ممن رفدوا الفن المصري بروافد مختلفة.
وفي مفتتح المقاطع السردية يثبت فتحي سليمان بيتاً من الشعر- كما حدث حين تماس مع أبي تمام- ثم يبني مقطعه السردي، ويمنح هذا المفتتح شكلاً مغايراً للخط المكتوب به النص، في توظيف جيد لفضاء الصفحة الروائية. فيبدأ بجملة شعبية دارجة: «من ده بكرة بقرشين»، أو يبدأه بذكر شخصيته المحكي عنها، نجوى السمراء الفاتنة مثلاً، وبما يهيء المتلقي إلى أن ثمة حكياً سيتم عن هذه الشخصية، وهكذا.
تبدو رواية «بولاق أبو العلا» مشوبة بحس ساخر ينتج مزيداً من المعنى ولا يعد مثلاً من قبيل الترويح الكوميدي، إنه تعبير عن هذه الروح المصرية المسكونة بالسخرية والتي تراها أحياناً وجهاً من وجوه المقاومة أو تعرية الزيف السياسي/ الاجتماعي. ففي إشارات متكررة عن الرئيس من قبيل «المؤمن/ السادات»، مثلت الإطار السياسي المتسرّب بنعومة في الرواية بعيداً من أيّ مقولات أيديولوجية زاعقة أو مباشرة. وهو يستخدم في ذلك تواريخ فارقة «النكسة/ انتفاضة الخبز 1977». وتبدو سنوات الانفتاح كأنها تحوي خراباً دامياً، يشار إليه في عبارات مقتضبة، مثل تلك التي وردت في مختتم الرواية: «الله يرحمك يا أنور. ما لحقتش أعمل فلوس في أيامك». (ص 90).
تتوارى مساحات السياسي أمام الفني ويبدو التعبير عن المكان تعبيراً عن فضاءاته الأهم، المتجاوزة حيّز الجغرافيا لتصير الحكاية عن بشر عاديين يحملون هواجس أو أحلام بِنت أوانهم، في لحظات مختلفة وحيوية من عمر المكان العام ( مصر)، بتجليه وتمثله الرمزي ( بولاق أبو العلا)، كأنها تعبير نابض عن حيوية الاختلاف التي تسمُ أُناساً يدافع عنهم فتحي سليمان، ليس عبر الرطان الكلاسيكي للمثقف ولكن عبر مزيد من الحكايات اللامعة والطريفة والدافعة إلى التأمل والتساؤل في آن.