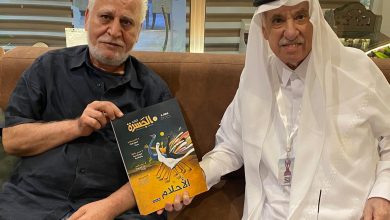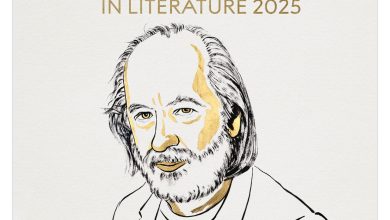آليات الحَكْي ووَعي الكتابة في «خريف العصافير» للمغربي خالد أقلعي

الجسرة الثقافية الالكترونية
عبد السلام ناس عبد الكريم
الكتابة الإبداعية هي الكتابة التي تسخر الإبداع الجمالي لرصد الواقع منفتحا على اللحظة التاريخية. هي كتابة واعية على الرغم مما يقال من إنها ممارسة عمياء قاصرة عن إدراك ذاتها وأبعادها.
هذه المقولة يسري حكمها على تجربة الكاتب خالد أقلعي أحد الأسماء الطليعية في الكتابة الروائية في المغرب. وأقل ما يمكن قوله عن تلك التجربة أنها حافلة بالحدوس اللماحة التي تجتلي واقعها المرجعي من زوايا وأبعاد تعطي الدليل على قوة الانسجام والتآلف بين الوعي المبصر والحس الإبداعي النابض لصاحبها، سواء في أعماله السردية، أو من خلال إسهاماته الماتعة في السينما، مؤلفا ومخرجا وكاتبا للسيناريو. والرواية التي أتناولها بالتقديم في هذا اللقاء «خريف العصافير» هي آخر إصدارات الكاتب، وتنم عن قدر من النضوج والتطور لهذه التجربة التي يحدوها البذل والجهد العميق الذي يجذّر وعي الكتابة في كتابة الوعي. ينطوي عنوان الرواية «خريف العصافير» على عبارة مثيرة للحدوس بما تعكسه من مقام تنابذي مثقلٍ بالتضاد بين مدلول النهايات المنبثق من ملفوظ الخريف، ومعنى البدايات المتحقق في لفظة العصافير، ضمن تشكل بلاغي إبلاغي متصل بإيحاءات العنف والسطوة. والحصيلة أن الرواية من خلال عنوانها هذا تشي بأن شخوصها كائنات مستلبة مشلولة الحركة لها شأن شبيه بعصافير الخريف، تظلّ عاجزة عن التحليق متشبثة بالأغصان خوفا من سطوة الرياح. ولاشك أن قارئ هذه الرواية سيلاحظ تناظرَ عنوانها في اللفظ مع عنوان موسوم لواحدة من أشهر روايات الهرم الكبير نجيب محفوظ هي رواية «السُّمان والخريف»، من حيث أنّ كليهما موصولُ الدلالة بإيحاءات الخريف وبالإيحاءات الحافلة بصنفين متمايزين من الطيور هما السُّمان والعصافير. فأما السُّمان فهو طائر من فصيلة الدّجاجيات، ويعدّ من الطيور المهاجرة العابرة للفصول بحثا عن الغذاء والمناخ الجيد. أما العصافير فهي طيور صغيرة من فصيلة الجواثم، لأن أظافرها تتيحُ لها التمسك الجيد بالأغصان. ومن العصافير فصيلتا العنادل والشحارير، وهي معروفة بالتغريد، ولكن تغريدها في الربيع مختلف عنه في الخريف. إذ يكافئ التغريد في الربيع بهجة الحياة، أمّا الخريف ففيه شجن الفقد والضياع. وعليه، فإذا اعتبرنا السُّمان في رواية نجيب محفوظ إحالة ترميزية إلى الهجرة المذهبية للمثقف الوصولي في الواقع المصري غداة الثورة الناصرية، فإن العصافير في رواية المغربي خالد أقلعي يمكن اعتبارها إيقونة رامزة لجيل الاستقلال في واقعه الموسوم بالهشاشة والإخفاقات المتتالية. فهل تسلّم العصافير بواقع المأساة وتستسلم للمصير؟ أم ستقاوم النزيف وتمضي في منعطف جديد؟
يمتد التشكيل الدرامي لهذه الرواية عبر ثلاثة عقود من الزمن، تتداخل فيها الوقائع وتتقاطع مع سيرة جعفر بوريشة الذي تقدمه الرواية بطلا إشكاليا يمسك الأحداث ثمّ يكتوي بنارها. في محيطه تتناسل المحكيات، ومن وعيه تتداعى اللحظات في اللانهائي العجيب. في الفصل الأول: «فندق النخيل» يتحدد الملمح التقديمي لهذه الشخصية من صورة شخص يلخص هويتـَه حزام ناسف ينوي تفجيره في فندق سياحي. ملمح مشحون بدلالة العنف كافٍ للتأشير إلى الصورة النمطية لشخصية الإرهابي المستهلكة في الأكليشيهات الإعلامية. لكن هذه الشحنة تتداعى لِما أبداه الشخص من ترددٍ وتأمل عميق قاداه إلى ترجيحٍ غريزة الحياة على نزوع الموت، متخذا الاسترجاع أداة للكشف عن تداعيات الموقف في علاقتها بتناقضات الواقع وانحراف القيم الضابطة للسلوك الاجتماعي. وقد وظّفت الرواية لتصريف هذه التداعيات ضمن نسيج القص فصولا استمدت عناوينها من مرجعية الأحياز المؤشرة لعمق المأساة وهي: السجن المدني، غرفة الإنعاش، باحة دكان سي علال… وعوّلت في فصلها الأخير «عش عصفور جريح» على حسم التحول في مصير البطل بعد واقعة الفندق، بالتركيز على مضاعفات الاعتقال وكلفتها الباهضة على النفس والجسد. أما التشكيلات الفرعية للحدث فهي تتقاطع مع المحكي الأساس لفرز تمفصلات الصراع الدرامي الذي يرجّح كفّة الشر والفساد التي يمثلها (الطيب السويهلي بوشيبة) الأب الجائر، على كفة الخير والصلاح الذي يعكسه مصير الأم (مليكة بنت الحاج عبد القادر)، المرأة الصالحة التي ألقى بها قدر الطلاق الجائر في هاوية الضياع. وتتناسل محكيات القائمة الأولى تحت مسميات (القاضي الكحلون) مشغل الأم الذي دنّس عرضها ثم قادها مكرهة إلى مافيا الدّاهي في مدينة «رموش العروس». (الحاج عشيبة) صاحب المعمل، مشغّل جعفر ومن لفق له التهمة التي غيرت مسار حياته. (عبدالنعيم) محاسب المعمل وصهر عشيبة، انتهازي وسخ مسكون بالفساد وتدنيس الأعراض.
(مراد الدويب) نقابي مضلّل ومتاجر بحقوق العمال. أما القائمة الثانية فهي تضم أسماء (فنة بنت سعيد هيوط) رفيقة الأم في محنتها، والزوجة التي أخلصت الود لجعفر ولزمت خدمته بعدما حلّ به المُصاب. (مزيود) حارس العربات، بوهيمي متحرر، ومثقف مستلب يرطن بالإنكليزية في كلّ موقف.
(المريضي) سائق في معمل الحاج عشيبة، رشّح جعفـراً لزعامة النقابة ودافع عنه في محنته. أما القاسم المشترك بين حيوات هذه القائمة فهو ما تنطوي عليه من سمات الحبّ والنقاء ونصرة الحق والإقبال بحماس على الحياة رغم مآسيها. ومن كلّ ذلك تعكس الوجه الشّفيف والجوهر اللطيف لشخصية جعفر.
أما البنية الحكائية في هذه الرواية ليست بمواصفات البناء الخطي التراكمي المعتاد في حبك الأعمال التقليدية، بل هي عبارة عن بناء درامي شديد الكثافة يشي بحضور وعي متعاظم يعقد القصّ ويجريه على أنين البوح وصرخة الشجب والإدانة، عبر خيوط دقيقة واصلة بين أطياف الذاكرة وهذيان اللحظة. وبحسب باشلار: «يوجد نمو كينونة في كل وعي لشيء ما»، لأنّ الوعي معاصر لصيرورة نفسانية نشيطة. والعمل الروائي «خريف العصافير» يعدّ مؤشرا ترميزيا لهذه الصيرورة من خلال ما يجليه من تقاطع صدامي بين نمطين من الوعي، وعي الواقع ووعي الذات. فالأول تؤطره سلطة الأعراف الجمعية، والثاني وعي غير مؤطـر يبدأ باستنارة روحية تستحضر الذات في لوعتها وانكساراتها، وينتهي بتأمل عميق لجوهر الأشياء واستشراف حثيث لأجواء السكينة. إن أحياز الرواية بمظاهرها وأبعادها المختلفة تتحكم في تفسير هذا الوعي المزدوج من خلال متوالية الأمكنة المغلقة الناظمة لأبعاد الواقعي المألوف وصورة النمط المكشوف، وهي: المستشفى، السجن، غرفة الإنعاش، عش العصفور… فالعرض المكثّف لهذه الأمكنة المضغوطة يقود إلى كشف الأثر النفسي السّلبي الذي تعكسه، وهو أثر معقود بواقع قهري صاعق ينوء بمعنى الاختناق وانسداد اللحظة الواقعية. ثم إن وضع هذه الأحياز في إطارها النصي الناظم (مدينة تمودا) يجعلها موسومة بدليلها المرجعي الذي يسخر حفريات التاريخ في تأويل منطق الراهن. لأنّ تمودا موقع أثري تلاشت هياكله واختفت منه سماته الأصلية الموصولة بالتمدن. فضاء يتوسله محكي الرواية قناعا لمحيط إنساني تئن فيه الحيوات تحت رحمة النسيان ومنطق الصمت والإقصاء. وفي المقابل النقيض تبدو مدينة «رموش العروس» من خلال سمتها التـّـرصيعيّ فضاء عجيبا خارج الجغرافيا والتاريخ. فضاء من فضاءات ألف ليلة وليلة، يغذي المخيال ويروي ظمأ الحياة وأشجان الغواية. مؤشر واضح لواقع سيكولوجي مثقل برواسب الجرح النرجسي ودمائه الجامدة، وبالرغبة في ولوج متاهات الحلم التعويضي. وملامحه دالة على مسالك الوعي الشقي الذي لا يحتفي بروما وهي تحترق، بل يكتوي بنارها من الداخل. أما أبعاده الفنية فتشي بسمات الواقعية النقدية التي لا تكتفي بإدراك الظواهر وربطها بدليلها المادي المكشوف، بل تفسرها وتضعها في سياقها النفسي الموصول بسَمْت التمثلات. وقد عبرت عنه الرواية بتشريح وعي الواقع في سلاسة وانسياب من خلال كيمياء البوح العابر لمسافات الغفو والصحو وحدود الزمان والمكان. وساهم في تطويع هذا الأسلوب استعانة ُالكاتب بخبرته في كتابة السيناريو من خلال حبك الربط بين مشاهد التتابع ومشاهد التجميع، حيث تتدفق الحركة ذهابا وإيابا وتبدو التغطية منطقية وفي غاية الإمتاع. ومن مظـــاهر هذا التراكب الممتع لتراسل السرود ولحظات الوعي وفيــــض المشاعر ما ترسله محكيات الأم والزوجة من تلوينات السرد المهموس النافذ في أعماق الكينونة، وهي في غفوتها السرمدية، حتّى تُشعّ حوْلها الأنوار وترسلَ خطوها فوق النتوء وتمضي بها رغم العاصفة. كما العصافير في لوعة الجراح تطوي عنادَ الريح وتـكسـِـرُ طوق الخريف. توصيف بليغ وتصوير عجيب وظفته الرواية للتعبير عن فحوى المقولة الخالدة التي تلخص جوهر الصراع الدرامي في الأعمال الروائية الكبرى، وهي أن الإنسان يمكن هزيمته ولكن لا يمكن قهره.
المصدر: القدس العربي