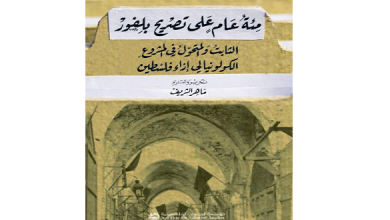«سندريلات مسقط» لهدى حمد.. جنيّات عُمان

رامي كوسا
في الشرق، حيث يقبضُ الدين على مفاصل الحياة كلّها، وتكثرُ اللاءاتُ بحجّة الموروث والعادات والتقاليد، تَكتسبُ الحياة طابعاً ذكوريّاً يستدعي جملة تمرّدات تُحاول أن تنتصر لقضايا المرأة وتضيء على أوجاعها. تقع أغلبُ هذه المحاولات في فخّ تناول العناوين العريضة بمعالجاتٍ أقلّ ما يُقال فيها إنّها تفتقرُ إلى الموضوعية أولاً، وتنساقُ خلفَ ما هو غريزيّ من الكتابة الحسيّة ثانياً.
الروايات الّتي تلعن الذكر في الصفحة الواحدةِ ألف مرّة، هي رواياتٌ «بيّاعة» بدون شك، ولها جمهورٌ يجعلُ دار النشر تتسابقُ إلى إصدار طبعاتٍ متتاليةٍ تُرضي شغف النساءِ الراغباتِ بقراءةِ سطورٍ تنتقم لهنّ من حبيبٍ خائن أو شابٍّ متعجرفٍ أو فتىً لعوبٍ أو رجلٍ لا يعرف كيف يحبّ. الحقيقة أنّ آخر ما يُمكن أن ينتصرَ لقضايا المرأة، لجهة التأثير في الوعي الذكوريّ وجعله أكثر حساسيةً لهمومِ النساء، هو هذي الروايات «البيّاعة».
إذا كانت أغلبُ الروايات الّتي تُعنى بالهمّ النسويّ، تسقطُ في شركِ الاستسهالِ والغرائزية وميوعة الطرح وصفراوية التحريض، فإنّ «سندريلات مسقط» لم تغُص في هذا المستنقع بكلّ تأكيد.
«سندريلات مسقط» روايةٌ للكاتبة العمانية هدى حمد، تتناول حكايةَ ثماني نسوةٍ عمانيات، تلتقين مرّة كلّ شهر في واحدٍ من مطاعم العاصمة. تجلسنَ على كتفِ البحر، وتحكين عن حيواتهن بما فيها من أسرارٍ وبوحٍ ودمعٍ وخيبة.
تنطلقُ الرواية من افتراضٍ سحريّ يجعلُ القارئ يستسلم لشرط وجودِ الجنيّات اللواتي فقدن قيمتهنّ لصالحٍ حياةٍ اجتاحتها التكنولوجيا ونال منها الصخب. ننوسُ هنا بين الفنتازيا والواقعية في تفاصيل التفاصيل، حيث نقرأ، مثلاً، عن جنيّة اصطدمت بصحنِ الدشّ على السطح فماتت. وعلى سبيل استكمالِ الافتراضِ الشرطيّ، تهمسُ لنا الروائية في أوّل الحكاية «لكن حتّى وإن افترضنا جدلاً بأنّ جنيّات مسقط مُتن جميعاً، أو اختبأن بخجلٍ، لأنّ أحداً لم يعد يستعين بهنّ أو يفكّر بأوجاعهنّ في تلك العزلة، فإنّ القوى الخارقة للتحول لا محالة موجودة في مكانٍ ما، ربمّا تكون مطلقة في الهواء، وكلّ ما تحتاجُ إليه هو كائناتٌ قادراتٌ على التقاطها». بطلاتُ الرواية الثماني التقطنَ هذي القوى، فصرنَ سندريلّات.
نساء عُمانيات
«فتحيّة» تكره صورةً عائليةً قديمةً تُذكرها بشكلها غيرِ الجميل في ماضيات السنين، و «سارة» تتحدّث عن معاناتها، ووالدتها، مع جدّتها الخرفة الّتي صرفت سنواتها الأخيرة في الأذية والسُّباب، و «نوف» الّتي خشيت أن يتضخّم صدرها ليحاكي صدر عمّتها «زيّانة»، فحالت دون تناميه، هي اليوم تخشى العنوسة بسبب تمنّع العرسان عنها لأنّهم لا يرغبون بالارتباط بـ «فتاةٍ دونَ تضاريس»، أمّا «ربيعة» فهي تشتاقُ إلى كينونتها بعيداً عن القوالبِ الجامدة الّتي حُبِست فيها استجابةً لتوصيات زوجها رائد. «ريا» امرأة ريفية تزوّجت بدوياً قِيل إنّه جامَعَ بقرةً فجعلَ عائلته محطّ سخط الضيعة كلّها، وبعد ثلاثين عاماً من هجرتها للقرية واستقرارها في العاصمة، لا زالت السيدة الخمسينية تستذكر وجعها في حضرة السندريلات. تُعيدنا «عليا» إلى زمنِ القنواتِ الأرضية وما كان يعرض عليها من مسلسلاتٍ مكسيكية أثرت في الوعي الجمعي للمشاهد العربيّ، فنقرأ عن توقِ الصبية إلى فضاءاتٍ أكثر دفئاً تُشبه تلك الّتي تحكي عنها المسلسلات. ثامنُ سندريلات مسقط هي «زبيدة»، الراوية الرئيسة للحكاية، تحكي لنا الأخيرة عن عمّتها «مُزنة» الّتي أُصيبت بداء ألزهايمر في سنٍّ مُبكّرة فتلاشى ماضيها وغارَ صباها إلى غير رجعة.
في تمام الساعة الثانية عشرة، تهجر السندريلات المطعم وتسرن في الشوارع خفيفاتٍ من كلّ عبءٍ بعد أن بُحنَ بأسرارهن لرئيس الطّباخين الذي منحهن الذهب الّذي لطالما احتجنه. منحهنّ الإصغاء.
هذه الأقاصيص قد تبدو مألوفةً جداً وخاليةً من أيّ فتحٍ حكائيّ، كما أنّ اللغة الّتي صِيغت فيها الرواية لم تكن عاليةً ولم تحمل اصطياداً أدبياً يُذكَر. لكن ما يُحسب لهدى حمد هو موضوعية طرحِ الهمّ بعيداً عن شيطنةِ الذكر واعتبارِه المُتسبّب الأول بتعاسة جنسِ النساء.
في الورق، لغةٌ بسيطةٌ وحكاياتٌ تُكاشف مجتمعاتنا ببعضٍ من مشكلاتِ نسائه. هذا الصنف من الرواية لا يحتاج أن تُنقش على غلافه عبارة غريزيةٌ تُحاكي رخص السوق كرمى لمبيعاتٍ زائدة وانتشارٍ مُضاف.
(السفير)