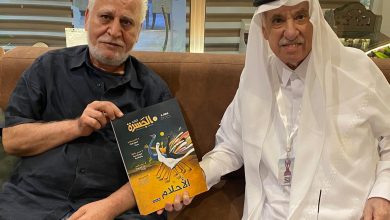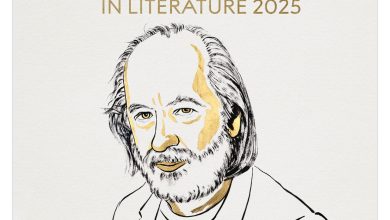محاولة للخروج من «جحيم الغرف المغلقة»

محمد شعير
لم يكن عنوان «محاولة للخروج» مجرد عنوان اختاره الروائي المصري الراحل عبد الحكيم قاسم لواحدة من رواياته المتميزة، بل يصلح تلخيصاً لمسيرة حياته، لأزمته الشخصية في البحث الدائم عن ذاته، في الشيء ونقيضه معاً، كلما وصل إلى يقين ما تركه، إلى نقيضه: في التصوف أحياناً، وفي الماركسية أحياناً أخرى. كان يحاول دائماً التحرّر من أسر المكان ووطأة جدرانه في السفر الذي أراد أن يحرّره من «عبودية الأماكن»، أو حتى فى ممارسة العمل السياسي المباشر، حيث اللقاء بالجماهير والحوار معهم. دامت رحلة البحث، ولكنه لم يجد نفسه سوى في الكتابة وحدها.
لم تكن ظروف ولادته عادية، كانت أمه الزوجة الثالثة لوالده، فتاة جميلة، صموتة، فشلت خطبتها من ابن عمها، فتزوّجت والد عبد الحكيم الذي ظل محباً لزوجته الأولى التي أنجبت له أبناء يفقن زوجته الثالثة عمراً. عندما جاء عبد الحكيم إلى الدنيا كان لأبيه «دار وأرض وبهيمة وعيال» غير أن عبدالحكيم ولد «عليلاً وهزيلاً». هذه العلة كان لها عميق الأثر في تشكل بداياته الأولى وعلاقاته مع أقرانه وأبيه.. يقول: «تنفيني علتي عن صحبة أقراني من العيال، وتلزمني كُن أبي ومجالس أصحابه في الأصائل الرقيقة والأماسي الندية في ردهة دوارنا». الأب كان محدثاً رائعاً، قادراً على السيطرة التامة على مستمعيه، وكانت تجربته الحياتية هائلة، فهو رجل كثير الأسفار في البلاد، كثير الأصحاب مشغول بالأولياء والمزارات والموالد والأسواق. لكنه قبل كل شيء وبعد كل شيء مفتون بالكلمة يجيد قولها ويجيد الإنصات إليها وهو يدرك سرّها ويطوّعها لحكايته ويصنع منها عالماً مغايراً للواقع اليومي المترَب المنضوح للشمس.. وكانت البداية: «لقد فتح أبي هذا العالم لي لأهرب إليه، أنا الطفل العليل غير القادر على ممارسة الحياة العادية لأقراني من العيال، هربت إلى عالم أبي هذا وأحببته ولزمته». ولكن لم تكن العلة وحدها سبباً في قربه من عوالم والده، كان هناك أيضاً عالم الذكورة في تقاليد قريته، عالم صارم «مجبول على تقاليد أبوية شديدة العمق في نفوسهم، كانوا يستهجنون أن يتعلق الذكور من أبنائهم بالأمهات، كما يقول في مذكراته غير المنشورة. وهكذا كانت عوالمه صوفية، حيث الموالد والحضرات الدينية، عشق المرحلة التي عبر عنها في روايته الأولى «أيام الإنسان السبعة» ولكن قرب قاسم من أبيه لم يدم طويلاً، اضطر في عامه الثامن أن يهجر قريته «البندرة» إلى قرية أمه في «ميت غمر» (بالغربية) لكي يدرس في مدرستها. خمس سنوات كاملة قضاها في بيت الجد، لم يكن يشعر فيها بسعادة: «لم تحبني جدتي أبداً، ولم يلاحظ جدي وجودي تقريباً، وخالي عصف بي في كثير من الأحيان». زادت غربته إذن في هذه المدينة عمقاً: «أنا الطفل النحيل الشاحب الريفي اللسان، ولم يكن ثمة حضن أبي لألبد فيه، في بيت جدي عرفت الكتاب، وقمت برحلتي في عالم الكتب وحدي، وربما بقيت سنين طويلة أعرف أشكال بعض الكلمات ومعانيها دون أن أعرف كيف تُنطق نطقاً سليماً». لم تكن الكتب كثيرة «كان الكتاب في بيوت الفقراء تديّن أو طرفة أو صدفة».. ولكنه كان يحلم أن يكون مثل هؤلاء الصغار الريفيين الآتين إلى «ميت غمر» من القرى القريبة، لكنهم يعيشون بأنفسهم دون رقيب في غرفة مستأجرة، يحيون فيها حياة فقيرة، لكنها بسيطة وطليقة. بدأ حلمه يتخذ شكل البدايات القصصية فكتب مثلاً عن شاب يعيش وحده في غرفة على السطوح ويقع في حب جارته: «كان حلماً رائعاً، وكأنني لم أصدقه فأنهيته نهاية فاجعة، انتحرت الفتاة وجن الفتى». ضاعت صفحات القصة ونسيها ولكنّ شيئا هاما جدا بقي له: «أن القراءة والكتابة هما عالمي، هما مهربي من عالم لا أستطيع التواؤم معه». وفي تلك المرحلة بدأ الشوق إلى القراءة كما يقول: «شوق نابع من احتياجات كانت تسوطنا لنجري ونلهث نبحث عن الكتاب في مظانه التي هي ليست سوى بيوت أمثالنا». ولكن في تلك الفترة كان مستغرقا تماما في قراءات كتب الفقة والسيرة النبوية وهذه القراءات قادته إلى الانضمام – كمعظم أبناء الريف – إلى جماعة الإخوان المسلمين.
كانت مرحلة الإخوان في حياة عبد الحكيم امتدادا لمرحلة «عالم الكلمات».. قبل أن يغادرها على يد أصدقاء آخرين دخل من خلالهم إلى مرحلة «الحياة الحقيقية» التي عرفها عندما ترك قريته إلى المدينة الكبيرة «الإسكندرية» من أجل دراسة الحقوق. هناك بدأ يقترب حثيثاً من بعض أفكار اليسار، وخاصة المتعلقة بالولاء للشعب وبالحركة الوطنية والقومية، ثم بدأ في التردد على القاهرة لزيارة بعض اصدقاء الطفولة، ويتعرّف على عالم المثقفين.
مفاجأة الآداب
وكانت المفاجأة عندما نشرت في مجلة «الآداب» البيروتية. ولكن فرحته بالنشر لم تستمر طويلاً فقد ألقى القبض عليه بتهمة الانتماء إلى تنظيم شيوعي. السجن… تجربة أخرى، تركت تأثيرها الكبير على قاسم.. هناك التقى صنع الله إبراهيم، ورؤوف مسعد، وكمال القلش. وحسب الروائي صنع الله إبراهيم لم تكن للمناقشات التي دارت بين «الأربعة» حول السياسة وإنما «حول الكتابة والمحاولات التي يقوم بها كلّ منا، وكنّا نعبر عن معارضتنا للمفاهيم الجامدة لمدرسة الواقعية الاشتراكية في الأدب والفن ونسخر من تصريحات خروشوف حول الفن التجريدي، وهذا ما خلق حساسية في علاقتنا بمحمود أمين العالم».
في السجن بدأ قاسم التخطيط لروايته الأولي «أيام الإنسان السبعة» (1969) التي كان صدورها وقتها بمثابة «قنبلة» أدبية، إذ اقترب فيها قاسم من عوالم الريف برؤى جديدة اختلفت كليّاً عن الكتابات السابقة له، كما عند محمد حسين هيكل، ويوسف إدريس وغيرها. حتى أن الدكتور الناقد عبد المحسن طه بدر خصص لمناقشة الرواية فصولاً عدة في كتابه «الروائي والأرض». ووصف إدوار الخراط كتابته بأنه «كاتب القرية المصرية الأمهر المولّه بعشقها، المعجونة روحه بطينها، الموزع قلبه على ناسها، المعلّق هواه بأهوائها.. يعرف الفقر والألم والمرض والموت في القرية، ويعرف كيف يصوغها لأنه يعرف ويصوغ أيضاً غناها الفاحش وشبق نشوتها وحبها للحياة وإيمانها الأولي العميق، هو يرصد دقائقها وخفاياها بعين المحب العارف وبيد الاقتدار».
وبرغم الاحتفاء الشديد بالرواية إلا أن قاسم لم يستطع أن ينشر أياً من رواياته وقصصه.. لأسباب لم تكن معروفة.. وهو الأمر الذي جعله يشعر بإحباط شديد، فقرر الهجرة إلى المانيا بحثاً عن «لقاء الحضارة الأوروبية على أرضها ومعايشتها ومعاناتها وتجربتها بالحواس الخمس لا فقط بالقراءة والنظر العقلي». كان يخشى استقرار الصورة لدى الناس حول حياته باعتباره «موظف المعاشات المظلوم الذي لن يقدم شيئاً بعد روايته الأولى». وهكذا قرر أن يغيب فترة في أوروبا ويعود «اسما جديدا، بدءا جديدا، وربما يكون الوقت في مصر قد تغير، وهو لا بد متغير بحيث يكون لنا فيه مكان».
ألمانيا
في المانيا حاول ان يعيد اكتشاف نفسه من جديد. حيث بدأ في التحضير للحصول على الدكتوراة في الأدب، وكان موضوعه الأساسي «رواية جيل الستينيات»، وهناك توالت أعماله الهامة ما بين القصة والرواية وأحياناً الشعر مثل «جحيم الغرف المغلقة»، «ديوان الملحقات»، «المهدي»، «الأخت لأب»، «سطور من دفتر الأحوال»، «الأشواق والأسى»، «الهجرة إلى غير المألوف» وكانت بيروت تفتح ذراعيها لنشر هذه الأعمال، إذ صدر معظمها عن «دار التنوير». سنوت برلين لم تحرر قاسم من «عبودية الأماكن» كما أراد، برغم أنه سافر بحثاً عن ثقافة غربية تصقل موهبته، فعندما قرر إنهاء منفاه الاختياري عاد مدافعا عن الثقافة القومية وداعياً إليها. هكذا ضاق بالبذلة الإفرنجية التى كان يرتديها في برلين، ليخلعها على باب داره مرتدياً جلبابه وطاقية رأسه. وأعلن بعد وصوله إلى مصر: «إنني غير مستعد للتصالح مع النموذج الأوروبي على أي مستوى من المستويات». عاد قاسم من برلين، مطالبا باحترام مجمع اللغة العربية واتباع قراراته حتى وإن بدت غريبة وغير معتادة، وكان ذلك رداً على من هاجموه لأنه استخدم كلمة «مرنأة» بدلاً من «تلفزيون». كما قرر أن يعيد كتابة «أيام الإنسان السبعة» بعد أن يخلصها من العامية، كما صرّح لبعض أصدقائه. هكذا أيضا يظل يبحث عن «نظرية جمالية عربية» بعد أن ظل العالم العربي معتمداً على «نظرية أوروبية».. فالثقافة العربية من وجهة نظره: «في حالة دفاع عن ذاتها وبينما الغربية في حالة محاولة للسيطرة على العالم.. ومن المستحيل أن نفسر الكتب العربية والأعمال الفنية العربية بثقافة مختلفة جوهرياً في الموقف التاريخي». ثم قرر أن يخوض انتخابات البرلمان. لم يكن موقفه مدهشاً لمن عرفوه. عندما سمع الروائي إبراهيم منصور بالأمر ضحك قائلاً: «يعملها عبد الحكيم». ففي سنوات اغترابه كان قاسم يتحدث دائماً إلى أصدقائه حول أمنيته بأن يكون هناك «نظام اجتماعي وسياسي في بلدنا يتيح للفرد أكبر توظيف ممكن لكفاءته وقدراته. لا أريد لإنسان أن يقفز علي ظله، لكنني أكره أن يكون ثمة ما يعوقه عن أن يحقق ذاته».
وفي الانتخابات لم يحقق نجاحا كبيرا، أنهكته التجربة التي لم يكن مستعداً لها استعدادا كاملا، لم يكن يمتلك القدرة على منافسة نماذج من البشر لا يملك شطارتها ونفوذها. لم يحقق النجاح، وكان الأمر بداية لهزيمة الجسد الذي سقط مصاباً بالشلل!
(السفير)