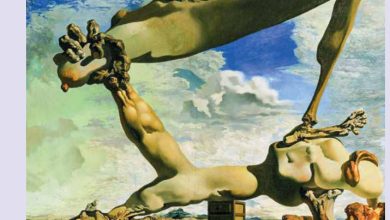شارع الصابحة.. رواية باللغة المصرية
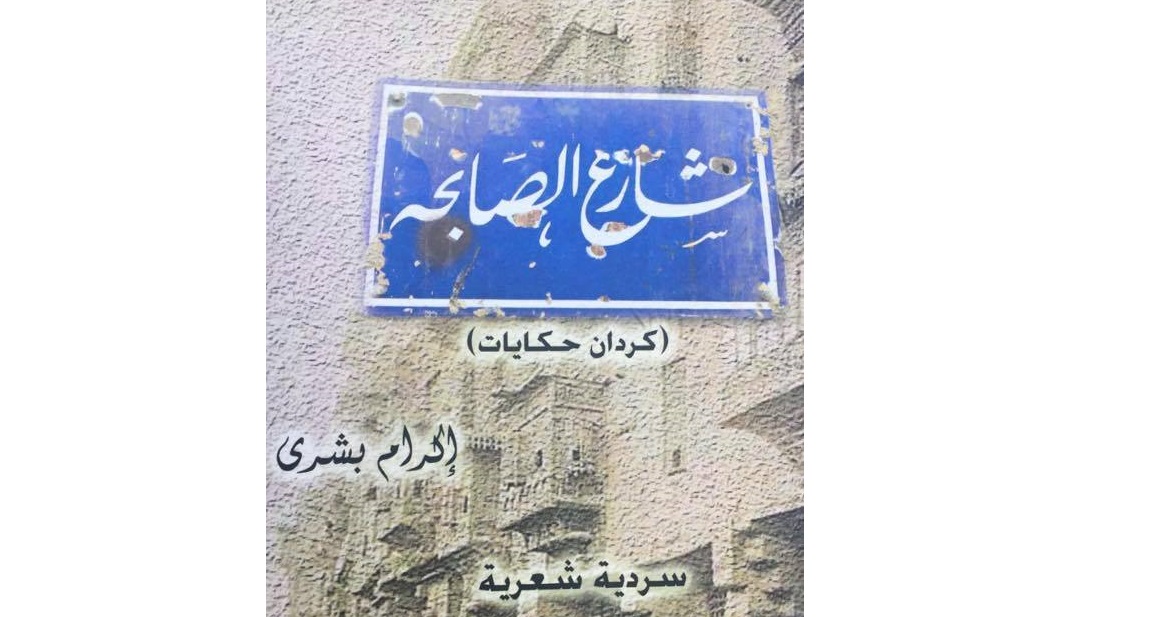
خاص ( الجسرة )
*يوسف وهيب
ــــــــــ
في تجربته الجديدة ” شارع الصابحة – كردان حكايات” للشاعر إكرام بشرى، الصادرة عن ” الدار للنشر و التوزيع” التي يديرها الفنان التشكيلي محمد صلاح مراد، يلمس القارئ ويستشعر بكل مسامه أنه في تجليات هذا الشعر المتقد، حين يكون لغة لرواية أو متتالية حكائية بلغة مصرية صافية، هو شعر حقيق بجوهر الشعر، إذ أنه يتماس وعمق ما تم اختزانه في أخاديد الوعي المصري، الذي قهرته ظروف تاريخية و سياسية على مر العصور، وفيما يدعي البعض أو يتوهم الواهمون أن اللغة المصرية دون الفصحى – هكذا في تعالٍ لا مبرر له- في تصور “من تعربوا” وهذا تعبير أراه يماثل تماما تعبير ” من تفرنجوا” أي انساقوا أو أُرغِموا في بدايات الأمور إلى لغة المستعمر، سعيا للحصول على وظيفة في دواوين الحكومات المتعاقبة، وهو بالمناسبة ما اشترطه ” ابن الحكم” وغيره من الولاة في مصر، ممن وصل بهم الحال إلى تقطيع ألسنة من يتحدثون باللغة المصرية، إن معنويًا كما رأينا في مساومتهم على الوظائف أو الإغراءات الأخرى، وإن ماديًا كما حدث مع من تحدوا مثل هذه القرارات اللاإنسانية، ولاستمرار بطش هذا المستعمر أو المحتل، سواء البطش المادي كالعقوبات التي تمثلت في قطع ألسنة من لا يتحدثون لغة المحتل الغازي في غضون السنة السبعمائة بعد الميلاد، وما بعد ذلك حتى الآن، يتبدى للبعض أن اللغة المصرية غريبة بين أهلها.
ولئن كان المجال هنا لا يتسع لطرح قضية اللغة، بما تستحق، إلا أن المتأمل للحال سيجد أن جُلَّ من يكتبون بالفصحى، يفكرون و يشعرون و يعيشون حيواتهم ويخاطبهم شخوص رواياتهم وقصصهم، وما إلى غير ذلك من صنوف أدبية، باللغة المصرية التي بها يحيون وعليها يموتون، ولن نذهب بعيدًا، فإنني ككاتب لهذه السطور، استقبلت هذه الشحنة الشعرية من شارع الصابحة” كما يحدث مع غيره من كتب وروايات، بما فيها المكتوب منها باللغة بالفصحى، بأحاسيس ومشاعر وموصلات وترددات لغتي المصرية التي بها أعيش وأفكر وأشعر

شارع الصابحة ليس مجرد شارع أو حارة، فهو وإن كان في وجوده الجغرافي أو تجلياته الاجتماعية والإنسانية، يماثله الكثير من الشوارع و الحارات في شتى ربوع مصر، بل في هذه “السردية الشعرية” أو “الشعرواية” ، يتجلى أهل الشارع في حضور شعري يعيد تشكيل الواقع من جديد، ولئن كان الظاهر من حكيهم الشعري، بطبيعة الحال، سردًا لأوجاعهم وانتصاراتهم وهزائمهم، وخاصة تلك الهزائم الاجتماعية التي تأسست بفعل الغازي القديم، إلا أنهم يؤسسون ويصنعون منها انتصارًا جديدًا للوجود المجابِه والمقاوم؛ حتى ولو بالتوحد في العجز والاحتياج الإنساني العابر لأي أيديولوجيا أو دين، وإن كان في صمت ولكن في فاعلية تعدمها بطبيعة الحال أي هتافات او شعارات ثورية، ويكفي ما تقرأه على لسان العاجزة الأميّة ” أوديت حنا” لحبيبها عبد العزيز:
(أوديت قالت لعبد العزيز:
هُمّه خايفين علي البنت
أصلها بتحبه .. وانت عارف بقى
هي مسيحية وهو ومسلم
ابتسم عبد العزيز وقال لها:
طيب ما انا وانت كده برضه يا أوديت!
قالت له:
لا يا عبد العزيز.. أنا وانت.. عَجَزةْ زي بعض يا خويا!)
ويستمر الشاعر في طرح كيفية تشكّل الوعي الاجتماعي بتجلياته السياسية و الدينية، وما تتمظهر فيه من تفريق شكلي، لا يمس الجوهر، جوهر الشخصية الواعية بالفطرة المصرية، التي تدرك أنها وحدة واحدة يسري فيها دم واحد وإن تغير نوع فصيلته، فتكوينه من هذا التراب و ما ينتجه من مزروعات و طيور وحيوانات، حتى إن مفهوم الشبع هنا قد يأتي في أحلى تجلياته وهو الاستغناء و الاكتفاء بما يكمن في جلد الإنسان المصري، وهو ما يجسده قول الخالة ” أم رحِّم” : (كنت لو شمّيت ضهر إيدي باشبع) وبمناسبة هذا السطر البسيط في تكوينه وهو ما يتردد على ألسنة عامة المصريين الخُلَّص، هل هناك في أي لغة تعبير يماثله، ليس فقط فيما يلخصه من قيم وتقنية مواجهة الظروف، بل، أيضًا فيما يشكله من صور تجعل من المجرد اللا ملموس ” الرائحة” وحاسة الشم” وسيلة وطريقًا لتحقق ما هو محسوس ” الشِّبع و القناعة” بما نملك في ذواتنا؟!
اسمعوا ” أم رحِّم” وهي تحدث أبناء شارع الصابحة مسلمين و مسيحيين:
( ده انا يا أولادي
لما كنت بادخل أي بيت من بيوتكم
كنت لو شمّيت ضهر إيدي باشبع
وكونوا زي ابونا يوسف
اللي كان دايماً يسعي للخير
وإيديكم زي إيديه
يا ما خبزت خير للناس)
وتتواشج العلاقات الروحية الاجتماعية، كما تجسدها حكايات أم رحيم ونصائحها لأولادها من مسلمين ومسيحيين وغيرها، حتى أنها تعود بهم إلى الينابيع الأولى للسلام الاجتماعي، وهو ما يتمثل في تحية الصباح أو المساء، حين كان المصريون يتبادلون التحية الإنسانية العامة مثال “صباح الخير والرد يسعد صباحك، او مساء الخير، والرد مساء النور و النعمة، وفي وسط النهار كان القول نهاركم سعيد، يستتبعه حتما الرد نهاركم سعيد مبارك” وكانت هذه اللغة المصرية الأصيلة لا تفرق بين من يحمل هذه العقيدة أو تلك، لكن كل ذلك تداعى وصار في خبر كان، بعد الغزوة الوهابية منذ السبعينيات وحتى الآن.
( لكن الغرض خلّيكوا فاكرين
ان صوت الشيخ محمد كامل
كان هو الصوت الوحيد اللي بيجمعنا بعد أم كلثوم
قولوا لبعض كل ما تتقابلوا:
صباح الخير ومساء الخير
ونهارك سعيد وليلتك سعيدة
متتشعبطوش في السلامو عليكم والسلام لكم
اللي ها تفرّقكم عن بعض
الدنيا اللي شايفانا النهارده
بكره ها تتغرب من غيرنا)
وبين ما هو موجود بالفعل و بين ما هو ماثل في الذاكرة، يتحرك شخوص “شارع الصابحة”، بل هم مجدولون في حبل واحد أو كما أسماه الشاعر في عنوان إضافي على الغلاف ” كردان حكايات” وبهذا التعريف لطبيعة الحكايات، كأنه أي صاحب الكتاب الشاعر إكرام بشرى، يريد القول أنها من الأصالة بحيث كلما مرَّ عليها الزمن، كلما كانت نقية نقاء الذهب الذي يصنع منها كرداناً يعانق الرقبة كديون قديمة للمحبة، ويفرش بـ “دلاياته” وأيقوناته على الصدر حنانًا وترطيباً في مواجهة صهد الحاضر وتلوثه، وهو أي الشاعر يذكرنا بأحد شخوص رواية ” المسيح يُصلب من جديد” للروائي اليوناني العالمي نيكوس كازنتازاكيس، وأعني ذلك العجوز الذي تم تهجيره وأبناء قريته من بلدهم تحت تهديد سيوف الغازي العثمانلي ” التركي” لم يكف هذا العجوز عن حمل جِوال به ما استطاع تحصيله من عظام آبائه وأجداده أثناء هجوم البرابرة الأتراك ضدهم، ويتنقل بهذا الجِوال من قرية إلى قرية ومن مكان إلى آخر، ولا همّ له سوى الإنصات كل ليلة لما تقوله هذه العظام، ما يشحذ همته و يشحن صدره بالأمل في العودة إلى قريته، حينئذ سيعيد هذه العظام إلى موضع راحتها في تربة بلادها.
(في يوم عدَّى عليه خمسة وعشرين سنة
حطّيت في شنطة سفري بيوت وناس
سكنتهم وسكنوني
وحيطان بيوت حِبلت وجعْ
وفرح وجروح
وروح بجناحات
لَفِّت تاخد من ريحتهم
بواقي حياة
وعطر الحنين من عضم التربة
وشِلْتْ في قلبي كلام من طرف لسانهم
كان بيزُقْ في غيوم الغربة
وبواقي عجين ما اختمرش
وحفنة تراب لطريق ما اكتملش)
وفي شارع الصابحة، شأنه كأيٍ من شوارع مصر بامتداد أقاليمها ومدنها وقراها، لم يكن هناك ثَمّ خصومة على أساس ديني، ولا ثأر تجاه الآخر، بل أنهم عاشوا ولا يزال بعضهم يعيش، في منظومة لا تسأل عما وراء الظاهر لها، يدركون الاختلاف نعم، لكنهم يفطنون دوما أنه اختلاف مذاقات، معاركهم الأثيرة كانت ولا تزال معارك وجود، تتصدر لقمة العيش أولوياتها، حتى أنهم يتوحدون في أي فعل حتى ولو كان غير مقبول اجتماعياً، وحين يحاول مدّعو التدين الشكلي في الثمانينيات و التسعينيات، أدلجة الأفعال الفاضحة، وتأميم العاهرات لصالح أبناء عقيدتهن فقط، تفضح إحداهن؛ أمهات هؤلاء الصبيان الذين نبتت لهم الذقون فجأة، وتفجر لصاحبتها، وللقارئ في آن واحد، جوهر الأزمة، أنهن أمام طغيان العوز والاحتياج، الذي لا يفرق بين لحم وآخر، ينمحي الإحساس باللذة إن كانت هناك لذة، بل الحضور الأكبر هو للمبلغ الذي سيتحصلن عليه، فالشخص في نظرهن مجرد رقم هو ” الخمسة جنيهات” وكفى!
(وعارفه كمان يا جميلة انهم لما دخلوا عندك في الليل
بعد جوزك ما طلع علي وردية الحلاجة
علشان يقولوا لك ده حلال وده حرام
كلهم ما طلعوش من عندك زي ما دخلوا..
اللي زينا يا حبيبتي مش بتحس ولا بتفتكر
ولا بتعرف تفرّق لحم عن لحم ..
الحاجة الوحيدة اللي بنحس بيها
وبنعرف طعمها ولمستها
هي الخمسة جنيه اللي بيحطّوها تحت المخدة
أو بنقبضها في الأول لما يكون واحد مش مضمون )
ويبقى أن تجربة ” شارع الصابحة ـــ كردان حكايات” للشاعر إكرام بشرى، تعد بجدارة ملمحا هامًا من ملامح الرواية بالشعر المصري، دون اللجوء إلى تزييف الأحاسيس وتجميد فعاليات الأحداث المتقدة بحيوية لغة أصحابها، عبر الترجمة إلى لغة أخرى هي الفصحى، التي صار اللجوء إليها، لا دوافع وراءه سوى ما وجدنا عليه آباؤنا الذين اضطروا إلى ذلك في عصور سالفة تحت سطوة المتحكمين في أمور البلاد والعباد آنذاك، ويظل برأيي أن هذه الترجمة كما أسلفت في مقدمة هذا المقال، تفقد الأدب كثيرا من طزاجته واشتعاله وتزيف حيوات الشخوص وأفاعيلهم، حين يصير الكاتب أو المؤلف نائباً عنهم في الحديث و التفكير أيضاً بلغة غير لغتهم.