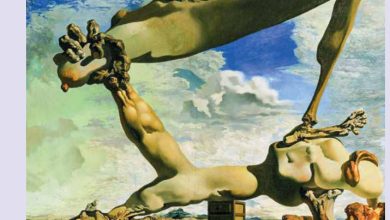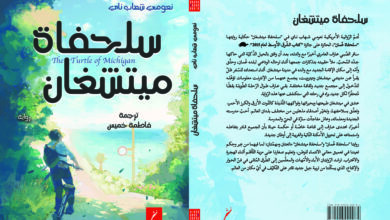الباحث العراقي صلاح حسن حاوي: بلاغة الحياة أجدر من بلاغة اللغة

صفاء ذياب
الحياة بوصفها سرداً.. هذه الجملة غالباً ما يرددها النقاد الباحثون عن قراءة يومياتنا، إلا أن هذه الجملة لن تكتمل إلا بقراءة بلاغة هذا السرد – الحياة، وهو ما سعى إليه الناقدان لايكوف وجونسون في كتابهما «الاستعارات التي نحيا بها»، ليفتتحا بذلك عالماً في قراءة البلاغة اليوم، البلاغة التي نشبت بسببها معارك وحروب طويلة من جراء جملة أو كلمة قالها سياسي بطريقة ملغمّة.. فالتشبيه والاستعارة والمجاز والبديع اليوم، ليس كما عرفناه على أيام الجرجاني والعسكري، بل تغيّر كل شيء، وبرزت مفاهيم جديدة مثل بلاغة الإقناع وبلاغة الجمهور والحجاج بنظرياته الكثيرة.. فكيف نفهم البلاغة اليوم؟ وما الذي علينا فعله؟
أسئلة كثيرة يشتغل على الإجابة عليها صلاح حسن حاوي، أستاذ البلاغة في جامعة البصرة، والباحث الذي يسعى لتقديم هذه المفاهيم بلغة جديدة ودراسات، يسعى لتغيير الثوابت التي جعلت منا حافظين لا فاهمين.
■ كيف نفهم مصطلح البلاغة الجديدة؟
□ ارتبط مصطلح البلاغة الجديدة بالفيلسوف البلجيكي شاييم بيرلمان وزميلته تيتكاه في كتابهما «مصنف في الحجاج أو البلاغة الجديدة» وهو كتاب مهم في الدرس البلاغي الحديث وبحث الحجاج، كما ذكر رولان بارت هذا المصطلح في كتابه «قراءة جديدة في البلاغة القديمة» لكنه يعبر عن مفهوم مغاير هو (الشعرية والنقد والجمالية الأدبية)، ويبدو أن السؤال دائماً عن البلاغة الحديثة، فذلك هو المصطلح الذي يعبّر عن مجمل المتغيّرات التي حدثت في البلاغة واحتضنت العديد من التوجّهات مثل، بلاغة الإقناع، البلاغة المرئية، وبلاغة الإشهار، وبلاغة الجمهور والبلاغة النقدية.
■ ما الأسباب التي دعت للانتقال بالبلاغة من المعيارية التعليمية إلى أحضان العلوم الإنسانية المختلفة لتدخل في اللسانيات والسيميائية والأسلوبية، وغير ذلك من المفاهيم النقدية المعاصرة؟
□ هذا السؤال منحني الكثير من الراحة، لأنه لم يحدد موطن البلاغة، ولذا سأجيب وعيني على البلاغة في موطنها الأول (اليونان) إذ أعطت كل ما تملكه للمتكلم لتدعم سلطته السياسية والاجتماعية عبر عنوانها (الإقناع) كما هي في بلاغة السفسطائيين، وظلت كذلك عند أرسطو، لكنّ بيير فونتانييه اختزلها بـ(بلاغة المحسنات) التي ظلّت متسيدة على تأريخ البلاغة، أمّا تأريخ البلاغة العربية فأعتقد بأنه يحتاج إلى قراءة جريئة تكشفه من داخل الخطاب نفسه، فقد صارت بلاغتنا معيارية كما يظنّ البعض، وأنا لا أتفق مع هذا التوصيف، فهي لم تكن معيارية، بل يمكن القول إنها تعليمية نعم، بفعل ما يحيط بها من مؤثرات أسهمت في تأسيسها وتوجيهها… أمّا اليوم فما زال الدرس الأكاديمي البلاغي رهين سلطة السكاكي وشروح «مفتاح العلوم» وما موجود من دراسات في المغرب العربي ومصر تشهد هذا الانفتاح، ففيها الكثير من المحاولات الجادة التي كُتب لها النجاح، وأظنّ أنّ هذا الأمر طبيعي يكشف عن تسيّد البلاغة على الحقول المعرفية الأخرى.
■ عاشت الاستعارة أكثر من حياة وبأثواب عدّة منذ الوقوف على أسسها وحتى وقت متأخر، لتبتعد كثيراً عن البحث الجمالي ضمن المفاهيم الجديدة، ونذهب بعيداً إلى الأحاديث اليومية والشائعة، أو ما عرف بالاستعارة الحيّة.. ماذا بعد هذه الاستعارة؟
□ يبدو لي الحديث من البداية مع ريتشاردز الذي رفض مسلمات البلاغة الكلاسيكية، والقول بأن الاستعارة قائمة على المشابهة، وجاء بالاستعارة التفاعلية التي أُنتجتْ (الاستعارة التصورية) في أحضانها، وكانت التصورية أو ما تسمى أحياناً بالمفهومية منطقة الكشف عن وجودها في اليومي والدخول في معترك الحياة، على حد تعبير جورج لايكوف ومارك جونسون في كتابهما «الاستعارات التي نحيا بها» فهي جزء من سلوكنا البشري، ومثله ما قاله البلاغي مصطفى ناصف في حديثه عن تسرّب الاستعارة – المجاز في حياتنا في كتابه «دنيا من المجاز»، إذ من خلال الاستعارة التصورية – بوصفها مكوناً من مكونات الذهن البشري- نستطيع فهم مجالين مختلفين والبحث عن مجال الهدف عبر مجال المصدر ويمكن تطبيقها على الخطابات المؤثرة في المجتمع، مثل الخطاب السياسي وفضح سلطته. والخطاب الديني وكشف تحكّمه الآيديولوجي، على الرغم من أن الاستعارة تعرّضت إلى الازداء والاستهجان من قبل الفلاسفة العقلين والتجريبيين، وقد وضع مؤلفا «الاستعارات التي نحيا بها» عنواناً لهذا التوجه في أحد المباحث هو «الخوف من الاستعارة». أما الاستعارة الحية، فهي جزء من الاستعارة التفاعلية، وقائمة على الابتداع والابتكار، فهي لصيقة بحياتنا واستعمالاتنا اليومية.
■ الجدل والرأي والدفاع عن الرأي حوّل علم البلاغة إلى تسميات عدّة، منها بلاغة الإقناع أو الحجاج، فانتظم بمناهج ونظريات.. هل نحن بحاجة لتنظيم كهذا؟ وهل نحتاج إلى الاستنارة في تبويب حياتنا حتى نتحول إلى كائنات مقننة ننتظر مناهج جديدة لتنظمنا؟
□ لم تحوّل هذا المفاهيم التسمية أو تعدّل منها، بل هي غيّرت وظيفة البلاغة من الإمتاع إلى الإقناع، أو بالأحرى إعادتها إلى وظيفتها الأولى، التي من أجّلها بُنيت معالم البلاغة ودافع عنها السفسطائيون وأرسطو، ويبدو أنّنا بحاجة إلى التماشي مع هذه الوظيفة، لأننا بدأنا نقرأ خطابات مختلفة ولم نكتف بالخطابات الشعرية التي فهمنا منها الإمتاع فقط، وعن المناهج والنظريات، فقد قلتُ في سؤال سابق أنّ البلاغة الحديثة احتضنت توجهات بلاغية لم تكن منشغلة بالوظيفة الجمالية، وحتى الحجاج نفسه لا يمكن النظر له من زاوية واحدة، بل من زوايا معرفية متعدّدة كل بحسب التوّجه المعرفي الذي فُهم الحجاج من خلاله، أمّا عن حاجتنا، فيبدو أنّ الدراسات الأكاديمية إذا لم تخرج من دائرة القراءة التتابعية الانجرارية، فسنبقى نعيش أنفاس هذه النظريات ونطبقها ممرنين أو على شكل تمارين واجب حلها.
■ ما زالت الجامعة العراقية تعيش في عصور لا يلتفت إليها أحد غيرنا، وخصوصاً في موضوعات البلاغة، فلم نخرج حتى الآن من تشبيه الجرجاني أو استعارة أبي تمّام، على الرغم من إنجاز أطروحات كثيرة في البلاغة الجديدة ومناهجها.. أين يكمن الخلل؟
□ في التراث البلاغي العربي الشيء الكثير الذي لم ينل عناية الباحثين والمختصين بالشأن البلاغي، فأغلب الدراسات التي تشعرنا بالملل، هي دراسات اجترارية واستعادية على الرغم من وجود مناطق عدة في التراث لم نلتفت إليها، والخلل يكمن في مجموعة من النقاط منها الخوف من القول ومخالفة سلطة المقدس الأكاديمي، وثانيهما عدم معرفة معظم الباحثين في الدرس البلاغي والنقدي واللساني لغة ثانية تجعلهم ينظرون إلى التراث بعين تفوقهم في النظر إلى تراثها، وهذا يقع على عاتق المؤسسة الحكومية التي لم تمنح جيل ما بعد التسعينيات فرصة التعرّف والتزوّد من اللغات الأجنبية عبر برامج الابتعاث البحثي أو غيرها من القنوات التي قد تطوّر الباحثين في المؤسسات الجامعية، وثالثهما غياب الدعم لرعاية مؤتمرات أو ندوات تعتني بتطوير الدرس البلاغي أو تشكيل ورش ومخبرات وجمعيات للبلاغيين والمهتمين بتحليل الخطاب في الجامعات العراقية كافة.
■ وهل يمكننا أن نسمي هذه الأطروحات المنجزة على أنها حبر على ورق من أجل الحصول على الشهادة الجامعية حسب، أو أنها غيّرت فعلاً في طرائق تدريسنا للبلاغة؟
□ نعم هي حبر على ورق إذا ما ظلّت تقدّس ما كُتب في الدرس البلاغي التقليدي ولم تذهب حتى إلى تغيير الشاهد الشعري أو القرآني، فثمّة خلل كبير في القبول بما يُكتب ويُدرّس… هناك أخطاء في المصطلحات والتطبيقات والتحليل، فعلى المشتغلين في هذا الحقل وغيره كذلك الالتفات إلى أغلاط كهذه، والخروج من دائرة طاعة ولي الأمر، أي ما كتبه السابقون يجب أن يكون مبجّلاً محترماً ويمنع المساس به، فهذا أمر مرفوض، نعم ما كُتب محترم والسابقون لهم الاحترام، لكنّ العيوب لابدّ من أن تُشخّص، ولابدّ من هجرة وتكرار الأمثلة والشواهد التي لم يغادرها السابق ولا اللاحق، فعلى الأقل تقديم أشياء مضافة لما يُذكر… أمّا عن مغادرة منهج السكاكي وشرّاح مشروعه «المفتاح» فهذا أمر يحتاج جهداً جماعياً، فعلى الأقل البداية من الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، فالثورة تبدأ من الدراسات العليا على أقل تقدير ثم نتوجه لطلبة الدراسة الأولية باحترام لتراثنا وللجهود العظيمة التي بُذلت، لكنّنا نحتاج كما قال المفكر التنويري سلامة موسى: إلى بلاغة تخدم الحياة، لأننا نمارس البلاغة من أجل الوصول إلى مستوى عالٍ من الحياة، فبلاغة الحياة أجدر من بلاغة اللغة.
■ في كتابك «بلاغة الإقناع» بحثت في الكيفية التي يقال بها النقد، وكأنك أردت سحب النقد والبلاغة العربية الكلاسيكية إلى مناهج الخطاب الجديدة، كمن يطبّق مفاهيم ما بعد حداثية على نصوص كلاسيكية قصراً.. ما الذي وجدته في محاولتك تلك؟
□ موضوع (تحليل الخطاب) يكشف ولا يُكتشف، وهذه المحاولة في غايتها الأولى هي فهم الكيفية التي قال بها الخطاب ما أراد أن يقوله، لأنّ الدراسات التي اشتغلت على النقد العربي القديم كثيرة لكنّها اشتغلت في مسارات متعددة، منها بحثت في أصول المقولات أو القضايا النقدية عبر التتابع الزمني في التراث، وأخرى كشفت عن تأثّر النقد بالفلسفة أو بأفلاطون وأرسطو وانتهت إلى التأثر والتأثير أو عدمه، ومنه من قرأ التراث النقدي عبر مقولة نقدية حديثة وحاول أن يجد لها جذوراً في ذلك التراث، فكلها بحثت في (ماذا قال النقد) أمّا «بلاغة الاقناع في الخطاب النقدي» فقد بحث في (كيف قال النقد) وهذا يسهم في الدخول إلى لغة الناقد وعباراته وتوصيفاته وقدرة النقد على أن يكون خطاباً مشروحاً لا شارحاً، أمّا عن علاقة الكتاب بالإقناع، فهي علاقة اقترحتها علاقتي بالبلاغة كوني متخصصاً منذ الماجستير في حقل البلاغة، وقد حاولت أن أغيّر وأحوّر في دلالة المصطلح بالقدر الذي يمكّنني من الاستقلالية، وهذه الدراسة جعلتني في محايثة مع الخطاب النقدي وعزّزت في داخلي قناعة ضرورة الاشتغال- وهو ما أعمل عليه- على الخطاب بما هو كيفية، وأخطط الآن في دراسة عن أنظمة التأليف في الخطاب البلاغي العربي، وهو يدور في كيفية تشكّل خطاب الجرجاني على سبيل المثال في معالجة بعض المفاهيم، من اختيار العنوان أو الشاهد وكذلك اللغة التي تتمّ بها المعالجة، وسياق التأليف وموجهات الخطاب.
■ تسير البلاغة الآن بالتوازي مع السرد، تطورا معاً، وحاولاً أن ينتجا مفاهيمهما في الوقت ذاته.. هل هناك رابط واضح بين هذين المصطلحين؟ وكيف بدأت البلاغة بالهرب من الشعر إلى الشعرية والنصوص السردية؟
– للسرد وظائف مهمة متعدّدة قد يتشابه بعضها مع وظائف البلاغة، فمثلاً هناك وظيفة متعلّقة بالسرد وهي وظيفة (التمثيل) إذ إنّ الراوي يتوهّم عالماً خارجياً ويمثّله في نصّه السردي، كذلك البلاغة هي استحضار وتمثيل للهدف الذي يقصده المتكلم، أو يعمد المتكلّم إلى استحضار مخاطَب يعمل على إمتاعه أو إقناعه، كذلك من وظائف السرد هو الإقناع، وهي وظيفة أساسية في البلاغة، بل هي الوظيفة الأم لها، ثم- أنا شخصياً- مؤمنٌ بالبعد الثقافي للبلاغة، وهو ذلك البعد المتجلي بشكل واضح في السرد، إذ نعبّر من خلال البلاغة عن الكثير من أشيائنا بوصفها ثقافة، فالكناية ليست كناية الجمال، بل هي كناية الثقافة وما يثبت ذلك دلالتها في الاستتار ولوازمها، كذلك الاستعارة عبر عناصر التفاعل والانتقال بين الحقول المعرفية، أمّا السرد فهو ثقافة الامم، وكما يقول فوكو وليوتار ويتجسد في طروحات المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد «أن الأمم والشعوب سرديات، وهذه المرويات هي استراتيجياتها في التخلّص من الامبريالية»، كذلك عبر البلاغة نتخلّص من السلطة بكل أشكالها عبر إنتاج خطاب جماهيري مضاد وهذا ما يعمل عليه (مشروع بلاغة الجمهور)، فضلاً عن أن ارتباط البلاغة بالسياسة أمرٌ لا يخضع للشك، فمنذ أرسطو نجد هذا الارتباط حتى يومنا هذا، وهل نشكٌّ في أنّ السرد أداة التعبير عن الفعل السياسي؟! أمّا عن هروب البلاغة من الشعر، فهذا أمر محال، لأن البلاغة في واحدة من توصيفاتها أنها النقد والشعرية، فيظل الشعر منطقة تشتغل عليها، لكنّ البلاغة اليوم تحاول قراءة نصوص لم تُقرأ بلاغياً.
■ تحدّثت عن بلاغة الجمهور، فما هذا الاتجاه البلاغي؟
□ هو توجه معرفي يعمل على دراسة الاستجابات الجماهيرية، اقترحته الباحث البلاغي عماد عبد اللطيف عام 2005، وعبر مجموعة من الدراسات، ولنا الآن كتاب جماعي عن هذا المشروع شارك فيه مجموعة من الباحثين العرب المتهمين بـ(البلاغة وتحليل الخطاب) قدّمتُ له وحرّرته مع العزيز عبد الوهاب صدّيقي من المغرب فيه خمس عشرة دراسة عنوانه «بلاغة الجمهور ـ مفاهيم وتطبيقات».
(القدس العربي)