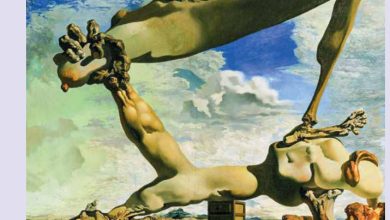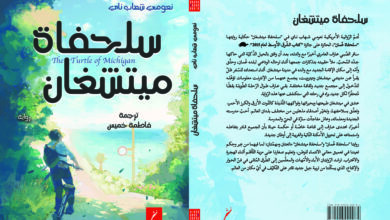«أحمر حانة» للعراقي حميد الربيعي… الافتتان بالتعرية وتبئير المكان

مروان ياسين الدليمي
تضعنا رواية «أحمر حانة» للكاتب حميد الربيعي الصادرة عام 2017 عن دار صفصافة للثقافة والنشر في القاهرة، أمام تجربة مميزة في تلقي العمل الروائي، خاصة أنها تطرح إشكالية العلاقة بين السرد الروائي والتاريخ، ما يستدعي طرح اسئلة ملحة حول الحدود التي تفصل المتخيل عن الحدث التاريخي داخل البنية الروائية، وجدوى حضور التاريخ إذا كان المبدع سيمارس معه فعل الإزاحة، اعتمادا على المساحة الواسعة التي تتيحها له مخيلته في أن يحلق بعيدا عن محدوديته الواقعية، هذا إضافة إلى أن هذه الرواية قد اتسمت بلغة عالية في رؤية الأشياء.
تفكيك الذاكرة
الربيعي كان حريصا على أن تحمل روايته بين سطورها سياقا فنيا مركبا في التعامل مع المكان والزمان، لم يكن من السهل الإمساك به حتى على قارئ يمتلك ذائقة مدرّبة على التفاعل مع أعمال تخرق المتداول في صياغة القول والبناء الفني، إلى جانب تصديه لذاكرة مدينة بغداد، بما مر عليها من حروب وخراب، خلال تاريخها الطويل. ابتدأ من الحرب العراقية الإيرانية ومن ثم غزو الجيش العراقي للكويت مرورا بالحصار الدولي الاقتصادي على العراق، وانتهاء بالحرب الطائفية والحرب ضد الجماعات الدينية المتطرفة، التي يعيشها العراقيون منذ سقوط نظام البعث عام 2003: «من سوء الطالع أن لا تجد مكانا في حافلة متجهة إلى العاصمة، مئات الجنود العائدين من الحرب الثانية يتطافرون خلف السيارات، مثل كور زنابير، يلتئمون ثم ينطلقون صوب أي حافلة تدخل المرآب العام، أراقب الحركة وأشده من الجرحى والعرجان، الذين يتدافعون بقوة عشرات الإصابات وبشتى مناطق الجسم تراها تتقيح إلى الخارج».
يأتي تعامل الربيعي مع التاريخ باعتباره فضاء سرديا مفتوحا أمام أدواته الفنية، وفي تشكيل خطابه التخييلي «كان ابن الأثير ينحني فوق فراشه على سطح الدار من صيف عام 1233 عندما مرق بجواره عزرائيل مرتديا لباسا أسود منحني الظهر يهرول قليلا، إذ أن ساقه اليسرى قد اتعبته من طول المطاردة، فهو يلاحق شابا أشقر ذا بزة غريبة، بنطلون ضيق وقميص بنصف كم»
انزياح الحدث
هذه الرؤية الفنية في التعامل مع التاريخ باعتباره فضاء سرديا، أتاحت للمؤلف أن يفكك العلاقة معه بما يتيح له أن يطلق العنان لمخيلته في تشكيلها، خاصة مع الشخصية، كما هو الحال مع شخصية ابن الأثير وأصحاب الكهف الذين ورد ذكرهم في القرآن، بذلك تشكلت رؤيته انطلاقا من قواعد البناء السردي، ساعيا بذلك إلى إزاحة كل ما له صلة بالحدث التاريخي إلى منطقة التخييل التاريخي «ابن الاثير من رعونته وخوفه اعترض طريق الملك، رغب بالتوسل كي يمهله بعض الوقت لتدبير شؤونه، عزرائيل بهت من اعتراض الرجل طريقه، كان ينوي الوقوف على حافة السياج، يتابع بنظره هروب الفتى الشيطان فوق سطوح المنازل».
وفق هذا المنظور يأتي هذا العمل في إطار إعادة كتابة التاريخ إبداعيا، أي من وجهة نظر ذاتية، بعيدا عن التوثيق العلمي، بالانزياح ناحية منطقة التخييل، وهذا يعني حضور وهيمنة الأسلوب واللغة الروائيين، بما فيهما من طاقة وجدانية تتجاوز المحددات الموضوعية التي تأسر المؤرخ في تعامله مع الحدث، وعلى ذلك يمكن النظر إلى شخصية ابن الأثير الهارب من ملك الموت، على أنها جاءت باعتبارها معادلا موضوعيا لرؤية المؤلف ذاته في الهرب من هيمنة التاريخ المكتوب، بمواجهته عن طريق كشف طبقاته من جديد، «يشعر بداخله أن وراء تلك المطاردة ثمة معلومة في غاية الخطورة، وأن الكشف عن تلك الحيثيات سيجعل من كتابه المقبل مهما وثمينا، سيتعب وسيرتاب، يضيع ويقرف وينتابه اليأس، ما دام يمشي وراء لغز محير، قوامه مدينة». لم يكن الهدف في هذا العمل التصدي لقضية تاريخية بعينها، بقدر ما تأتي في إطار طرح أسئلة ملحة تهدف إلى تعرية الواقع وإدانته»، تفتت حجارة الطرقات أولا من ثقل الآليات التي داستها في ذهابها وإيابها، من سوح المعارك خلال ثماني سنوات. الحجارة تناثرت على الجوانب، تاركة عرض الشارع نهبا لمجنزرات تقلب باطن الأرض وتحيله إلى تراب أسود».
ما كان للربيعي أن ينهض بهذه المهمة على ما هي عليه من تعقيد في تداخل الأزمنة في ما لو بقي أسير الحدث التاريخي، ولم ينسحب به ناحية الإزاحة، ولكي يمضي في هذا المسار كان لابد أن يعيد صياغة علاقة جديدة مع الزمن والمكان، من خلال تحطيم المسار الطبيعي لكليهما، في مقابل بناء علاقة فنية أخرى قائمة على التشظي بهدف الإمساك بالفراغات التي أحدثها التاريخ.
التمرد على الشكل
من هنا اختار لخطابه أن يخوض في مسار مغاير يتداخل فيه المتخيل بالواقعي، وفي لحظة جدل ثنائية ما بين الرواية والتاريخ، وقد جاء ذلك عبر بنية سردية مشحونة بالتمرد من الناحية الفنية، حيث يقف فيها التاريخ والمؤرخ وجها لوجه أمام بعضهما، في محاولة من المؤلف لتعرية الماضي، باستدعاء شخصية المؤرخ ابن الأثير ليكون الشخصية المحورية. في الوقت نفسه لينهض بدور الساردة للأحداث من بعد ان يتعرض قبره إلى عملية تدمير، أقدم عليها تنظيم «دولة الخلافة» (داعش) في مدينة الموصل بعد أن استولى على المدينة في 10 حزيران/يناير 2014، وهذا ما يدفع إلى أن ينهض من قبره ويغادر المدينة متجها إلى بغداد في محاولة منه لإكمال ما لم ينجزه من أعمال قبل وفاته سنة 632 هـ/ 1233م، لذا يقرر إعادة كتابة تاريخ مدينة بغداد من جديد «في عنقه دين منذ أن استفاق من شق القبر في الموصل، وطوال بضع سنوات قضاها في المدينة المدورة بحثا عن ذلك الفتى الذي يشبه الشيطان». هذا السفر في الطبقات الزمكانية الذي اخذنا إليه حميد الربيعي يدفعنا إلى إعادة تشكيل وعينا من جديد إزاء التاريخ والمؤرخين .
الرواية تضع القارئ أمام تحد لذائقته السردية، لأنه سيخوض مغامرة داخل عالم يتسم بالغرابة، وسيشعر بالامتنان والامتلاء في الوقت نفسه، حتى لو أصيب بالتوهان في رحلة يكتنفها الغموض، وهذا يعود إلى ما تحمله من نزعة فنية متمردة على ما هو متداول في الكتابة، خاصة في ما يتعلق برؤيته للمكان، باعتباره بنية سردية، كما يشير إلى ذلك كتاب «المكان العراقي» للناقد لؤي حمزة عباس «ففي المكان وحده تتظافر أبعاد الزمان في حوار لا ينتهي، من دون أن ينحصر بوصفه تجليا سيميوطيقيا، في حدود تجاربنا الحسية، وهو يمنحها حيزا وجوديا فاعلا، إنه يمضي إلى ما وراء ذلك ليسهم بتشكيل الذات الإنسانية وبلورة خصائصها، إنه الكينونة في سيرورتها».
رواية «أحمر حانة» تحمل مستويات متراكبة في خطابها المعبأ بحمولات تاريخية مضطربة عاشتها بغداد (المدينة/ المكان )، والربيعي يقترح رؤيته الذاتية في قالب من البوح الثنائي يتناوب عليه سارد عليم بكل شيء وسارد ذاتي، فتتعالق الشخصيات (العرجاء والجنرال وإخوة الكهف) مع المكان، إلى الحد الذي يصعب فيه التمييز بينها، حتى إننا في لحظــة ما لا ندري من الذي يتولى عملية السرد، هل هي الشخصية؟ أم المكان في إطار علاقة متشابكة حد التماهي.
(القدس العربي)