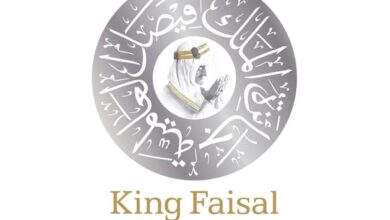بوشعير يرصد ويحلل قضايا فكرية وفنية وجمالية في الرواية الخليجية
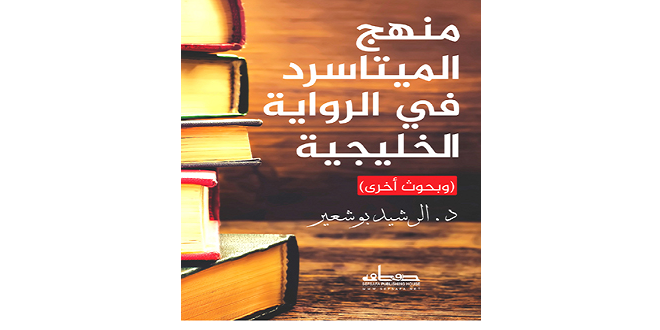
محمد الحمامصي
يتناول كتاب “منهج الميتاسرد في الرواية الخليجية” لأستاذ الأدب الحديث والأدب المقارن بجامعة الامارات د. الرشيد بوشعير قضايا فكرية وفنية وجمالية في الرواية الخليجية وذلك من خلال باقة من البحوث التطبيقية النصية الممنهجة مثل منهج “الميتاسرد” و”إشكاليات التصنيف السردي” و”الانزياح الرؤيوي” و”بناء الزمن” و”تجليات وتمثيلات الأنا والآخر” و”الهواجس الاجتماعية” وغيرها، ليفتح المؤلف أبوابا جديدة في دراسة الرواية الخليجية.
وقال بوشعير عن منهج “الميتاسرد” في الرواية الخليجية “يمكن تعريف الميتاسرد بأنه قصة داخل قصة، وهذا التداخل بين قصتين يتفاوت من حيث مداه وقوته أو ضعفه، وتماسكه أو انفراطه. وهذه التقنية تقتضي وجود راويين أو أكثر، وتمكن من (الوعي) بالسرد، وذلك من خلال تقديم (إفادات وتصريحات) حول ذلك السرد المتخيل، على حد تعبير “باتريس وو”.
وأضاف في كتابه الصادر عن دار صفصافة “إن آلية الميتاسرد تحكم بنية الحبكة الكلاسيكية التي تمنح العالم معناه، وتضع التجربة السردية موضع مساءلة واعية. وقد كانت هذه الآلية السردية بأساليبها المختلفة معبرة عن روح العصر وعن تطلعات فلسفة ما بعد الحداثة، وغدت سمة مهيمنة “في كتابات جيل من الروائيين، يستشعر أكثر من غيره فداحة أزمة المجتمع. فالعصر يتسم بعدم الاطمئنان وعدم الاستقرار والأمن، والشك في كل شيء. تأتي الرواية مع هؤلاء لتعكس روح هذا العصر من خلال روح جديدة، وذلك عن طريق تكسير القيم والرؤى التقليدية التي ظلت الرواية التقليدية تحملها وتدافع عنها”.
وفي بحثه المعنون “منهج “الميتاسرد” في الرواية الخليجية “حب في السعودية” لإبراهيم بادي أنموذجاً” قال بوشعير إنه لا يريد التأريخ لآلية “الميتاسرد” وأساليبها في أنطولوجيا الرواية العالمية والعربية، وإنما نريد أن نشير في إيجاز إلى بعض التجارب الروائية الخليجية التي توسلت بهذه التقنية التغريبية وجمالياتها.
وأوضح بوشعير “من هذه التجارب الروائية الخليجية تجربة علي الدميني في روايته الموسومة بـ “الغيمة الرصاصية”، وهي رواية لا تقدم حدثاً واحداً أو قصة ذات بناء مغلق، وإنما تقدم لنا أحداثا متداخلة أو متوازية تتواصل فيما بينها حينا وتنفصل عن بعضها من حيث البناء والزمن والسرد والشخوص حيناً آخر. وأول هذه الأحداث التي يجد لها علي الدميني بهذه الرواية أطراف من سيرة “سهل الجبلي” الموظف في بنك الدمام، وحكاياته مع شخوص رواية كان يحاول صياغتها بمشقة كبيرة. فنحن إذن أمام قصة داخل قصة متناسلة تفرز عدداً من الأحداث، ويحاول الكاتب من خلال هذه البنية أن يعالج قضايا واقعية، ولكنه يتخذ من هاجس الكتابة الروائية موضوعاً للتأمل.
وأضاف: من هذه التجارب الروائية أيضاً “دنسكو” لغازي القصيبي الذي يستهل عمله بالتعليق المباشر على عنوان الرواية وموضوعها، ورواية “ساق البامبو” الفائزة بجائزة البوكر العربية دورة 2013التي لا تخلو من تطلعات “ميتاسردية” تتراءى في قصة “راشد الطاروف” الذي ينجب ابناً من خادم آسيوية ويمنحه جنسيته الكويتية، ولكن المجتمع بقيمه يرفض ذلك الابن. إن هذه القصة التي تشكل بنية رواية “السنعوسي” تكون موضوع تعليق من قبل مترجمها “إبراهيم سلام”، ومن قبل مؤلف الرواية المنسوبة إلى “عيسى” أو “Jose” نجل “الطاروف”، كما أن فعل الكتابة الروائية وأثره في المجتمع يغدو محل تعليق بهذا العمل.
ومن هذه التجارب الروائية كذلك تجربة طالب الرفاعي برواية “ظل الشمس” وهي الرواية التي كان الكاتب نفسه من شخوصها.
وأشار إلى إن “إبراهيم بادي” في روايته “حب السعودية” لم يكن الوحيد الذي أراد أن يجرب كتابة “الميتاسرد” في الرواية الخليجية، ولكنه يعد متميزاً عن غيره في خوض هذه التجربة لكونه لم يكتف بتقديم قصة داخل قصة بروايته “حب في السعودية”، وإنما أراد أن يضمنها ثلاث قصص متداخلة فيما بينها، كما أراد أن يجعل من فعل الكتابة الروائية في حد ذاته موضوعاً للتعليق والتأمل.
تدور أحداث هذه الرواية في المملكة العربية السعودية في كنف مجتمع شديد المحافظة والتشبث بالقيم الروحية والمواضعات والأعراف الأخلاقية، وهو ما يوحي بالتناقض بين طبيعة الأحداث والفضاء الذي تنسج فيه خيوطها، وهو التناقض الذي أراد بعض الكتاب السعوديين أن يتجنبوه بالهروب إلى فضاءات أخرى بالخارج، على نحو ما يتراءى في رواية “ستر” لرجاء عالم، و”بنات الرياض” لرجاء الصانع، و”نزهة الدلفين” ليوسف المحميد، و”سماء فوق أفريقيا” لعلي الشدوي، و”الفوارس” لحسن الشيخ، و”القندس” لمحمد حسن علوان، وغيرها من الروايات التي تدور كثير من أحداثها العاطفية في فضاءات غير فضاءات الخليج، علماً بأن الفضاءات المقدسة في حقيقة الأمر لا تتناقض بالضرورة مع العواطف الإنسانية النبيلة السامية، وإنما تتناقض مع الانحرافات والفجور والفسوق وسائر المحرمات.
وخلصت قراءة بوشعير إلي أن أسلوب “الميتاسرد” قد أخذ يروج في السرديات الروائية الخليجية نتيجة للتثاقف الأدبي والنقدي، وليس لضرورة فكرية ملحة، لا سيما وأن هذا الأسلوب يوظف في السرديات الأوربية للتعبير عن الإحساس بغياب اليقين وموقع الإنسان القلق في الكون، وهو ما يناقض جوهر الثقافة العربية التي ترسخت فيها قيم اليقين والنأي عن الارتياب الذي يزعزع الاطمئنان.
وإذا كان أسلوب الميتاسرد قد وظف في المسرح الملحمي بوصفه تغريباً يزرع الشك في القيم البورجوازية، ويدعو إلى تغييرها، فإن هذا الأسلوب في الرواية الخليجية يوظف فنياً وليس أيديولوجياً.
وفي قراءته حول نموذج المرأة في الرواية النسوية الخليجية، يقارب بوشعير للموضوع مقاربة تراهن على سرديات المرأة ذاتها، بغض النظر عن تفاوتها في عمق الطرح ونضج التجربة الجمالية والفنية، متمثلا بأعمال روائية لكاتبات خليجيات ينتمين إلى الأقطار الخليجية الستة التي تشكل مجلس التعاون بالمفهوم التاريخي لا بالمفهوم الجغرافي.
توقف بوشعير مع أربعة نماذج للمرأة هي: الرومانسية، الواقعية، الوجودية، المتمردة:
أولا: نموذج المرأة الرومانسية: وهذا النموذج يتسم بالنزوع العاطفي الوجداني والأحلام المخملية والاندفاع في سبيل تحقيق تلك الأحلام، فضلا عن الحنين إلى الماضي. ولكن هذه السمات العامة تتفاوت في مدى قوتها أو ضعفها من رواية إلى أخرى. ويمكن أن نتمثل لهذا النمط الأنثوي الرومانسي بكثير من النماذج التي تطالعنا في الأعمال الروائية النسوية.
في رواية “الطواف حيث الجمر” للكاتبة العمانية بدرية الشحي نرى الفتاة الجبلية “زهرة” التي كانت متعلقة بابن عمها “سالم” الذي كان خطيبا لها ثم أصيب في حرب أهلية، وعندما شفي فرّ إلى سواحل إفريقيا الملاصقة لعمان، حيث تزوج وأنجب، بينما كانت زهرة تغزل خيوط الأمل في عودته، وعندما يموت غرقا تصاب بحزن عميق، وترفض الزواج من شقيقه “عبدالله” الذي يصغرها سنا، ولكن أهلها أرادوا أن يرغموها على هذه الزيجة فتتظاهر بالقبول، ثم تأخذ مصوغاتها وتخوض مغامرة صعبة، فتركب سفينة النوخذة “سلطان” وتسافر إلى إفريقيا تجنبا للزواج من “عبدالله” ورغبةً في التعرف على أرملة “سالم”، وهناك تتعرف على بحار تقترن به، وعندما يموت زوجها تتفرغ لاستثمار مزرعته التي ورثتها عنه.
وفي رواية “شجن بنت القدر الحزين” للكاتبة الإماراتية حصة الكعبي (سارة الجروان)، تخوض “عائشة” بطلة الرواية مغامرة شبيهة بمغامرة “زهرة”، فقد أراد والدها أن يجبرها على الاستمرار في الزواج من الشاب المستهتر “مبارك” الذي كان يعاملها معاملة الأمة، فتهجر بيت الزوجية وتعود إلى منزل والدها، ولكن ذلك الوالد المستبد يحاول أن يرغمها على الاقتران برجل آخر مسن مزواج، فتتنكر في ملابس شقيقها وترحل إلى البحرين، حيث يطاردها أشقاؤها وينتقمون منها انتقاما جاهليا، فيغرز أحدهم خنجره في نحرها ثم يختفي، وبذلك يجهض مشروع زواجها من “خالد” الشاب الطيب الذي تعرفت عليه بالبحرين.
ولو أردنا أن نستقصي نماذج أخرى في أعمال الكاتبات الخليجيات لامتد بنا الزمن؛ فهناك كثير من الروايات النسوية التي تتسم نماذجها الأنثوية بالنزوع الرومانسي، وخاصة في أعمال سميرة خاشقجي، وبعض أعمال الكاتبات الإماراتيات اللواتي يغلب على بطلات رواياتهن الحنين إلى الماضي، من أمثال “أمنيات سالم”، و”صالحة غابش”، و”لميس المرزوقي”، و”آمنة المنصوري”.
ثانيا: نموذج المرأة الواقعية: وهذا النموذج يجنح إلى محاولة التكيف مع الواقع والتخطيط لتغييره تخطيطا منطقيا لا اندفاع فيه ولا تهور. ويطالعنا هذا النموذج في كثير من الأعمال الروائية الخليجية؛ ففي رواية “مريم الغفلي” الموسومة بـ “بنت المطر” نقابل الطفلة “لطيفة” التي فقدت والديها ووجدت نفسها مضطرة إلى العيش مع “نورة” أرملة والدها التي تذيقها ألوانا من الامتهان والقهر والكيد، وتفرض عليها أن تتزوج من شيخ ثري هرم أصبح جَدا، وهي في الثانية عشرة من عمرها، موهمة إياها بأنها قد ورثت كمية من الذهب تضمن لها مستقبلا رغدا، وعندما يخيرها زوجها بين البقاء في عصمته أو تسريحها، تختار البقاء تجنبا للمواجهة مع نورة. ويصاب ذلك الزوج بمرض فتصاحبه لطيفة إلى لندن للعلاج، وتسهر على راحته وترعاه، بينما تتفرغ ابنته “شيخة” وزوجها للأسواق واقتناء البضائع، تاركين أبناءهما محبوسين بالفندق.
وعندما يموت الزوج تحرص لطيفة على نقل جثمانه إلى أبوظبي، وبعد انتهاء مراسيم العزاء تتعرض لسلسلة من المواقف المؤلمة، فتتهم في شرفها، وتطرد من منزل زوجها، وتكتشف زيف الذهب الذي تلقته من نورة، فتواجه قدرها بصبر، وتخرج ظافرة في نهاية المطاف.
وفي رواية “تداعي الفصول” للكاتبة القطرية مريم آل سعد، تطالعنا سارة طالبة الهندسة الطموحة التي كانت تسعى للحصول على وظيفة تتيح لها أن تسهم في تنمية وطنها، ولكن رؤساء الأقسام من الإداريين كانوا يرفضون فكرة توظيف أنثى. وتواصل سارة مساعيها حتى تحصل على وظيفة مهندسة مختبر بأحد المعامل، فتؤدي عملها بمهارة وتفانٍ، وتكتشف كثيرا من مظاهر التسيب والجهل والعنجهية والفساد، فتنبري لمواجهة كل تلك المظاهر السلبية، فتجمع معلومات عن ذلك، ولكن رئيسها يفصلها من منصبها ويتهمها بتسريب معلومات سرية دون إذن منه، وإضافة إلى ذلك فإن خطيبها المقاول يتأذى من موقفها ويتخلى عنها، وتكتمل محنتها بتعرضها إلى حادث سير يفقدها قدرتها على الوقوف على قدميها.
ومع ذلك فإن سارة لم تستسلم؛ بل ظلت تقارع لإثبات وجودها، فاتخذت قرارا بالسفر إلى أميركا بغرض مواصلة الدراسات العليا، وتعود بعد سنوات وهي تحمل درجة الدكتوراه، كي تلتحق بوظيفة جديدة بوزارة الاقتصاد.
إن بطلة الرواية، كما نرى، رسمت خطة صارمة في حياتها ونفذتها بإصرار وعزم، دون كلل أو لغوب، متحدية كل العقبات الكأداء التي واجهتها.
ثالثا: نموذج المرأة الوجودية: وهذا النموذج يتراءى في كثير من الأعمال الروائية الخليجية النسوية، وخاصة في رواية “الآخرون” لـ “صبا الحرز”، ورواية “السقوط إلى أعلى” لفتحية النمر، و”الحياة كما هي” لظبية خميس.
إن بطلة “الآخرون” لصبا الحرز كانت شاذة تعاني من نوبات الصرع التي كانت تنتابها من حين إلى آخر، وهو ما انعكس سلبا على علاقتها بالآخرين، وعلى رؤيتها إلى الكون، ولذلك نراها تريد أن تعيش حرة دون قيود أو سدود، وترفض أي شكل من أشكال الوصاية عليها، وخاصة على جسدها الذي لا تريده أن يرزح “تحت سلطة أحد”، ولكن اندفاعها في السعي إلى التحرر ينتهي بها إلى هاوية العدمية؛ إذ لم تعد تبالي بنجاحها أو إخفاقها أو موتها: “أنا لست طيبة كفاية لتركلني الدنيا خارجها، لكني من التعب بحيث أحتاج إلى موتي”.
وفي رواية “السقوط إلى أعلى” تطالعنا الزوجة منى التي تضيق ذرعا بجمود زوجها فتتخذ قرارا بالانفصال عنه مضحية بأبنائها، وذلك بدافع الرغبة الجارفة في التحرر الوهمي المطلق الذي ينتهي بها إلى نفق مسدود.
وفي رواية “الحياة كما هي” تسافر “مهرة” (بطلة الرواية) إلى أميركا بدافع البحث عن الحرية المطلقة التي لا تبالي بأي التزام، ولذلك نراها تفرح عندما يموت والدها؛ لأنها “أصبحت ولية أمر نفسها”، وبعد تجارب عاطفية مخفقة تنتهي هي الأخرى إلى أفق عدمي خاو يماثل قبض الريح !
رابعا: نموذج المرأة المتمردة: الحقيقة أن التمرد بوصفه ضربا من “الرفض” أو بوصفه ظاهرة من ظواهر الإحساس بعبثية الحياة، كما يذهب “ألبير كامو”، يمكن أن يخالط أمزجة النماذج الأخرى التي وقفنا عندها، وخاصة النموذج الرومانسي والنموذج الوجودي، ولكنه قد يغلب على نماذج رواية نسوية بعينها فتغدو رموزا له، وقد يتجاوز التمرد في هذه النماذج رفض القيم الاجتماعية والأخلاقية، إلى رفض القيم الميتافيزيقية، على نحو ما يتراءى في بعض مواقف بطلة “الآخرون” لصبا الحرز، ومواقف “سارة” بطلة “الأوبة” لوردة عبدالملك.
وخلص بوشعير إلى أن هذه النماذج النسوية التي وقفنا عندها في هذه العجالة، تومئ إلى هواجس المرأة الخليجية وأمزجتها ومستوياتها الفكرية والاجتماعية كما تبدو في السرديات الروائية النسوية، وهي محكومة بالشروط التاريخية التي تحاكي الرمال المتحركة في تغيرها، وربما كانت هذه النماذج “باستثناء النموذج الواقعي” إفرازا من إفرازات التواصل مع ثقافة الآخر والانفتاح على حضارته وقيمه في عصر العولمة الذي أسهم في رفع سقف طموحات المرأة بوصفها كائنا إنسانيا يتطلع إلى الحرية والمساواة والإنصاف من المجتمعات الذكورية، ولكن طموحات هذه المرأة من جهة أخرى تظل محكومة في حدودها بالقيم الروحية والاجتماعية المحلية نسبيا، وهو ما يشكل صمام أمان بالنسبة إلى بنية الأسرة التي تعد نواة المجتمع، يصح المجتمع بصحتها ويعتل باعتلالها.
(ميدل ايست اونلاين)